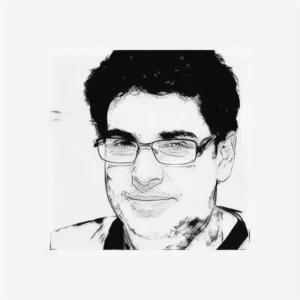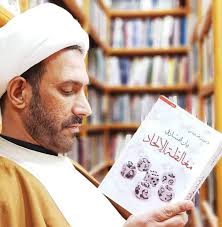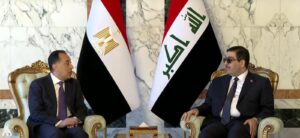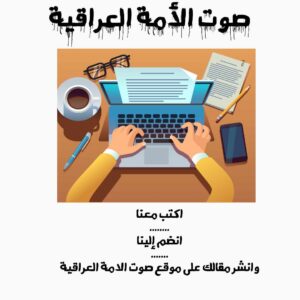اسم الكاتب : صادق الطائي
رغم أن انتفاضة تشرين (أكتوبر)، أو ما بات يعرف بانتفاضة الصدور العارية، تمثل استمرارا لحراكات شعبية سابقة، ابتدأت منذ فبراير 2011 حتى الآن، إلا أنها بدت مختلفة من جهة حجم المشاركة الشعبية العفوية غير المسيسة، بالإضافة إلى العنف الذي سلطته الأجهزة الحكومية على حركة الاحتجاج للقضاء عليها بأسرع وقت.
ونشير إلى لطمة مؤثرة وجهها المنتفضون إلى وجه الحكومة، بل العملية السياسية ككل، حتى إلى شريحة المثقفين، بأدائهم اللافت للنظر، رغم افتقار شباب الحراك للتنظيم، أو الرأس، أو التنسيقيات التي يمكن أن توجه وتقود الجماهير المنتفضة. وقد حاول بعض المدعين، وهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي، أو بعض القنوات الفضائية، أن يرسموا أنفسهم ليظهروا وكأنهم قادة الحراك، الذين يمتلكون النفوذ والقدرة على إخراج المظاهرات أو إيقافها، طمعا في ما قد ينتج من تفاوض مع الجهات الحكومية والإقليمية، وما قد يحصلون عليه من فتات العطايا، والنماذج الأبرز لهذا السلوك أشهر من أن أسميها باسمائها، فقد عرفهم كل المتابعين مما تم تداوله من فيديوات تحريضية لهؤلاء المسوخ، وسرعان ما تحولت هذه النماذج إلى بهلوانات مضحكة يعرف الجميع زيفها ويضحكون من صرخاتهم المهددة، رغم انطلائها على البعض من غير العارفين هنا أو هناك.
إذا اردنا الحديث عن دور المثقف العراقي في الحراك السياسي بشكل عام، وفي حركات الاحتجاج بشكل خاص، يجب علينا أولا أن نحدد، ولو بشكل تقريبي، من هو المقصود بتسمية أو توصيف «المثقف»؟ وأين تقع حدود هذه الشريحة من المجتمع؟ بالتأكيد أن إطلاق هذه التسمية على شريحة معينة شابه الكثير من الخلط وعدم الدقة، لكنه بالنتيجة جمع في سلة واحدة، المشتغلين في حقول الثقافة والإعلام وبعض المهن التي يمكن أن تسمى مهن النخب، والنتيجة تكونت لدينا شريحة واسعة من الكتاب والصحافيين والمشتغلين في إنتاج الثقافة بكل تفرعاتها، والعاملين في قطاع الإعلام بكل تنوعاته، بالإضافة إلى المهندسين والأطباء والمحامين والمدرسين والموظفين الحكوميين إلخ، ممن يمكن وصفهم بالعاملين في مهن النخب الاجتماعية. كل هؤلاء بات يطلق عليهم الشارع جزافا صفة «المثقف». لكن في قلب هذه الشريحة هنالك توصيف عصي على التحديد، ولا يمكن الإمساك به بدقة ، لكن يمكن أن يحس، وهو ما نجده في التعاطي مع المدونين أو الحكائين المترددين على شارع المتنبي وفعالياته، الذين يقدمون أنفسهم بصفتهم صوت الناس، أو الناطق الرسمي باسم الثقافة، هؤلاء هم الاكثر التصاقا بصفة «المثقف» الشعبوية التي يتعاطاها الشارع العراقي اليوم.
علاقة من يعتبرون أنفسهم متحدثين باسم الثقافة مع الحراك الجماهيري في العراق علاقة معقدة، شابها الكثير من التوتر تاريخيا، فقد ورث هذا المثقف في إطار تعامله مع رجل الشارع عنجهية شريحة الافندية العثمانية وتكبرهم، بل احتقارهم لرجل الشارع باعتباره جاهلا، فظا، غير متحضر، مما خلق بالنتيجة لدى المثقف شعورا بأن من حقه احتكار التمثيل المعنوي والسياسي لأفراد مجتمعه، يصاحبه طبعا امتياز الأولوية في إشغال العمل الحكومي والعمل العام، نتيجة ما يعتقده المثقف من امتلاكه أدوات التعبير التي يفتقدها (الرعاع) من وجهة نظره. بقيت العلاقة متوترة بين المثقف ومحيطه، وقد ورثتها الأحزاب الليبرالية في الحقبة الملكية، التي بنيت على صيغة الليبرالية الغربية، لكن بطريقة شابها الكثير من التخبط وعدم الدراية، نتيجة حداثة التجربة وقلة الخبرة السياسية، إذ احتكر «الأفندية» التمثيل السياسي وواجهات الأحزاب، وبالتالي التمثيل البرلماني والحكومي، لكن ابتدأ حراك اجتماعي حقيقي في عقد الخمسينيات، قرّب الأحزاب الليبرالية العراقية حديثة العهد بالعمل السياسي من النمط الغربي، وبدأ حراك سياسي واجتماعي يظهر في المجتمع العراقي حينها، نتيجة أسباب اجتماعية واقتصادية أحدثت تغيرات في البنية السياسية. لكن الأحزاب الأيديولوجية (الشيوعي والبعث تحديدا) لم تمهل تجارب الليبرالية طويلا، واكتسحت ساحة النشاط السياسي، وطرحت نمطا جديدا من نسق العلاقات بين المثقف وشارعه، إذ ترسمت هذه الأحزاب صورة المثقف بصيغة مقاربة لإطروحة المفكر الماركسي أنطونيو غرامشي الشهيرة عن المثقف العضوي، لكن مع وصول حزب البعث لسدة الحكم، وترسيخه نظام الحزب الواحد والدولة الشمولية، وبالنظر لمعطيات اقتصادية متمثلة بكون اقتصاد العراق نفطيا ريعيا بشكل أساس، وقد أمسكت الحكومة بريعه عبر السيطرة على عائدات البترول، باتت حكومة البعث تتعامل مع قطاع الثقافة والمشتغلين به على أنهم منتجو ثقافة يمكن الاستثمار عبر العمل على شراء تبعيتهم، وخلق جيش من المداحين المنافقين الذين يكتبون ويغنون ويلحنون ويرسمون وينظّرون ويناقشون ما يأمرهم به رأس الهرم الحزبي والحكومي، وباتت وصمة تبعية المثقف للسياسي تشكل سمة من سمات المثقف العراقي في ظل الدولة الشمولية، ولم ينج من هذه الوصمة إلا القلة.
مع التغير الذي تزامن مع الاجتياح الامريكي، خرج العاملون في قطاع الثقافة وكأنهم مسرنمون، خرجوا من عقود من تبعية الثقافي للسياسي الشمولي، وبحثوا عن حلول وتكييفات لوضعهم في النظام الجديد، البعض نظر باحثا في التاريخ القريب قبل موجة الانقلابات العسكرية عن نماذج يحتذيها، والبعض حاول استنتساخ تجارب غربية ونقلها للوطن الجديد، أما الشريحة الأبرز فبحثت عن أرباب عمل جدد في الأحزاب والحركات السياسية المتشظية في العراق الجديد.
في ظل صراع ثنائية بغيضة وغريبة اسمها صراع مثقف الداخل المتهم بولائه السابق للديكتاتور مع مثقف الخارج المتهم بالقدوم على ظهر دبابة المحتل، ولدت منابر الثقافة في العراق الجديد، منابر انشطرت وتوالدت بطريقة أميبية، غير خاضعة لمنطق يحكمها، وانطلقت مئات الصحف وعشرات القنوات التلفزيونية، ومثلها من الاذاعات. اما المنظمات والجمعيات والحركات فلا ضابط ولا رابط لها. في سوق الهرج هذا، حاول المتحدثون باسم الثقافة أن يلتقطوا خبزتهم، التي كانت في أغلب الأحيان مغموسة بإذلال صاحب الدكان الثقافي قليل الخبرة السياسية والثقافية وحتى الحياتية، الذي ظهر فجأة من غياهب الفانتازيا العراقية. لذلك ولدت علاقة سايكوباثية مرضية بين رب العمل الإعلامي والثقافي والسياسي وشريحة المثقفين العاملين عنده، سمة هذه العلاقة الاحتقار المبطن والمخفي، الذي يكنه المثقف لرب عمله، والمحاباة الظاهرية والتملق الذي يبديه له، ما شكل نوعا من شيزوفرينيا شارع الثقافة العراقي.
في انتفاضة تشرين حيث كانت السمة العامة للمشاركين هي البساطة وعدم التسيس وعدم وجود قيادات ميدانية أو حتى وجوه معروفة، ممن شاركوا في حراكات سابقة، وكذلك عدم وجود ناشطين أو مدونين في منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك أدى إلى اتسام العلاقة بين المشاركين في الحراك من جهة والمثقفين من جهة اخرى بنوع من الجفوة وحتى التوتر، وصولا إلى الاتهامات المتبادلة، إذ سرعان ما اتهم المنتفضون المثقفين بأنهم أدوات بيد الحكومة، وأنهم انتهازيون يطبلون للحراك الجماهيري وهم في بيوتهم، وقد أطلقت توصيفات عدة على المثقف من بينها «ثوار الكيبورد» وغيرها، في إشارة على التحريض للخروج في الانتفاضة والهرب من المشاركة الحقيقة فيها. يضاف إلى ذلك كم هائل من الشتائم انصبت على رؤوس من يطلق عليهم توصيف «مثقفو الخارج»، واكثر هذه الاتهامات شيوعا هي المتاجرة بدم الابرياء في الداخل، بينما هم متنعمون هم وعوائلهم بالامان والاستقرار في مهاجرهم الغربية المستقرة. من جهة اخرى كانت أصوات بعض المثقفين تطالب من هم في الخارج بالصمت والامتناع عن التدخل أو حتى الخروج في وقفة تضامنية مع أهلهم في الداخل، واعتبروا ذلك نفاقا غير مبرر، وطالبوا من في الخارج إذا كانوا صادقين في مشاعرهم العودة إلى وطنهم والوقوف مع أهلهم في محنتهم، وإلا فإنهم مدعون وكاذبون.
اما موقف شريحة مهمة ممن يعدون أنفسهم مثقفين، أو ضمن المشتغلين في هذا القطاع، فقد أبدوا تعاطفهم وأسفهم على ما أريق من دماء الشباب، واستنكروا العنف الحكومي الذي سلط على المتظاهرين، لكنهم وضعوا أسئلة مفادها عدم جدوى الحراك، إذ طالما وضعت كلمة في نهاية اي مقال أو منشور متعاطف على منصات التواصل الاجتماعي ليلحقها عبارات مثل؛ وما هي نتيجة الحراك؟ وهل سيتمكنون من تغيير نظام المحاصصة الفاسد؟ وهل سيقدرون على إطاحة الحكومة ومواجهة ميليشاتها؟ وإنهم مجموعات من الشباب المتحمس صاحب الحقوق بالخروج للتظاهر والاحتجاج ، لكنهم لا يمتلكون الخبرة السياسية والثقافية؟ أو ما هو مشروعكم البديل؟
هذا التعاطي المتبادل بين الطرفين (المتظاهرين والمثقفين) خلق نوعا من التخدنق بينهما، وزاد من حدة التعاطي مع موجة احتجاجات قد تمر مثلما مرّ غيرها سابقا، إلا أن الشيطنة وصلت حد الترويج إلى أن هذا الحراك سيقود إلى الحرب الأهلية في البلد، وألقيت التهمة كما هو معتاد على طرف خفي جاهز كشماعة لتعليق خيباتنا عليها في كل مرة.