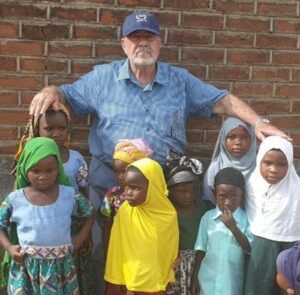رياض سعد
وُلِدَ قاسم في المدينة التي تتَنَفَّسُ صدأً… ؛ كانت شوارعها، فيما مضى، تمشي بأقدامٍ حافيةٍ على جمر الحرمان، تحت سماءٍ من صفيحٍ رصاصي… ؛ عاش أبناؤها في حِضْنِ العَوَز، يتناقلون الفُتاتَ كوصفةٍ للبقاء، مُتَكَيِّفينَ مع جَلَّادي الزمن، مُحَصَّنينَ ضد الانتحارِ بجلدٍ صَلْدٍ تَشَكَّلَ من سنواتِ القبضةِ الحديدية… ؛ كان اليأسُ عندهم رفيقاً مألوفاً، لا غازياً مُرْعِباً.
وُلد قاسم في مدينةٍ تعرف الفقر كما يُعرف الاسم، لا بوصفه لعنة، بل كعادةٍ يومية...
نعم , كان الجوع هناك صامتًا، والحرمان مهذّبًا، والناس يتقاسمون القسوة كما يتقاسمون الخبز اليابس، دون أن يفكّروا في الهرب من الحياة نفسها… ؛ كانوا محاصرين، نعم، لكنهم لم يكونوا مهزومين من الداخل؛ فالسجن الكبير الذي اسمه الوطن آنذاك لم يكن يسمح حتى بتخيّل نافذة…
الا ان قاسم لم يولد في الهامش، بل وُلد بعد انهيار نظام القمع والتهميش والافقار عام 2003 ... ؛ فالمدينة الشعبية التي جاء منها لم تعد كما كانت في ذاكرة آبائها؛ الفقر لم يعد جماعيًا، بل فرديًا، والحرمان لم يعد قدرًا مشتركًا بل فشلًا شخصيًا يُحاسَب عليه صاحبه… ؛ و هنا تكمن أولى المفارقات التي ستشكّل وعيه …
فقبل ولادته بأشهر معدودة ؛ سقط الجدار الصدامي البعثي المقيت ؛ وفجأة، صار الهواء وفيرًا أكثر مما ينبغي، وصارت الحرية ثقيلة على الأكتاف الغضّة… ؛ وانفتحتْ أبوابُ السماءِ المُغَبَّرة، ونزلَتْ وعودُ الحريةِ كأمطارٍ غريبةٍ على أرضٍ لم تَتَعَوَّدْ إلا على قطرات الدم… ؛ و تَهَافَتَ النورُ على البيوت، وتوسعتْ صدورُ الناسِ بزَفيرٍ طويلٍ، كأنهم وُلِدُوا من جديد…
نعم , جاء قاسم مع انبلاجِ الصباحِ الجديد، كأن قَدَرَهُ أن يَفْقِسَ من بيضةِ القمعِ مباشرةً إلى فراغِ الفضاءِ الواسع، حراً، كالنسرِ الذي تَعلَّمَتْ أجنحتُهُ التشكُّلَ في القَفَص…
فالأجيال السابقة عاشت القسوة بلا مقارنة، أما جيله فكان يرى العالم كله، ولا يملك منه شيئًا...
نشأ قاسم في بيتٍ مستقرّ، بلا نقصٍ ماديّ حاد، محاطًا بعنايةٍ زائدة، كأن الأسرة كانت تحاول أن تحميه من تاريخٍ لم يعشه… ؛دلّلته عائلته كما يُدلَّل الناجون، وكأنهم أرادوا تعويض قرنٍ من القهر في جسدٍ واحد… .
وفي علم النفس، يُسمّى هذا فرط التعويض: حين يُربّى الطفل المدلل لا ليواجه الواقع، بل ليُعفى منه...
نَشَأَ قاسم في حَجْرٍ دافئٍ، مُدَلَّلاً، باعتباره آخرَ عنقودٍ في سلسلةٍ من الأبناء الخمسة … ؛ نما كالسَّنْبَلَةِ في تربةٍ خَصْبَة، فصارَ فارعَ الطول، أبيضَ كالحليبِ تحت القمر، عيناهُ واسعتان جميلتان من سَعَةِ الدنيا التي لم يَعرفْ ضِيقَها… ؛ كان جسدُهُ نحيلاً قوياً، يَتمايلُ في مشيتهِ تمايلَ سَعَفَةٍ نادرةٍ تهزُّها ريحٌ عابرة، كأنه إيقاعٌ مَطْوِيٌ داخل نغمة… ؛ زادَتْهُ الرياضةُ صلابةً وَوَهَجاً، وَرُبَّما غُرُوراً.
نعم ؛ كبر جميلًا، وكان جماله أشبه بسكينٍ لامعة: نعمة في الظاهر، وخطرًا في العمق… ؛ و مصدر قوةٍ وسوء تقدير في آنٍ واحد؛ إذ اعتاد أن تُفتح له الأبواب بسهولة، فظنّ—بلا وعي—أن العالم يعمل هكذا... ؛ كان يمشي وكأن الأرض أقلّ من أن تحمله، ويتحرّك كمن يعرف أن العيون تلاحقه قبل الخطى…
عندما اشتدَّ عُودُهُ، و بلغ السابعةَ عشرة، بدأ الشرخ… ؛ و نَظَرَ إلى وطنهِ بِعَيْنَيْ مُستكشِفٍ وَقَعَ في أرضٍ بَائِسَة… ؛ كَرِهَهُ كُرْهاً شديداً، مُتَجَلِّداً كالبلور… ؛ كره المكان لا لأنه قاسٍ، بل لأنه أصغر من خياله… ؛ و لم يُدركْ سرَّ صبرِ أولئك الأقدمينَ على الذلِّ والجوعِ والسجونِ والهُوَّاتِ التي تفتحُ في منتصف الطريق في عهد صدام … ؛ لم يَعْلَمْ أنهم كانوا سُجناءَ في غرفةٍ مُعَزَّولةٍ اسمها “العراق”، حيثُ كانت النوافذُ مُحْكَمَةَ الإغلاق، والهواءُ الآتِي من العالمِ الخارجيِّ مَشْفُوعاً بِرَقابةٍ صارمة… ؛ أما هو، فَصَحَا في عالَمٍ بلا أسقف، حيثُ العالَمُ كلُّهُ قريةٌ مُعلَّقةٌ في سحابةِ اللاّمكان … ؛ فقد عاشَ قاسمُ وأقرانُهُ حياةً مُنْشَطِرَةً: أرواحُهم تَسْكُنُ باريسَ وبرلينَ ولندن، بينما أجسادُهم تَرْقدُ على أَرائِكَ بغدادَ أوبوادي الناصرية أو أهوار العمارة ، كأنها أغطيةٌ فارغة… ؛ أَصَابَ هذا الانْشِطارُ روحَهُ بِفَجْوَةٍ هائلة، كَوَّنَتْ فِيها سُحُبُ الاكتئابِ عاصفةً سوداء… ؛ فقد حاولَ أن يرمي نفسَهُ في نهر دجلة ، لولا أنْ أمسكَ بهِ صديقُهُ حُسَين، كالغُصْنِ الذي يمنعُ ورقةً من السقوط.
نعم , لم يفهم كيف صبر السابقون، ولم يدرك أنهم لم يكونوا يملكون المقارنة… ؛
فهو ابن الشاشات الزرقاء المفتوحة، والخرائط الرقمية، والمدن التي تُزار بالأفكار قبل الأقدام… ؛ كان يعيش في بغداد بجسده، وفي عواصم العالم بروحه، فتمزّق بين صورتين: حياة لا تشبه أحلامه، وأحلام لا تشبه واقعه… ؛ كان محاطًا بعالم افتراضي يَعِد بالكثير، ويمنح القليل، فدخل في ما يصفه علم الاجتماع بـ الاغتراب المقارن: أن تقيس حياتك بما تراه لا بما تعيشه.
أحسَّ الأبُ بِزَلْزَلَةِ الخطرِ في أساسِ البيت… ؛ فجَمَعَ لابنهِ حُزْمَةً من الأملِ المُصْطَفَى، على شكلِ مال، ليُلَبِّيَ حُلْمَ الهجرةِ إلى أورُوبَّا، حيثُ تُرْسَمُ الحياةُ بألوانِ الجنةِ الموعودة… ؛ حين غادر البلاد، لم يكن هاربًا من الفقر، بل من الشعور بعدم الانتماء…
سافرَ قاسمُ وحسين عبرَ تركيا، ثم رَكَبا في أحشاءِ قاربٍ مَهْزُومٍ، يَخْتِرِقُ جَسَدَ البحرِ الأبيض المتوسط… ؛ لكنْ، في إحدى الجُزُرِ المُتْعَبَة، وَقَعَتْ خصومة و شِجَارٌ مع رُكَّابٍ أفغان متعصبين دينيا ، وانتهى بغَدرَةٍ سَكِّينٍ تَغْرَسُ نفسَها في قلبِ حسين… ؛ وحين قُتل صديقه في الطريق، انهار التوازن النفسي الأخير لديه… ؛ الفقد هنا لم يكن عاطفيًا فقط، بل وجوديًا: فالموت المفاجئ يجرّد الحياة من منطقها، ويجعل كل الخيارات متساوية في عبثيتها.
بَقِيَ قاسمُ جاثياً أمامَ القبرِ المُؤَقَّتِ على الشاطئ، بينما انْسَحَبَ البحرُ بكلِّ أمواجهِ كأنَّ شيئاً لم يَكُن… ؛ حين مات صديقه في طريق الهجرة، لم يمت وحده… ؛ مات المعنى… ؛ ومنذ تلك اللحظة، صار قاسم يمشي وهو فارغ، كقنينة أُلقيت في بحرٍ لا يعرف الرسائل…
وَصَلَ أثينا، المدينة البيضاء، حيثُ تَشَتَّتَ الرفاقُ كذراتِ غبارٍ في مهبِّ الريح، وبَقِيَ هو وَحيداً، لا يدري أين تُؤدِّي بهِ الخطوات.
عاشَ أياماً في غُرفِ فنادقَ رخيصة، سَكْرَانَ بِجمالِ المدينةِ ولوعةِ الفقدِ معاً… ؛ و تَعَرَّفَ على شابٍّ تونسيٍّ، فأخذَهُ الأخيرُ إلى عالَمِ النسيانِ السائل: قناني خمرٍ تَتَحَوَّلُ إلى أنهارٍ سوداءَ تَجْرُفُ الذاكرة… ؛ استمرَّ شهرينَ في دوامةِ الطعامِ الجاهزِ في المطاعم , والنومِ الثقيلِ والدُّخانِ الكثيفِ الذي يُغَطِّي مرآةَ النفس… ؛ وعندما تَثُورُ الشهوةُ الجسديةُ، كان يَلْجَأُ إلى جسدِهِ وحده، في طقسٍ مُهينٍ من العُزلة… ؛ حيث يمارس العادة السرية .
في المدينة الأوروبية، عاش المرحلة التي يسميها علماء النفس التفريغ: إنفاق المال، الإفراط في اللذة، محاولة نسيان الصدمة عبر الاستهلاك… ؛ لكن المال ينفد، والصدمة لا.
ففي اثنيا ، أكل حتى الشبع، شرب حتى النسيان، ثم… نفد كل شيء… ؛ وحين ينفد المال، يبدأ الحساب الحقيقي.
نعم , نَفَدَ المال… ؛ و ضاقَتِ الدنيا فجأةً كَفتحة الابرة الصغيرة… ؛ أصبحَ الظلُّ سَقْفاً، والحديقةُ العامةُ سريراً، حيثُ يَضَعُ حقيبتَهُ تحت رأسهِ، ويتلفعُ بِلِحافِ النجومِ الباردة… ؛ و يَتَغَذَّى على فُتَاتِ المَوائدِ في زوايا الطرقاتِ، ويَغْتَسِلُ بِخِجْلٍ في حماماتِ المحطات.
بلى , صار ينام تحت السماء، ويغتسل من الخجل قبل الغبار، ويكتشف أن الجوع ليس ألم المعدة فقط، بل انكسار الكرامة.
عندما وجد نفسه بلا مأوى، بلا طعام، وبلا شبكة دعم، دخل مرحلة البقاء الخالص…
هنا تتراجع الأخلاق إلى موقعها الحقيقي: ليست مبادئ مطلقة، بل ترفًا مشروطًا بالأمان…
لم يفكر قاسم كثيرًا؛ الجوع لا يمنح وقتًا للفلسفة، لكنه يصنعها لاحقًا…
اكتشف—متأخرًا—أن الجسد في سوق العالم الحديث ليس ملكًا لصاحبه دائمًا، بل موردًا يُستثمر حين تنعدم الخيارات… !!
وفي إحدى الأيام، اقتربَ منه رجلٌ يُونانيٌّ اربعيني يُدْعَى بِيترُو… ؛ تَهادَتْ بينهما كلماتٌ بسيطة، ثم قدَّمَ لهُ خمسَ يوروهاتٍ مُقابلَ تدليكٍ للكتفينِ المُتَعَبين… ؛ وافقَ قاسم، وشَعَرَ بأصابِعِهِ، وهي تَفركُ جسدَ غريب، كأنها تَمسحُ كرامتَهُ نفسَها...
عادَ في اليوم التالي، لكنَّ الطلبَ كان مختلفاً… ؛ “هل تَمارِسُ الجنسَ معي؟” سألهُ بيترو بعشرةِ يوروهات… ؛ ارتَدَّ قاسمُ كمنْ لُطِمَ، ففي صميمِ كِيانِهِ، كان هذا الفعلُ هوةً سوداءَ لا يُشرِقُ فيها نور… ؛ رَفَض، فانصرفَ الرجل اليوناني من دون رجعة .
عندها فهم الحقيقة التي لا تُدرّس: أن الجسد، حين يُحاصر، يتحوّل إلى عملة.
وأن بعض الأبواب لا تُفتح إلا حين تُغلق في داخلك نوافذ كثيرة.
اشتدَّ الجوعُ، وصارَ كالوحشِ الذي يَنْهَشُ الأحشاء… ؛ و في إحدى حَدائِقِ اللقاءاتِ المَشْبُوهة، حيثُ يَتَرَصَّدُ المثليونَ ضحاياهم، ظهرَ رجلٌ خمسيني سعوديٌّ مُتأنِّق…
“أَنْتَ عراقي… أنتمُ الرجالُ الحقيقيون، جمعتُم الجمالَ والقوة” قالهُ مبتسماً، ثمَّ أضافَ، كمنْ يقدمُ عرضاً تجارياً: “أبحثُ عن شابٍّ قويٍّ مثلك… ؛ أكونُ أنا المرأة والزوجة وهو الرجل … ؛ مقابل مائةُ يورو… لكلِّ مرة…!! “
تَجَمَّدَ قاسم… ؛ اذ رأى أمامَ عينيهِ جبلاً من الذهبِ وقد انهارَ على رأسِ جوعِه… ؛ سَكَتَتْ كلُّ القِيمُ في داخلهِ لحظةً واحدة… ؛ وافق...!!
في غرفةِ الفندقِ الفاخر، شَرِبَ قاسمٌ حتى الثمالة، كي يَغْرَقَ وَعْيُهُ ولا يرى ما يحدث… ؛ ثمَّ تحوَّلَ إلى آلةٍ بلا روح… ؛ وقد أذهلَت قوَّتَهُ الجنسية والعضلية الرجلَ السعودي، “أبو مشاري”، الذي دفعَ ألفاً بدلاً من سبعمائة – مقابل سبع مرات من النكاح المتواصل على مدى ست ساعات – ، وألبسَهُ من الملابس الراقية ِ، وأطعمَهُ أطايبَ الطعام…
بَقِيَا معاً عشرةَ أيام، ينتقلان بين أفخمِ المطاعمِ وأجملِ المتاجر، وفي الليلِ يتحوَّلُ قاسمُ إلى وحشٍ غريبٍ يَفْرِسُ جسدَ الشيخِ مقابل المالِ والمأوى… ؛ أهداهُ أبو مشاري، عند الرحيل، هاتفاً جديداً وأربعةَ آلافِ يورو… ؛ تَعانَقَا في المطارِ عناقَ العشاقِ الزائف، حيثُ تَختلطُ أنفاسُ الشهوةِ بأنفاسِ الندم والمصلحة …
لم يكن ما حدث نتيجة انحراف، بل نتيجة اختلال ميزان القوة: طرف يملك المال، وطرف يملك الحاجة... ؛ ومع كل تنازل، لم يكن يشعر بالذنب بقدر ما كان يشعر بالفراغ.
الذنب يفترض وجود معنى أخلاقي ثابت، أما الفراغ فهو علامة على تآكل المعنى نفسه.
نعم , لم يكن ما فعله شهوة، بل مقايضة صامتة مع العالم... ؛ كان يمنح ما لا يريد، ليشتري ما يحتاج.
وكل مرة، كان يشعر أن شيئًا منه يُترك خلفه، على مصطبة، أو في غرفة، أو في مرآة لا ينظر إليها طويلًا...
عادَ قاسمُ إلى الحديقة العامة، إلى نفسِ المصطبة الخشبية ؛ جلسَ، وقد تَحَوَّلَ جسدُهُ إلى سلعةٍ مُعَرَّوضةٍ في سوقِ النهار… ؛ ربما ينتظرُ زبوناً آخرَ يُشبِهُ أبا مشاري، بينما تَهْمِسُ في أذنيهِ ريحٌ عابرة: “مَنْ أنتَ الآن، يا وَلَدَ المدينةِ الاوربية ؟”
وتحت أقدامه، بدا ظلُّهُ طويلاً، مُشَوَّهاً، كأنه طائرٌ كَسيرُ الجناحين، نَسِيَ كيف يَحِلِّقُ نحو السماءِ التي وُلِدَ منها.
نعم , حين انتهت المرحلة، وعاد إلى الحديقة، لم يعد الشخص ذاته... ؛فالنفس، حين تُباع مرة، لا تعود كاملة.
لم يكن محطمًا بالكامل، لكنه لم يكن سليمًا.
كان مثالًا حيًا على ما يسميه الفيلسوف سارتر:
الإنسان محكوم بالحرية، حتى حين لا يملك خيارًا جيدًا.
جلس على المصطبة ذاتها، لا ينتظر شخصًا بعينه، بل احتمالًا منقذا كأبي مشاري السعودي .
احتمال أن تبدأ الحياة من جديد،
أو أن تستمر كما هي، بلا تفسير.
وفي الحالتين، كان يعرف شيئًا واحدًا فقط:
أن الإنسان لا يسقط دفعة واحدة،
بل ينزلق ببطء، خطوةً مبرَّرة بعد خطوة.