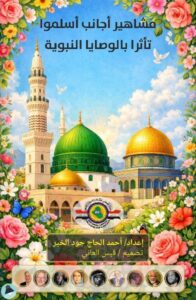رياض سعد
في ظهيرةٍ متعبةٍ من تموز البغدادي اللاهب، كان السائق محمد يجوب شوارع العاصمة كما يهيم الظمآن في صحراء قاحلة… ؛ عيناه تجوسان في وجوه المارّة، تفتشان عن يدٍ ممدودةٍ تشير إليه، لعلّه يظفر بركابٍ يضيفون شيئًا من الدنانير إلى كيسه المتعب.
لم يكن محمد رجلاً طمّاعًا، لكنه كان مثقلاً بالتزاماتٍ تئنّ تحت وطأتها روحه : فواتير الكهرباء والماء، أجور المدارس الأهلية، مستحقات الإنترنت، حاجيات زوجته، وألعابه الصغيرة لطفلته… ؛ كل ذلك يسير معه في السيارة كأنهم ركّابٌ لا يدفعون أجرة.
وبينما يغوص في متاهات حساباته المالية، لاحت له على الرصيف فتاةٌ صغيرة تجرّ حقيبتين تكادان تمزّقان ذراعيها النحيلتين، ترتدي عباءة سوداء فضفاضة، يلوح في ملامحها مزيجٌ عجيب من السذاجة والبراءة، ومن الحزن المكسور والشرف المهيب …
رفعت يدها بخجلٍ وأشارت نحوه، فتوقف، نزل من السيارة وساعدها على وضع الحقائب، ثم سألها إلى أين؟
قالت بخفوت: “إلى المنصور، كم الأجرة؟”
أجاب: “اثنا عشر ألفًا.”
قالت: “عشرة، فقط لدي عشرة.”
ابتسم محمد بحنوّ وقال: “اصعدي، لا بأس.”
لكن ما إن أغلقت باب السيارة وبدت وحدها تمامًا، حتى تسللت الريبة إلى قلبه، وسألها:
“من أين أنتِ؟ وأين أهلك؟ وكيف تخرجين وحدكِ في هذا الحرّ؟”
سكتت لحظة، ثم فجأة، انهمرت دموعها كسيلٍ لم يجد سدًّا يردّه، وقالت بصوتٍ مرتعش:
“عمو… أقول لك الحقيقة، لكن لا تسيء الظن بي، والله وثقت بك عمو .”
ارتبك محمد، وانتفضت داخله عاطفة لم يكن يتوقعها، وقال:
“تكلمي يا بنتي، أنا مثل أبوكِ، والله.”
قالت:
“أنا اسمي حوراء، عمري خمس عشرة سنة… ؛ عايشة مع أهلي بمنطقة راقية، أبي غني، بس ما يحبني … ؛ دائمًا يشتمني امام الاقارب ، يقلل من قيمتي، يصفني بالحمق، ويخاصم أمي اللي أحبها منذ كنت صغيرة… ؛ نعم انا مدللة من الناحية المادية ؛ ولكن أنا تعيسة، أحس بالذل كل يوم… ؛ حتى لما أنجح أو أعمل شيء جيد ، لا يفرح أبي ولا يشجعني … ؛ لذا قررت أهرب من البيت ، اذ يمكنني ان ألقى حياة أحسن بأذن الله .”
أطرق محمد رأسه لحظة، ثم قال وهو يحاول كبح حزنه:
” ابنتي عزيزتي … ؛ حتى أنا أحيانًا أصرخ على أولادي، و أتخاصم مع أمهم، الا ان هذه التصرفات العفوية لا تعني كراهية … ؛ بل هي طباع البشر منذ الازل … ؛ انت لم تتحملي تصرفات (ابوك ) فكيف تتحمّلين الشارع؟ الشارع ليس حضنا دافئا يا عزيزتي … ؛ انه بركان تنهمر منه نيران تشوي الوجوه وتحيل الاجساد الى ركام … ؛ فالشارع كالغابة المليئة بشتى الوحوش الكاسرة والتي لا تعرف الرحمة …
أكمل وقد ارتجّ صوته:
” كيف تذهبي وحدك الى منطقة لا تعرفينها؟ انتي صغيرة، ليست لديك اية خبرة في الحياة ، انت لا تعرفين بعد القلوب السوداء والنفوس المرضة … ؛ هناك في الشوارع : يغتصبوك، يستغلوك، يبيعونك قطعة قطعة ، يحوّلوك إلى كائن مسخ مدمن على المخدرات والجنس الرخيص … ؛ وهذا الطريق الوعر لا رجعة فيه ابدا … ؛ وكل من سار فيه لم يرجع الى اهله وبيته بعدها , وهام على وجهه في الشوارع تتقاذفه امواج الازقة الضيقة والاماكن الموبوءة…؛ لذا اقسم عليك بالله العلي العظيم بالرجوع الى بيت اهلك والى حضن امك …. ؛ وانا لا استطيع ايصال الى حتفك , فأنت كأبنتي الصغيرة …
تسمرت عيناه في مرآة السيارة وهو يراقب وجهها، فرأى فيه طفولةً تختنق، وسذاجةً تتحدى الحياة بشجاعة كاذبة.
قالت بتردد :”عمو، لا تخاف عليّ، أنا شاطرة… أقدر أدبّر نفسي.”
لكن محمد أيقن أن ما بين الشطارة والتهلكة، خيطٌ رفيع اسمه الطيش والجهل .
قال بحزم:
“أنا أرجعك، وغصبًا عنك إذا اضطررت لذلك … ؛ أنتي مثل بنتي، ولا أقدر ان أرميك للشارع الذي لا يرحم امثالك .”
استدارت السيارة، كأنها تقود القدر من جديد إلى الصواب.
وفي الطريق، لم تكفّ حوراء عن البكاء، ثم قالت بانكسار:
“عمو، خذني معك الى بيتك ، اخاف من أهلي لئلا يقتلوني.”
تنهد محمد، وشدّ على المقود بقبضة مرتعشة، وقال:
“والله العظيم لا اسمح لاحد بإيذائك قط ؛ أنتي أمانة برقبتي.”
وصل إلى بيت أهلها، طرق الباب، وخرج الأب مكفهر الوجه، تتبعه نظرات القلق.
أخرجوا الحقائب، وتكلم محمد بلهجة لا تحتمل المساومة:
“هذه بنتك المسكينة ، قلبها مكسور، وانت مسؤول…؛ أقسم بالله العظيم لو لمستها بسوء، لن اتساهل معك فهي دخيلة عندي وانا ابن عشائر وعادات وتقاليد لا تسمح بإعطاء الدخيل وتسليمه الا اني وثقت بك فانت اباها …”
اندهش الأب، وأقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يعيد الإساءة وسوف يحسن معاملتها .
ركب محمد سيارته ودموعه تسيل بصمت.
عاد إلى بيته، ضمّ ابنته الصغيرة، ولاعبها حتى ضحكت، وكأن شيئًا في قلبه قد تغيّر إلى الأبد.
ولأول مرة منذ سنين…؛ أحسّ أن الحياة، رغم قسوتها، لا تزال تمنحنا فرصة أن نكون بشرًا.