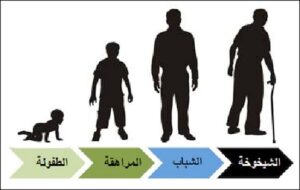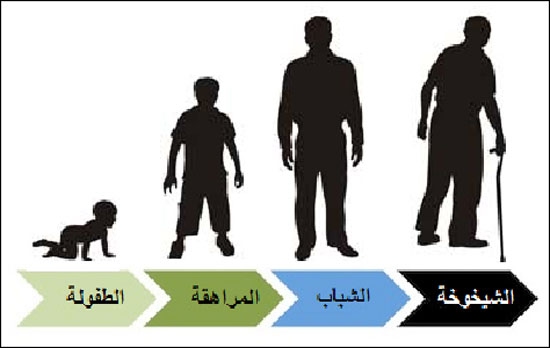مقاربة فلسفية – صوفية- أنثروبولوجية – اجتماعية نفسية – في جدل الفرد والهوية
رياض سعد
ليس الإنسان كائنًا طائفيًا بالفطرة، ولا يولد حاملًا لهوية مغلقة أو أحكامٍ مسبقة تجاه جماعة دينية أو عرقية بعينها أو وعيًا إقصائيًا تجاه الآخر … ؛ فالطائفية والعنصرية ، كما سائر أشكال التمركز الهويّاتي الصلب ، ليست معطًى طبيعيًا مغروسًا في جوهر الطبيعة البشرية , ولا ضرورة أنثروبولوجية ، بل هي بناءٌ اجتماعي–نفسي ونتاج تاريخي يتشكّل عبر مسارات التنشئة الأولى… ؛ و آليات التلقين الاجتماعية , حيث تتقاطع اللغة، والأسرة، والذاكرة الجمعية، والرموز، والخطابات، والطقوس، لتصوغ بنيةً إدراكية ونفسية تُقدَّم للفرد بوصفها “الطبيعي” و“البديهي”.
اذ يولد الإنسان كائنًا مفتوحًا، قابلًا للانتماء، هشّ الحدود، واسع الإمكانات، ثم تبدأ هذه القابلية الخام بالتصلّب والتشكّل عبر اللغة، والأسرة، والذاكرة الجمعية، والخطاب السائد، والطقوس، والعادات، والأعراف كما اسلفنا .
فالإنسان يولد قابلًا للانتماء، لا منتميًا سلفًا… ؛ وهذه القابلية، في ذاتها، حيادية ومفتوحة؛ غير أنها سرعان ما تُوجَّه وتُحدَّد داخل أطر ضيقة، فتتحوّل من استعداد وجودي للتواصل والمعنى، إلى انغلاق هويّاتي يُعيد إنتاج ذاته عبر الأجيال… ؛ ومن هنا، لا يمكن الحديث عن محوٍ كامل لأثر التنشئة الأولى، إذ ما يُغرس في البدايات يستقر في طبقات اللاوعي، ويتحوّل إلى بنية نفسية عميقة تعمل بصمت، وتُوجّه الإدراك والسلوك دون أن تعلن عن نفسها.
نعم , في هذا السياق، تتحوّل الهوية من أفقٍ مفتوح إلى إطارٍ مغلق، ومن تجربة وجودية إلى تصنيف قسري… ؛ ولا يمكن محو أثر هذه التنشئة محوًا تامًا؛ إذ سرعان ما تستقر في طبقات النفس العميقة، وتغدو جزءًا من البنية اللاواعية للفرد… ؛ إن وهم “التجرد الكامل” من التربية الأولى ليس سوى إنكارٍ للذات وتاريخها، أما التحرر الحقيقي فلا يكمن في القطيعة، بل في الوعي النقدي: إدراك الجذور دون الخضوع المطلق لها، والتمييز بين ما تحمله من معانٍ إنسانية حيّة، وما تختزنه من رواسب إقصائية أو أسطورية أو عنيفة كما اسلفنا … .
نعم ,الوعي النقدي يتيح إمكانًا آخر: لا القطيعة الوهمية مع الجذور، ولا الاستسلام المطلق لها… ؛ فالتحرر الحقيقي لا يتمثل في إنكار الأصل، بل في تفكيكه، وإعادة قراءته، وضبط سلطته على الوعي… ؛ إن التربية الأولى تحمل الغث والسمين معًا؛ تحمل المعنى والدفء، كما تحمل الوهم والعنف الرمزي، ولا نجاة إلا بالتمييز كما اسلفنا .
من منظور فلسفي–صوفي، يظهر الإنسان بوصفه كائنًا ذا طبيعة كونية، تتجاوز حدود التعريفات الجاهزة… ؛ فهو ليس مجرد كيان اجتماعي قابل للتصنيف، بل ذاتٌ منفتحة على المطلق، تحمل في أعماقها نزوعًا أصيلًا إلى الاتساع والتجاوز… ؛ لذلك لم يكن توجّه الإنسان نحو السماء، عبر التاريخ، مجرد تعبير ديني أو ميثولوجي، بل رمزًا وجوديًا لسعيه الدائم إلى ما يتخطّى المحدود، وإلى المعنى الذي لا يُختزل في إطار واحد.
وفي هذا السياق، تبدو مفارقة الاختزال صادمة: كيف لكائنٍ “انطوى فيه العالم الأكبر”، بحسب التعبير العرفاني، أن يُحاصر داخل دوائر ضيقة من العِرق، أو القومية، أو المذهب، أو الجغرافيا، أو الحزب، أو الأيديولوجيا؟!
كيف أمكن لهذا الوجود الرحب أن يُختزل في علامة، أو شعار، أو بطاقة هوية؟!
ومن منظور أنثروبولوجي، يظهر الإنسان بوصفه كائنًا رمزيًا بامتياز؛ يعيش داخل شبكات من المعاني التي ينسجها بنفسه ثم يقع أسيرًا لها… ؛ فالهوية، حين تتحوّل من أداة تعريف إلى أداة حصر، ومن معنى إلى عقيدة صمّاء، تصبح سجنًا ناعمًا لا قضبان له، لكنه أشدّ فتكًا من الزنازين المظلمة … .
منذ أن وُجد الإنسان على هذه المعمورة، كان بصره مشدودًا إلى السماء؛ لا بمعناها الديني فحسب، بل بوصفها رمزًا للتجاوز، وللقلق الوجودي، وللسؤال الذي لا يهدأ – كما اسلفنا – .
إن الإنسان كائن كوني، مخلوق مشدود بين الأرض والسماء، بين المحدود واللامحدود… ؛ ومن هنا تنبع الدهشة: كيف أمكن لقوى السلطة، أيًّا كانت تسمياتها— حكامًا، أنظمة، خطابات، أو حتى “شياطين رمزية” بالمعنى المجازي او مخلوقات فضائية ما شئت فعبر —أن تحاصر هذا الكائن الواسع داخل دوائر خانقة، أشبه بزنازين الاعتقال، تحت مسميات الهوية الصلبة؟
الأعجب من ذلك ليس فعل الحصر ذاته، بل قابلية الإنسان له… ؛ اذ كيف رضي هذا الكائن الهائل أن ينكمش، وأن يتحوّل إلى ما يشبه المارد العظيم المختبئ داخل مصباح صغير، يتحكم به من يملك المصباح لا من يملك الجوهر؟
هنا يلتقي التحليل النفسي بالتحليل الاجتماعي: فالحاجة إلى الانتماء، والخوف من العزلة، والرغبة في الأمان الرمزي، تجعل الفرد مستعدًا للتنازل عن اتساعه الداخلي مقابل يقينٍ ضيق، وعن حريته الوجودية مقابل هوية جاهزة.
إن أزمة الإنسان المعاصر ليست في تعدد الهويات، بل في تأليهها، ولا في الانتماء، بل في تحوّله إلى قيد… ؛ فالهوية حين تنفصل عن بعدها الإنساني الكوني، تتحوّل من جسرٍ إلى جدار، ومن معنى إلى أداة إقصاء… ؛ أما الإنسان الفرد، في جوهره، فهو أوسع من كل تصنيف، وأعمق من كل شعار، وأغنى من كل سردية مكتملة.
إن هذا الواقع، بما يحمله من مفارقات، يدعو حقًا إلى الدهشة والحيرة؛ لا بوصفهما عجزًا عن الفهم، بل كبدايةٍ للسؤال، وبوابةٍ لتحرير الإنسان من اختزاله، وإعادته إلى مقامه الطبيعي: كائنًا مفتوحًا على العالم، لا أسيرًا لهويةٍ تدّعي حمايته وهي في الحقيقة تضيق عليه الخناق... ؛ فالإنسان كائن رمزي، يعيش داخل شبكات من الدلالات يصنعها بنفسه، ثم يقع أسيرًا لها… ؛ والهوية، حين تتحوّل من أفق دلالي مفتوح إلى بنية مغلقة، تصبح أداة ضبط لا أداة تعريف، وسجنًا ناعمًا بلا جدران مرئية كما اسلفنا … ؛ إنها لا تُقيّد الجسد، بل تُعيد تشكيل الوعي، فتجعل المحدود يبدو طبيعيًا، والضيق يبدو قدرًا.