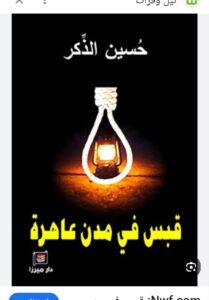رياض سعد
نشأتُ كـ”حفيد أساطير”… ؛ أسمعُ أصواتَ الأجدادِ تنسابُ من شقوق الجدران، تُحوِّلُ حكايات العشيرة إلى سردٍ ميثولوجي , اذ تُروى كملاحم مقدسة : “المشيخة” بوصفها عرشًا من تراب ودم , وإكليلَ مُلكٍ ممتدٍّ على ضفاف دجلة، و”المجد” الذي يذوب في مياه الأهوار كسرابٍ لا يُدرك… ؛ رغم اني وُلِدتُ في بغداد، ولا أفضِّل سواها عليها حقًّا … ، وقد نشأ أبي بين أزقَّتها منذ كان فتى يافعا ، وجاءها اقاربي وارحامي من الجنوب منذ عقود ، وحفرت أسماؤهم في ذاكرة المدينة القديمة… ؛ لكن جذورنا الجنوبية ظلَّت كالنخلةِ تتحدى الزمن؛ فقد جئناها حاملين اسماء منقوشةً على ألواحٍ طينية، وتمائم سومرية , وهامات سمر رافدينية ؛ حتى ازددتُ قناعةً بأن بغداد امتدادٌ للسهل الرسوبي الجنوبي، لا للصحاري والهضاب والجبال ، رغم موجات الهجرات الاجنبية والثقافات الوافدة والتغييرات الديموغرافية التي غيَّرت ملامحها… ؛ نعم، في العراق يسير التاريخ عكس المنطق: فبينما العواصمُ مرايا لهوية أهلها الاصلاء … ؛ صِيغَت بغداد لتصيرَ فسيفساءَ للغرباء والاجانب والدخلاء – عثمانيِّين وتركًا وإيرانيين وارمن واثوريين واعراب وشيشان وهنود مهاجرين … الخ – كأنما نُزِعَت منها روحُ الجنوب العراقية والعراقة الوطنية وحُوِّلت إلى مركبٍ يعكس تناقضاتِ التاريخ , ومدينة تعيش على التناقضات واختلاف الرؤى والمزاجيات والسلوكيات … ؛ نعم، العراقُ يسيرُ كساعةٍ معكوسة: عواصمُ العالمِ تُنصتُ لقلبِ أهلها، أما بغدادُ فصمَّاءُ كبابِلَ، تسمحُ للغرباءَ ببناء أبراجهم فوق لسانها، بينما يُنزفُ الجنوبُ من عروقها، ويُحوَّلُ إلى أسطورةٍ تُروى في ليالي السمر… ؛ نعم الجنوبُ يشبهُ وعاءَ الفخَّار – كلما كسرته اكتشفتَ أنه يحوي وعاءً آخر… ؛ أما بغدادُ فهي اليدُ التي تمسكُ الوعاءَ وتُسقطه في الوقتِ نفسِه … ؛ لكنَّ بغداد – رغم كل شيء – ظلَّتْ تُشبهني: جسدٌ يُزيحُ ترابَ الهضابِ عن كتفيه، وينصاعُ لنداء السهل الرسوبي، حتى لو اختبأ تحتَ أظافرها أنقاضُ عثمانيين وإيرانيين واعراب ومجنسين .
أنتمي إلى عشيرةٍ وُلدتْ من رحمِ الطين والماء، تمتدُّ كشبكةِ عروقٍ تحت جلد العراق : من الشمال إلى البصرة , وكجذور النخيل تخترق الأرضَ وتتحدى الحدودَ… ، تتناثرُ بيوتُها كحروفٍ مسماريةٍ على رقيمٍ مكسور… ؛ نحنُ شيعةٌ وسُنَّة، لكنَّ دمَ العشيرةِ أزرقُ في عروقنا جميعًا … ؛ يتنوع أبناؤها بين مذاهبَ وأفكار، لكنهم يشتركون في سماتٍ تكاد تكون أسطورية: كرمٌ يُجفِّفُ غيومَ الشح، وشجاعةٌ تُرهبُ الأعداء، وفطنةٌ تُحلُّ أعقدَ الأمور… ؛ حتى هندامهم – أو “الكشخة” كما نسميها – يروي حكايةَ كبرياءٍ لا تنثني … ؛ “فالكشخة” في هندامنا ليست زينةً، بل شفرةٌ تُخبرُ أننا أبناءُ ملوكٍ من زمنٍ يسبقُ التاريخَ المكتوب…؛ نعم قد تربَّيتُ – في بيت مشيخة وديوان قبيلة – على مكارم أخلاقٍ صارت نادرةً في وقتنا الراهن : النخوةُ التي تُحيي الموتى، والفراضةُ التي تحق الحق وتزهق الباطل و تحمي الضعيف، والعزوبيةُ التي ترفض البخل والخسة ؛ والفزعة لنجدة المظلوم … ؛ كانت هذه القيمُ تمائمَ نعلِّقها على جدران الذاكرة لطرد شياطين الحداثة ورفض قيم المدينة الاجنبية ، أو لنُقل: لتخفيف وطأتها على روحٍ تحلمُ بأجنحةٍ تتخطى جغرافيا العشيرة التي ترفض الانحناء حتى لأصوات الرصاص .
سمعتُ منذ الصغر حكاياتِ الأجداد عن زمنِ العز، حين كانت المشيخةُ سلطةً لا تُجارى، والماءُ والأرضُ ثروةً لا تُقاس… ؛ رجالٌ أشداءُ كالنخيل، يحيطون بالشيخ ويحمون الحمى، وأخلاقٌ كأنها من زمن الأنبياء… ؛ فتشكَّلتْ هويتي الأولى: جسدٌ يعانق ظلَّ الأسلاف، وروحٌ تحلِّق فوق سهول الجنوب، حاملةً معها تناقضًا عميقًا بين ولاءٍ للماضي وحنينٍ إلى عالمٍ يتسعُ لأحلامٍ أكبرَ من جغرافيا الدم… ؛ نعم هكذا تكوَّنتْ هويتي: جسدٌ يُحاكي أشباحَ الأسلافِ، وروحٌ تُحلِّقُ كطائرِ الفينيقِ فوقَ خرائطَ متشظية و مؤانى بعيدة .
سمعتُ حكاياتِ العزِّ القديم: زمانٌ كانتْ فيه الأرضُ تُنجبُ ملوكًا – شيوخ بلا تيجان – وحكماء – فراضة وقضاة بلا شهادات – ؛ لا سياسيين نفعيين او مرتزقة وموظفين ، والماءُ يُنبتُ حضاراتٍ لا أنابيبَ نفط… ؛ رجالٌ أشداءُ كأشجارِ الغَرَبِ، يلفُّونَ الشيخَ كأسوارِ أوروكَ، وأخلاقٌ كسِفرٍ مفتوحٍ على سطورٍ من ذهب… ؛ لكنَّ ظلَّ الحداثةِ كانَ يتسللُ كديدانِ الأرضِ: يثقبُ الذاكرةَ، ويحوِّلُ الأساطيرَ إلى كومبارسٍ في مسرحياتِ العولمة.