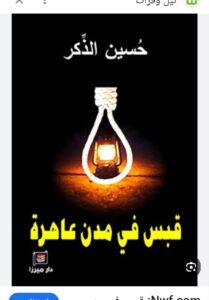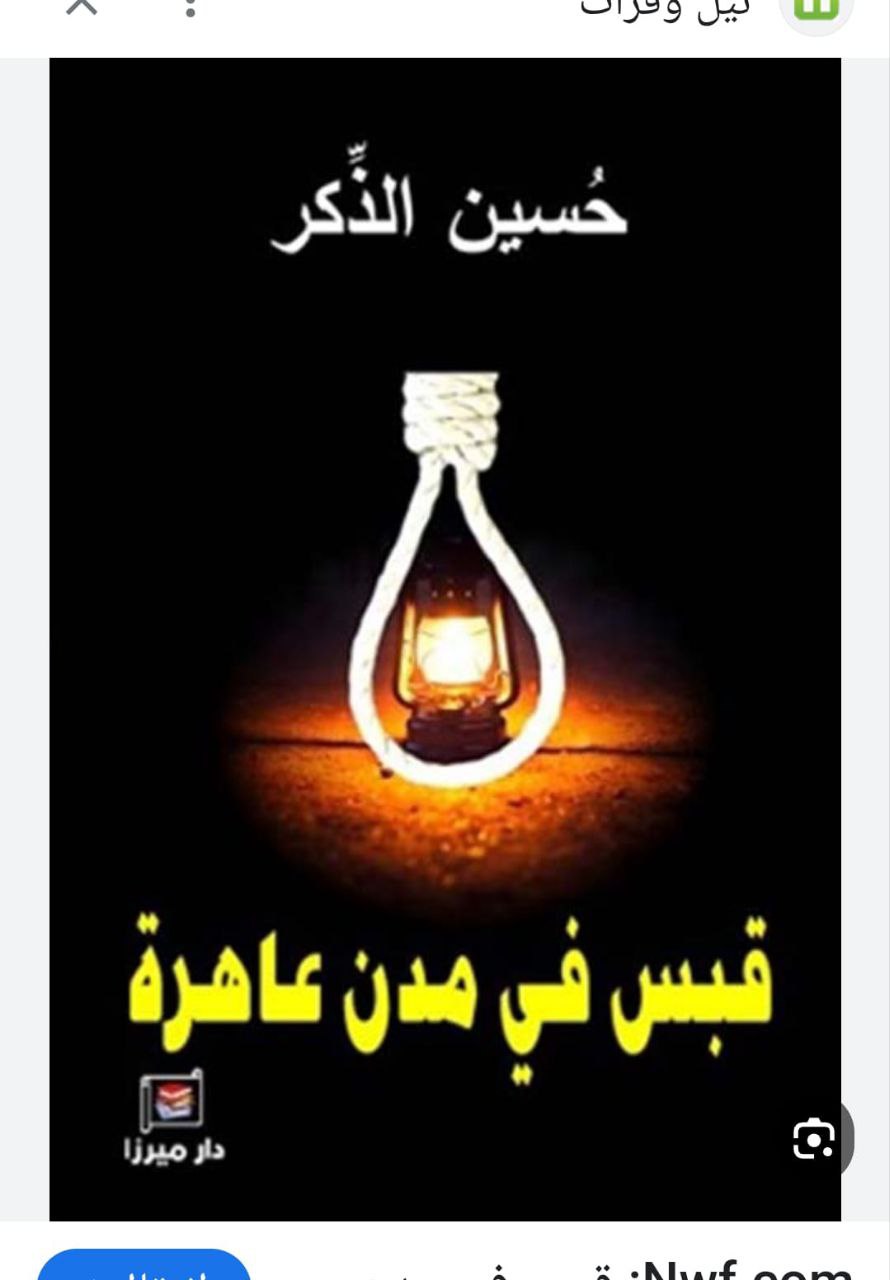رياض سعد
لازلتُ أتساءل: ألا زلنا شرفاء حقّاً إلى هذه اللحظة؟
سؤالٌ لا يُطرح للترف الفكري، بل يُلقى كحجرٍ في ماء النفس الراكد، فتتموّج حوله القيم، وتنكشف في أعماقه حقيقة الإنسان كما هي، لا كما يحب أن يراها أو يقدّمها للآخرين.
لقد انقضى زمنٌ كان فيه الإنسان يُنشَر بالمناشير، ويُقطَّع إربًا إربًا، وتُفصل رأسه عن جسده بالسيوف والسواطير، ويُساق إلى أقبية التعذيب، ويُغيَّب في غياهب السجون والمعتقلات والزنزانات، فلا يتزحزح عن معتقده، ولا يتبرأ من قضيته، ولا ينقلب على رفاقه، ولا يقف في صف أعدائه… ؛ كان الثبات يومها هو الأصل، والخيانة نشازًا مرفوضًا… ؛ أما اليوم، فقد ولى ذلك الزمان بلا رجعة، وغدت تلك المواقف أقرب إلى الأساطير، أو إلى الحديث عن ديناصورات انقرضت ولم يبقَ منها سوى الصور في كتب التاريخ.
أولئك الرجال الذين لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والذين لو عُرضت عليهم الدنيا بما فيها لما غرّهم بالله الغرور، ولم ينقلبوا على أعقابهم، ولم يتبرؤوا من مبادئهم، ولم يبدّلوا جلودهم مع تبدّل الفصول… ؛ أصبحوا في عداد المفقودين، وصار وجودهم أندر من الكبريت الأحمر... ؛ لقد أمسى وجودهم حلماً بعيداً في زمننا العجيب هذا … ؛ زمن انقلاب الموازين، حيث أصبح حلال الأمس حرام اليوم، وحرام اليوم حلال الأمس.
لم تعد الجريمة جريمة إذا حُمّلت أثواب التبرير، ولا الرذيلة رذيلة إذا زُيّنت بالألفاظ الملساء… ؛ فما من منقصة إلا وتجد من يلمّعها، ويباركها، ويجعلها من العاديات، بل من المناقب أحيانًا، وفق منطق نفعي أعور، كما يقول المثل الشعبي السائد: «الزلمة اللي يعبي رِكِي بالسِّلّة»، دون اكتراث بمصدر الرِّكِي ولا بمشروعية السلة... ؛ فالقبح صار جمالاً، والمنكر معروفاً… .
والأمر لا يخلو من سخرية مأساوية , اذ تتجلى الحقيقة العارية: لكلٍّ منا ثمن…. !
فمن الناس من يُشترى بالفتات، ومنهم من يبيع مبادئه بالحطام القليل، ومنهم من لا يرضى إلا بالكثير، فيرفع شعارًا فظًّا: إن عشقتَ فاعشق قمرًا، وإن سرقتَ فاسرق جملًا… , فلا يقتنع بالقليل ولا يغيّره إلا الكثير…؛ اذ تختلف الشعارات وتتنوع الذرائع، لكن المحصلة واحدة: لكل إنسان بابٌ خفيٌّ تُدقُّ عليه الشهوة، ومفتاحٌ يُفكّ به قفل النفس التي ظنّ صاحبها أنها عصيّة على الاقتحام... ؛ نعم , الخلاصة : أن لكل إنسان مفتاحاً سرياً، يكشف حقيقة شخصيته التي ظنّها حصناً منيعاً...!!
بل لقد تناهى إليّ أن فلاناً “المجاهد” الذي قارع النظام الصدامي الإجرامي، وصمد في مديرية الأمن العامة، وفي أقبية مديرية أمن صدام سيئة الصيت، ولم يعترف على أحد من رفاقه واصدقاءه رغم انهيار كثيرين تحت وطأة العذاب الجهنمي … ؛ هذا الرجل نفسه تغيّر حاله بعد سقوط الصنم عام 2003… ؛ نعم، صمد أمام السياط، وتحدّى الجلاد، لكنه لم يصمد أمام بريق الدنيا ولمعانها؛ ؛ فأصبح زير نساء وعاشقاً للدولار… ؛ “فمن لم يسقط أمام الدينار، قد يسقط أمام الدولار… ومن يتحدَّى الجلاد، قد لا يستطيع تحدي الجميلات”… , فأمسى أسيرا للسلطة والنفوذ والشهوة والمال… ؛ ولله في خلقه شؤون.
وما أكثر الذين رأيناهم بأمّ أعيننا: العابد الزاهد، والمجاهد المناضل، والعالم المثقف، وصاحب المبادئ و المقولات الرنانة , ورافع الشعارات البرّاقة، وابن العائلة المحترمة… , والشخصية الوقورة … ؛ كلّهم تمرغوا في وحل الفساد، و سقطوا جميعًا في وحل الفساد المالي والإداري والأخلاقي، دون أن تشفع لهم أسماؤهم ولا ماضيهم ولا خطبهم…, ولا ردعتهم مبادئهم المعلنة… .
ويا للمفارقة : أكثر الغارقين في الوحل هم مَن كانوا أشدّ الناس صرخةً ضد الفاسدين والفساد… ؛ بل لعل أكثر من تمرّغ في الوحل هم أولئك الذين كانوا يشجبون الفاسدين ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهارًا… .
ولم تشفع لهم ألقابهم السابقة، ولا ردعتهم مبادئهم المعلنة… ؛ ويا للمفارقة! أكثر الغارقين في الوحل هم مَن كانوا أشدّ الناس صرخةً ضد الفاسدين والفساد…!!
فهل لنا بعد هذا أن ندّعي شرفاً ثابتاً، أو فضلاً متأصلاً، أو أننا “بيننا وبين العصمة شبر”؟ كلا!
كل ما في الأمر أننا شرفاء إلى هذه اللحظة فقط… ؛ وربما الفضل في ذلك ليس لصلابتنا العقائدية ، بل لِعَدم فتح الأبواب المؤصدة بوجوهنا… , وما يحفظ شرفنا في كثير من الأحيان ليس سموّنا الأخلاقي، بل القدر ؛ فلو دعَتنا الدنيا إلى عناقها، لَذَهَبنا إليها مسرعين، ولَسَحَقنا شرفنا تحت أقدامنا، كما فعل مَن كانوا أشدَّ منا زهداً، وأوسع علماً، وأعظم شجاعة , وأعمق تدينًا، وأقوى بأسًا، وأنبل خلقًا …!!
نعم , من الجهل العميق بحقيقة الإنسان وخفايا النفس البشرية … ؛ ينبع ادعاؤنا بأننا شرفاء وفضلاء ونزهاء ، وأن بيننا وبين العصمة شبرًا، أو أننا قاب قوسين أو أدنى من الكمال والمثالية … ؛ والحقيقة أن الأمر أبسط وأكثر قسوة: نحن شرفاء إلى هذه اللحظة فقط.
لذلك، لا تُكثر من مدح نفسك، ولا تُفرط في تزكية غيرك قبل التجربة؛ فالتجربة وحدها هي الميزان… ؛ ولهذا قيل: خير الناس من لم تُجرّبه، لأن الامتحان يكشف المعدن، ويُظهر الخيط الأبيض من الأسود، ويضع الإنسان عاريًا أمام مرآة الحقيقة، بلا زينة ولا أقنعة... ؛ و قد يكشف أن ما نحمله من “شرف” قد لا يكون سوى هدنة مؤقّتة مع المغريات التي لم تأتِ بعد.