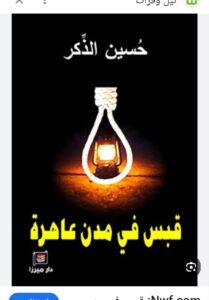فاضل حسن شريف
جاء في موقع الزيدي عن عقيدة الخلود في ميزان الثقلين (كتاب الله – أهل البيت): قال الله تعالى: “بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” (البقرة 81) الشّاهد: الخطابُ في هذه الآيَة جاءَ بخطابٍ عامٍ لجميع الأمم والنّاس، وسياقُه في تكذيب بني إسرائيل عندما قالوا: “وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ” (البقرة 80)، فأجابَ الله جلّ شأنه عليهم بجوابٍ عامٍّ شاملٍ ينطبقُ على بني إسرائيل وعلى جميع الأمم، فقال: “بَلَى” أي ليس الأمر كما ذهبتُم معشر اليهود، فـ “مَن كَسَبَ سَيِّئَةً” أي مَن ارتكب كبائر المعاصي، كأن يُشرِكَ بي، أو يَقتُل الأنفس المُؤمنَة، أو يُولّي يوم الزّحف، أو يزني..إلخ من الكبائر العظام، “وأَحَاطَتْ بِهِ” ولَزمِتهُ ولم تنفكّ عنه، بمعنى أصرّ عليها، “خَطِيئَتُهُ” والخطيئَة هي أقلّ من السّيئة مرتبة في الآيَة، فالخطيئة تعني الصغيرَة، أمّا السيئة فهي تعني الكبيرَة، وهِي من قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: “وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ”، فنسبَ الخطيئة إلى نفسه ومعلومٌ أنّ خطايا الأنبياء ليسَت إلاّ صغائر، فيكون معنى الآيَة: ومَن ارتكبَ كبيرةً وأحاطَت به هذه الكبيرَة أي أصرّ عليها وماتَ عليها، أو مَن ارتكبَ صغيرةً وأصرّ عليها وماتَ عليها، “فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”، إن قيل: لِم لا يكونُ المقصودُ بالسيئة والخطيئة هي الشّرك بالله تعالى، فيكون الخلود مُخصّص لهم دون أصحاب الكبائر من أهل القِبلَة ؟ قُلنا: يمتنعُ هذا من سياق الآيَة، إذ الآيَة تُخبرُ عن مُستحقّي عذاب الله تعالى يوم القيامة، وكذلكَ تُخبرُ عن مُستحقي ثواب الله تعالى يوم القيامَة، وسياق الآيَة هو قول الله تعالى: “بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”، فجميعُ أصناف النّاس داخلون تحتَ وعدَ الله ووعيدهُ في هاتين الآيَتين، وعدهُ بالجنّة للذين آمنوا، ووعيدُه بالخلود في النّار لمَن أساؤا، والنّاس يوم القيامة ثلاثة أصناف، إمّا مؤمنون، وإمّا فسّاق أصحاب كبائر وصغائر، وإمّا كفّار مُشركين، والله قَد أخبرَ عن حال المؤمنين في قوله: “وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”، فَبَقِيَ صنفان، الفُسّاق والكُفّار، وقد شَمِلَهما الله تعالى بقولِه: “بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”، فأصحابُ السيئات هُم الكُفّار وأصحاب الكبائر من أهل القِبلَة، وأصحاب الصغائر (الخطيئات) من أهل القِبلَة هم مَن أصرّوا على خطيئاتهم فأحاطَت بهِم ولزمَتهُم إلى يوم القيامَة، على أنّ هناك طائفةٌ مِن علماء أهل القِبلَة قالوا بأنّ هذه الآيَة شاملَة لأهل الكبائر، منهم: الحسن بن أبي الحسن البصري والسّدي، قالا عن (السّيئة): (هِيَ الكَبيرة مِن الكبَائر)، وقال الأعمش والسّدي وأبي رزين في قول الله تعالى: “وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ”: (الذي يَموتُ على خَطاياه مِن قَبل أن يَتوب)، وقال أبو العالية ومجاهد والحسن بن أبي الحسن البصري والرّبيع بن أنس أنّ الخطيئة هي: (المُوجِبَة الكبيرَة)، والكبائر المُوجبَات منها، الشرك بالله، وقتل النّفس المؤمنة والرّبا والسّحر وقذف المُحصنات وغيرها، فَأصحابُ هذه الكبائر لاشكّ خالدون مُخلّدون في النّار كما صرّحت الآيَة، نعم إن قيل: إنّما مُراد هؤلاء العُلماء بالكبائر، أي الشّرك بالله تعالى وفَقط؟ قُلنا: الكبيرةُ لفَظةٌ يَدخلُ تحتَها جميعُ المُوجِبَات، ولو سلّمنا لكم هذا، فإنّ بقيّة آيات القرآن تشهدُ لقولِنا فَي أنّ (السّيئة) في الآية هي الكَبيرة، وأنّ الكبيرة تشمل الشّرك بالله وبقيّة الموجبات التي قد يرتكبها فَسقة أهل القِبلَة، ومعلومُ أنّ خير مُفَسِّرٍ للقرآن هُو القرآن، فالله تعالى يقول في حق قاتل النفس المؤمنة: “وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا” (النساء 93)، وقَتل النفس من الكبائر المُوجِبات، والآية صرّحت بخلودِ صاحِبها في النّار، فهي تُوافق تأويلَنا للآيَة بأنّ السّيئة (هي لفظةُ يدخلُ تحتها جميع الكبائر المُوجِبَة)، بدليل تخليدِ الله لأصحابِها، فقد خلّد القرآن أصحاب الرّبا، وخلّد المُتعدّين لحدوده في أكل أموال النّاس بالباطل وذلك في آية المواريث، وخلّد قاتلي الأنفس المؤمنة بغير وجه حقّ، والُمنافقين والمُنافقات، والسنّة كذلك خلّدت أصنافاً كثيرة من مُرتكبي الكبائر، كشاربي الخَمر، فهذه الكبائر كلّها تشهدُ لقولِنا القريب.
عن موقع عرفان: بعد أن أخرجت عقائد الزيدية من كتاب البحر الزخار، وقفت على رسالة مختصرة باسم العقد الثمين في معرفة ربّ العالمين لموَلّفه العلامة الاَمير الحسين بن بدر الدين محمد المطبوع باليمن، نشرته دار التراث اليمني صنعاء، ومكتبة التراث الاِسلامي بصعده وهي من أوائل الكتب الدراسية في حقل أُصول الدين والموَلّف من أجلّ علماء الزيدية، وأكثرهم تأليفاً وتعد كتبه من أهم الاَُصول التي يعتمد عليها علماء الزيدية و يدرسونها كمناهج. فصل (في أنّ اللّه تعالى واحد) فإن قيل: أربّك واحدٌ لا ثاني له، أم لا؟ فقل: بلى هو واحد لا ثاني له في الجلال، متفرد هو بصفات الكمال؛ لاَنّه لو كان معه إله ثان لوجب أن يشاركه في صفات الكمال على الحد الذي اختصّ بها، ولو كان كذلك لكان على ما قدر قادراً، ولو كان كذلك لجاز عليهما التشاجر والتنازع، ولصح بينهما التعارض والتمانع، ولو قدّرنا هذا الجائز لاَدى إلى اجتماع الضدين من الاَفعال، أو عجز القديم عن المراد، وكل ذلك محال، تعالى عنه ذو الجلال؛ لقوله: “لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاّ اللّه لَفَسَدَتا” (الاَنبياء 22)، ولقوله عزّ قائلاً: “أَم جَعَلُوا للّه شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَّارُ” (الرعد 16) فتبين أنّ الخلق يشهد بإله واحد، وأنّه ليس هناك خلق ثانٍ يشهد بإله ثان، وهذا واضح؛ فإنّ هذا العالم دليلٌ على إله واحد وهو الذي أرسل الرسل، وأوضح السبُل. ويَدُل على ذلك قوله عزّ وجلّ: “فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلهَ إلاّ اللّه” (محمد 19)، وقوله: “شَهِدَ اللّه أَنّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَالمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوْا العِلْمِ قَائِماً بِالقِسْطِ” (آل عمران 18)، وقوله: “وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌج” (البقرة 163)، وقوله: “قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ” (الصمد 1). فصل (في أنّ اللّه لا يريد شيئاً من القبائح). فإن قيل: أربك يريد شيئاً من القبائح؟ فقل: إنّه تعالى لا يريد شيئاً منها، فلا يريد الظلم، ولا يرضى الكفر، ولا يحب الفساد، لاَنّ ذلك كله يرجع إلى إرادة القبيح، وإرادة القبيح هي قبيحة، وهو تعالى لا يفعل القبيح. ألا ترى أنّه لو أخبرنا مُخبرٌ ظاهرهُ العدالة، بأنّه يريد الزنا والظلم لسقطت عدالته، ونقصت منزلته، عند جميع العقلاء، ولا علّة لذلك إلاّ أنّه أتى قبيحاً، وهو إرادة القبيح. وقد قال تعالى: “وَاللّه لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ” (البقرة 205). وقال: “وَلاَيَرْضَى لِعِبادِهِ الكُفْرَ” (الزمر 71). وقال: “ومَا اللّهُ يُريدُ ظُلماً للعِبادْ” (غافر 31).
جاء في موقع الزيدي عن عقيدة الخلود في ميزان الثقلين (كتاب الله – أهل البيت): قال الله تعالى: “زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ” (البقرة 212) الشّاهد: الكلامُ هُنا حول المشيئة الإلهية، أهل البيت سادات الزيدية يقولون أنّ مشيئة الله تعالى في قول الله جلّ شأنه: “وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ” لا تَحملُ إلاّ المُتّقين الذين يرضَاهُم الله تعالى دون الظّالمين غير مرضيي الطريقة عند الله تعالى، والمُخالفُ على مُقتضى فهمه للمشيئة في قول الله تعالى: “إنّ الله لا يَغفرُ أن يُشرك به ويَغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء”، سيقولُ: أنّ الله قَد يَشاء أن يَرزُقَ المتّقين أو الظّالمين، مَن يرضَى عنهُم، ومَن لا يَرضى عنهُم، كما قالوا سابقاً أنّ الله سيشاءُ أن يَغفرَ لأصحاب الكبائر الظالمين من أهل القبلَة، ويَرحمهم، ويُخرجهم من النّار، عليه فلننظر أخي الباحث لكتاب الله تعالى، مشيئة الله تعالى فيمَن تحقّقت؟ هل فيمَن هُو مُتّقٍ فقط؟ أم في المُتّقين والظالمين؟ قال تعالى: “زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ”، فأخبرَ الله تعالى أنّه رزق الذينَ اتّقَوا ورَفَعَهُم فوق الذين كفَروا، ومعلومٌ أنّ صفة التّقوى ليست تنطبقُ على كل المُسلمين، إذ كلّ مُتَّقٍ مُسلم، وليس كلّ مُسلمٍ مُتّقي، فمشيئة الله تعال هي أن يَرزُقَ المتّقين لا الظّالمين، فصحّ قول ثقل الله الأصغر، وشَهِد له الثّقل الأكبر، فكانَ هُو الحجّة.