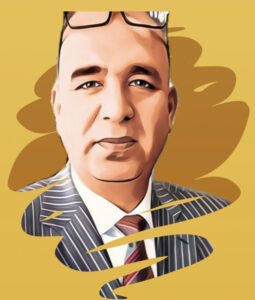فاضل حسن شريف
عن تفسير الميسر: قوله تعالى “بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ” ﴿الأنعام 28﴾ لَعَادُوا: لَ لام التوكيد، عَادُ فعل، وا ضمير. ليس الأمر كذلك، بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعه خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب. وإنهم لكاذبون في قولهم: لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا، وكنا من المؤمنين. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ” وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ” (الأنعام 28) قال تعالى: “بل” للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني “بدا” ظهر “لهم ما كانوا يخفون من قبل” يكتمون بقولهم (والله ربنا ما كنا مشركين) شهادة جوارحهم فتمنوا ذلك، “ولو ردوا” إلى الدنيا فرضا “لعادوا لما نُهوا عنه” من الشرك “وإنهم لكاذبون” في وعدهم بالإيمان.
جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ” ﴿الأنعام 28﴾ “بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ” اختلف فيه على أقوال أحدها: إن معناه بل بدا لبعضهم من بعض ما كان علماؤهم يخفونه عن جهالهم وضعفائهم، مما في كتبهم، فبدا للضعفاء عنادهم. وثانيها: إن المراد بل بدا من أعمالهم ما كانوا يخفونه، فأظهره الله، وشهدت به جوارحهم، عن أبي روق. وثالثها: إن المعنى ظهر للذين اتبعوا الغواة، ما كان الغواة يخفونه عنهم، من أمر البعث والنشور، لأن المتصل بهذا قوله: “وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا” الآية، عن الزجاج، وهو قول الحسن. ورابعها: إن المراد بل بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفر، عن المبرد. وكل هذه الأقوال بمعنى ظهرت فضيحتهم في الآخرة، وتهتكت أستارهم. “وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ” أي: لو ردوا إلى الدنيا، وإلى حال التكليف، كما طلبوه، لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب “وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ” ويسأل على هذا فيقال: إن التمني كيف يصح فيه الكذب، وإنما يقع الكذب في الخبر؟ والجواب: إن من الناس، من حمل الكلام كله على وجه التمني، وصرف الكذب إلى غير الأمر الذي تمنوه، وقال: إن معناه هم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم في الدنيا من الإصابة، واعتقاد الحق، أو يكون المعنى: إنهم كاذبون إن خبروا عن أنفسهم، بأنهم متى ردوا آمنوا، وإن كان ما حكي عنهم من التمني، ليس بخبر، وقد يجوز أن يحمل على غير الكذب الحقيقي بأن يكون المراد أنهم تمنوا ما لا سبيل إليه فكذب أملهم وتمنيهم، وهذا مشهور في كلام العرب يقولون: كذبك أملك لمن تمنى ما لم يدرك، وقال الشاعر: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها * بني شاب قرناها تصر وتحلب. وقال آخر: كذبتم وبيت الله لا تأخذونها * مراغمة ما دام للسيف قائم. والمراد ما ذكرناه من الخيبة في الأمل والتمني. فإن قيل: كيف يجوز أن يتمنوا الرد إلى الدنيا، وقد علموا أنهم لا يردون ؟ فالجواب عنه من وجوه أحدها: إنا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أ حكام الآخرة، وإنما نقول: إنهم يعرفون الله معرفة لا يتخالجهم فيها الشك، لما يشاهدونه من الآيات الملجئة لهم إلى المعارف. وأما التوجع والتمني للخلاص، والدعاء للفرج، فيجوز أن يقع منهم ذلك، عن البلخي. وثانيها: إن التمني قد يجوز فيما يعلم أنه لا يكون، ولهذا قد يقع التمني على أن لا يكون ما قد كان، وأن لا يكون فعل ما قد فعله، وتقضى وقته. وثالثها: إنه لا مانع من أن يقع منهم التمني للرد، ولأن يكونوا من المؤمنين، عن الزجاج. وفي الناس من جعل بعض الكلام تمنيا، وبعضه إخبارا، وعلق تكذيبهم بالخبر دون “لَيْتَنَا” وهذا إنما ينساق في قراءة من رفع “وَلَا نُكَذِّبَ” “وَنَكُونَ” على معنى: فإنا لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فيكونون قد أخبروا بما علم الله أنهم فيه كاذبون، وإن لم يعلموا من أنفسهم مثل ذلك، فلهذا كذبهم. وذكر أن أبا عمرو بن العلاء استدل على قراءته بالرفع في الجميع، بأن قوله: “وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ” فيه دلالة على أنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم، ولن يتمنوه، لأن التمني لا يقع فيه الكذب.
جاء عن موقع براثا دراسات العيد في القران وتحقيق جهد المؤمن والوحدة للشيخ محمد الربيعي: العيد في القران: “قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا و آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين” ان المتتبع لآيات القرآن الكريم سيلاحظ ان كلمة العيد ذكرت بالقران مرة واحده، و في آية واحدة في سورة المائدة، و التي عرضناة بصدر الكلام اعلاه. محل الشاهد: عند تتبع الايات و الحوارات القرانية بصدد حادثة الاية اعلاة، يظهر جليا ان معنى العيد، هو طلب التكرار و الرجوع لاستذكار تلك النعمة التي كانت سببا للانتصار، فالنص يتحدث عن اية من السماء طلبها الحواريون من النبي عيسى ليأكلوا منها و ليذهب عنهم الريب و تطمئن قلوبهم بالإيمان و بصدق هذا النبي و بذلك طلب النبي عيسى عليه السلام، ذلك و قال بنهاية الطلب تكون “لنا عيدا”، و المقصود هنا أن تكون المائدة ذكرى يرجعون اليها ليذكروا ما عاهدوا الله عليه و بالذي طلبوه هم و اخذ ميثاقهم بالايمان و التصديق، و الفرحة هنا هي الكرامة الالهية الممنوحة لهم من قبل الله عزوجل. اذن العيد بالمقصود القرآني هو: العودة و الرجوع الى المنحة الى النصر الإلهي المتحقق بفضل الله عزوجل. و هذا المعنى اكده الامام علي عليه السلام عندما قال (إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه و قيامه)، بمعنى انك تكون في عيد لانك استطعت ان تعيش الانتصار و تنتصر على نفسك الامارة بالسوء و على الشيطان و هجر المعاصي، بما منحه الله لك و وفره لذلك الانتصار وهو فريضة الصوم. و من هنا كانت الفرحة للمؤمن بما يمنحه الله من فرصة لطاعته و تكون هي أمنيته وأمنية الاجيال ان يعيشوا استحقاق الرجوع في كل عام تلك النعمة و هي الصوم لينالوا فرحة الانتصار بفضل الدعم الإلهي لهم. و بذلك يرتفع معنى العيد (ليشمل كل منحة كل انتصار من الله لك في كل تكليف تنجزه)، فأكيدا فما بعده ذلك الاداء المتكامل و المستوفي لكافة شروطه وقواعده يكون عيدا، وهذا المعنى ايضا بينه الامام علي عليه السلام عندما قال: (كل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد)، أي كل يوم تخوض فيه التكاليف الشرعي الواجبة عليك و التي فيها نفعك و نفع مجتمع وتؤديها فبعدها تكون أنت في عيد وفرح ذلك الانتصار المبين الذي تكون فيه قريب من جنة النعيم. فمعنى العيد ليس ابتهاجا لعصيان الله و نسيان نعمة إنما هو التذكرة أن بما فيه انت من انتصار من نعم هو لنعمة سبقت ودعمتك فانتصرت والله ولي التوفيق.
قال جل من قائل: “بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ” (الانعام 28) “وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ” (الانعام 28)). لقد انكر الامام أبو جعفر عليه السلام على هؤلاء القوم انصرافهم عن وعظه، وإرشاداته الهادفة إلى استقامتهم وحسن سلوكهم، وظفرهم بخير الدنيا والآخرة، وقد وجه إليهم هذه الموعظة البالغة فدعاهم الى الله، والتمسك بطاعته، فانه بيده الخير والحرمان. لقد وعظهم بهذه المواعظ التي تخشع لها النفوس، وتتوجل منها القلوب ليرجعهم إلى حظيرة الإيمان وواقع الإسلام.
جاء في موقع موضوع عن طريقة عمل كليجة التمر للكاتبة فداء ابو حسن: تعد كليجة التمر أحد الحلويات التي تشتهر بإعدادها منطقة الخليج العربي والعراق، وهي عبارةٌ عن عجينةٍ محشوةٍ بالتمر أو بالحشوات المختلفة الأخرى، ويتم تحضيرها في المناسبات وأعياد الميلاد وفي فصل الشتاء البارد تحديداً، وفي هذا المقال سنتحدث عن إعداد الكليجة بالتمر بالإضافة إلى الكليجة بالجوز. المكونات العجينة أربع كؤوسٍ من الطحين الأبيض. كأسٌ من السمنة. ملعقةٌ صغيرةٌ من الخميرة الفورية. نصف ملعقةٍ صعيرةٍ من الهيل المطحون. حليبٌ سائلٌ حسب الرغبة والحاجة. رشة ملح طعام. الحشوة كأسٌ من التمر منزوع البذور. ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة. ملعقةٌ كبيرةٌ من الهيل المطحون. طريقة التحضير تحضير العجينة من خلال وضع الطحين في وعاءٍ وإضافة الملح والهيل إليه وإضافة السمن وعجن المواد بشكلٍ جيد. تنظيف السمسم وغسله جيداً بالماء وقليه في مقلاةٍ وتركه حتى يبرد. تذويب الخميرة بكميةٍ قليلةٍ من الماء وإضافتها إلى المزيج والبدء بالعجن مع إضافة الحليب بشكلٍ تدريحي حتى تتكون عجينةٌ متماسكةٌ وطرية. ترك العجينة لتتخمر ويتضاعف حجمها لما يقارب الثلث ساعة. تحضير الحشوة من خلال قلي التمر بالزيت على نارٍ متوسطة الحرارة وتقليبها حتى تصبح مثل العجينة ورفعها عن النار. إضافة الهيل إلى التمر وعجن المواد معاً وترك الحشوة جانباً حتى تبرد. تحضير الكليجة من خلال تقسيم العجينة إلى كراتٍ متوسطة الحجم لصنع أصابعَ عريضةً منها. حفر كل كرةٍ من الكرات بالإصبع من الوسط وحشوها بالتمر حسب الرغبة والذوق. تشكيل كريات الكليجة باليدين على شكل أصابعَ عريضةٍ والنقش على وجهها باستعمال شوكة. صف أصابع الكليجة المحشوة بالتمر في صينية فرنٍ مدهونةٍ بالقليل من الزيت أو الزبدة وخبزها في فرنٍ على درجة حرارةٍ متوسطةٍ حتى تتحمر ويتغير لونها. إخراجها من الفرن ووضعها في صحونٍ مناسبةٍ للتقديم ساخنةً أو باردةً حسب الذوق والرغبة.