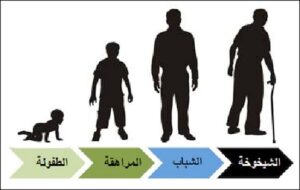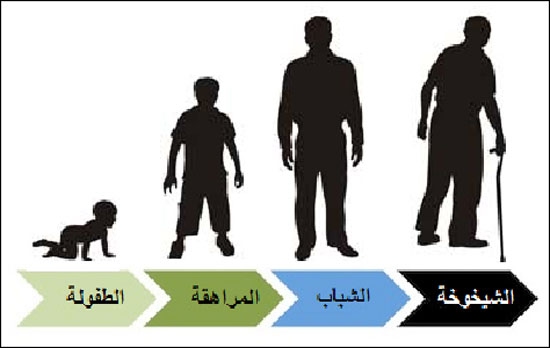رياض سعد
في مدينة الثورة حيث كانت البيوت تُبنى على شاكلةٍ واحدة، بفناءٍ خلفيٍّ تظلله عادةً نخلة وشجرة زيتون ، لم تكن البيوت وقتذاك – عقد الستينيات من القرن المنصرم – مجرد جدرانٍ تؤوي الأجساد، بل كائناتٍ صامتة تتنفس مع ساكنيها… ؛ كأنها خرجت من ذاكرةٍ جماعية: دارٌ يتقدّمها بناءٌ صغير، غرفتان ومطبخ وحمام ودرجٌ ضيق، وخلفها باحة مكشوفة تُترك عمداً للسماء… ؛ في تلك الباحة الخلفية تُزرع نخلةٌ كي لا ينسى البيت جذوره، وشجرة زيتونٍ لتتعلّم الجدران معنى الصبر، وأحياناً تُربّى دجاجة أو أرنب، كأن الحياة لا تكتمل إلا بما هو هشّ وقابل للفقد.
في ليالي الصيف، كانت الباحة تتحوّل إلى غرفة نومٍ كبرى. الأرض فراشٌ، والنجوم سقفٌ بلا تشققات، والهواء يمرّ بين الأجساد كوصيةٍ قديمة… ؛ هناك، في ليلةٍ لا تختلف ظاهرياً عن غيرها، كان قاسم في الخامسة من عمره، محاطاً بإخوته الخمسة، وبقرب أمه وأبيه، حين انفتحت في داخله نافذة لم تُغلق إلى اليوم.
رأى نفسه ينهض من فراشه، لا بجسده الصغير، بل بوعيٍ أثقل من عمره… ؛ اتجه نحو الدار، وحين مدّ يده ليدخل، اكتشف أن البيت لم يعد البيت… ؛ الطابوق الحديث انقلب طابوقاً قديماً أحمرَ متآكلاً، يتساقط منه الغبار كأنه يشيخ أمام عينيه… ؛ خيوط العنكبوت نسجت تاريخاً طويلاً على الزوايا، والهواء كان رطباً برائحة الهجران، كأن أحداً لم يسكن المكان منذ قرنٍ أو أكثر.
رفع قاسم رأسه نحو السماء، فوجدها ملبّدة بغيومٍ سوداء، لا تمطر، بل تتوعّد… ؛ وحين دخل الدار، لم يجد ظلاماً خالصاً ولا نوراً، بل لوناً رمادياً ضبابياً، يشبه الذاكرة حين تختلط فيها الحقيقة بالكوابيس.
هناك، في قلب البيت، ظهرت سبعة ثعابين سوداء ضخمة، عرابيدَ ممتلئة … ؛ رأى العرابيد السبع. لم تكن ثعابين عادية، بل كانت كائناتٍ من مادة الظل نفسها، يبلغ طول الواحدة منها أمتاراً وتتحرك بانسيابيةٍ سائلةٍ مخيفة، تملأ الزوايا وتتسلل على الدرج. كان هسهستها أشبه بصوت الرمال المتساقطة في ساعةٍ زجاجية عملاقة… ؛ كانت تتحرّك في كل الاتجاهات، تملأ الزوايا، تزحف على الدرج المؤدي إلى السطح، كأنها حراسُ قدرٍ لا يُرى. حاولت الاقتراب منه، لكن حاجزاً خفياً كان يصدّها، جداراً لا يُلمس ولا يُكسر… ؛ قوةٌ تمنع اقترابهن… ؛ ولكن إحداهن تمددت كظلٍّ طويل، واقتربت حتى لم يعد بينها وبين وجهه غير شبر… ؛ ثم نفخت في وجهه نفخةً باردة مرعبة، فارتجّ العالم في عينيه… ؛ لم تكن النفخة هواءً، بل كانت زفيراً من صقيع الوجود… ؛ حملت برودة الموت والنسيان، وصرخةً مكبوتةً من أعماق لا يعرفها… ؛ ارتعش قاسم كله وفزع، ثم اندفع جرياً من فضاء الكابوس إلى حضن أمه الدافئ.
استيقظ قاسم صارخاً، يركض نحو حضن أمه، كأن الحضن وحده قادر على إعادة ترتيب الكون… ؛ لكن الرؤية لم تستيقظ معه؛ بقيت هناك، جاثمة في مخياله، تكبر كلما كبر، وتغيّر شكلها دون أن تفقد معناها.
منذ تلك الليلة، صار الحلم خريطة حياته السرية… ؛ كل سبع سنوات، كما لو أن عقارب الساعة الذائبة في لوحة “ثبات الذاكرة” لدالي قد أتمت دورة، كانت مصيبةٌ كبرى تحل به: موت عزيز، خيانة صديق، خسارة لا تعوض… , أو عداوةٌ تنبت فجأة كعشبٍ سام… ؛ وكلما حلّ في مكان، أحس بتلك العيون السوداء من وراء الأكمة تترصد، حسداً أو عداءً… ؛ نعم : أينما حلّ وارتحل ، وجد ظلال الحسد تراقبه، ووجوه الأعداء تتبدّل دون أن يختفي أثرها… ؛ و السواد لم يفارقه؛ كان يعود في هيئة جنازة، أو خبرٍ ثقيل، أو صمتٍ طويل… ؛ حتى صار السواد لوناً أساسياً في لوحة حياته، وصارت الرؤيا لغزاً ملحاً يبحث له عن تفسير… ؛ هل كانت الثعابين سبع مراحل من عمره؟ أم سبع خطايا لم يرتكبها لكنه دُفع ثمنها؟ أم أن البيت نفسه، بباحته المفتوحة ونخلته الصامتة، كان يحذّره من أن الزمن لا يسكن البيوت وحده، بل يسكن البشر أيضاً , ويحذره من أن الجدران التي تحمينا قادرة أيضاً على أن تتحوّل إلى مرايا لمصائرنا؟
إلى اليوم، كلما دخل قاسم بيتاً جديداً، تفحّص جدرانه، أنصت إلى صمته، ونظر طويلاً إلى باحته إن وُجدت… ؛ يعرف في قرارة نفسه أن بعض الرؤى لا تُفسَّر، لأنها لم تأتِ لتُفهَم، بل لترافقنا، شاهدةً على أن حياتنا، مهما بدت بسيطة، قد تخفي في داخلها بيتاً يتقدّم في العمر… قبل ساكنيه.