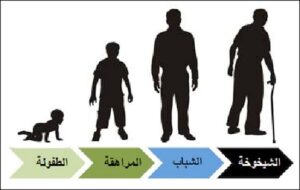د. فاضل حسن شريف
جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ” (التوبة 34) قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله” الظاهر أن الآية إشارة إلى بعض التوضيح لقوله في أول الآيات: “ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق” كما أن الآية السابقة كالتوضيح لقوله فيها: “الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر” ﴿التوبة 34﴾. أما إيضاح قوله تعالى: “ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله” بقوله: “إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل” فهو إيضاح بأوضح المصاديق وأهمها تأثيرا في إفساد المجتمع الإنساني الصالح، وإبطال غرض الدين. فالقرآن الكريم يعد لأهل الكتاب وخاصة لليهود جرائم وآثاما كثيرة مفصلة في سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها لكن الجرائم والتعديات المالية شأنها غير شأن غيرها، وخاصة في هذا المقام الذي تعلق الغرض بإفساد أهل الكتاب المجتمع الإنساني الصالح لو كانوا مبسوطي اليد واستقلالهم الحيوي قائما على ساق، ولا مفسد للمجتمع مثل التعدي المالي. فإن أهم ما يقوم به المجتمع الإنساني على أساسه هو الجهة المالية التي جعل الله لهم قياما فجل المآثم والمساوي والجنايات والتعديات والمظالم تنتهي بالتحليل إما إلى فقر مفرط يدعو إلى اختلاس أموال الناس بالسرقة وقطع الطرق وقتل النفوس والبخس في الكيل والوزن والغصب وسائر التعديات المالية، وإما إلى غنى مفرط يدعو إلى الإتراف والإسراف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن، والاسترسال في الشهوات وهتك الحرمات، وبسط التسلط على أموال الناس وأعراضهم ونفوسهم. وتنتهي جميع المفاسد الناشئة من الطريقين كليهما بالتحليل إلى ما يعرض من الاختلال على النظام الحاكم في حيازة الأموال واقتناء الثروة، والأحكام المشرعة لتعديل الجهات المملكة المميزة لأكل المال بالحق من أكله بالباطل، فإذا اختل ذلك وأذعنت النفوس بإمكان القبض على ما تحتها من المال، وتتوق إليه من الثروة بأي طريق أمكن لقن ذلك إياها أن يظفر بالمال ويقبض على الثروة بأي طريق ممكن حق أو باطل، وأن يسعى إلى كل مشتهى من مشتهيات النفس مشروع أو غير مشروع أدى إلى ما أدى، وعند ذلك يقوم البلوى بفشو الفساد وشيوع الانحطاط الأخلاقي في المجتمع، وانقلاب المحيط الإنساني إلى محيط حيواني ردي لا هم فيه إلا البطن وما دونه ولا يملك فيه إرادة أحد بسياسة أو تربية ولا تفقه فيه لحكمة ولا إصغاء إلى موعظة. ولعل هذا هو السبب الموجب لاختصاص أكل المال بالباطل بالذكر، وخاصة من الأحبار والرهبان الذين إليهم تربية الأمة وإصلاح المجتمع. وقد عد بعضهم من أكلهم أموال الناس بالباطل ما يقدمه الناس إليهم من المال حبا لهم لتظاهرهم بالزهد والتنسك، وأكل الربا والسحت، وضبطهم أموال مخالفيهم وأخذهم الرشا على الحكم، وإعطاء أوراق المغفرة وبيعها، ونحو ذلك.
والظاهر أن المراد بها أمثال أخذ الرشوة على الحكم كما تقدم من قصتهم في تفسير قوله تعالى: “يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر” (المائدة 41)، في الجزء الخامس من الكتاب. ولو لم يكن من ذلك إلا ما كانت تأتي به الكنيسة من بيع أوراق المغفرة لكفى به مقتا ولوما. وأما ما ذكره من تقديم الأموال إليهم لتزهدهم، وكذا تخصيصهم بأوقاف ووصايا ومبرات عامة فليس بمعدود من أكل المال بالباطل، وكذا ما ذكره من أكل الربا والسحت فقد نسبه تعالى في كلامه إلى عامة قومهم كقوله تعالى: “وأخذهم الربا وقد نهوا عنه” (النساء 161)، وقوله: “سماعون للكذب أكالون للسحت” (المائدة 42)، وإنما كلامه تعالى في الآية التي نحن فيها فيما يخص أحبارهم ورهبانهم من أكل المال بالباطل لا ما يعمهم وعامتهم. إلا أن الحق أن زعماء الأمة الدينية ومربيهم في سلوك طريق العبودية المعتنين بإصلاح قلوبهم وأعمالهم إذا انحرفوا عن طريق الحق إلى سبيل الباطل كان جميع ما أكلوه لهذا الشأن واستدروه من منافعه سحتا محرما لا يبيحه لهم شرع ولا عقل. وأما إيضاح قوله تعالى: “ولا يدينون دين الحق” بقوله: “ويصدون عن سبيل الله” فهو أيضا مبني على ما قدمناه من النكتة في توصيفهم بالأوصاف الثلاثة التي ثالثها قوله: “ولا يدينون دين الحق” وهو بيان ما يفسد من صفاتهم وأعمالهم المجتمع الإنساني ويسد طريق الحكومة الدينية العادلة دون البلوغ إلى غرضها من إصلاح الناس وتكوين مجتمع حي فعال بما يليق بالإنسان الفطري المتوجه إلى سعادته الفطرية. ولذا خص بالذكر من مفاسد عدم تدينهم بدين الحق ما هو العمدة في إفساد المجتمع الصالح، وهو صدهم عن سبيل الله ومنعهم الناس عن أن يسلكوه بما قدروا عليه من طرقه الظاهرة والخفية، ولا يزالون مصرين على هذه السليقة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اليوم.
قوله تعالى: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم” قال الراغب: الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه، وأصله من كنزت التمر في الوعاء، وزمن الكناز وقت ما يكنز فيه التمر، وناقة كناز مكتنزة اللحم، وقوله: “والذين يكنزون الذهب والفضة” أي يدخرونها. ففي مفهوم الكنز حفظ المال المكنوز وادخاره ومنعه من أن يجري بين الناس في وجوه المعاملات فينمو نماء حسنا، ويعم الانتفاع به في المجتمع فينتفع به هذا بالأخذ وذاك بالرد، وذلك بالعمل عليه وقد كان دأبهم قبل ظهور البنوك والمخازن العامة أن يدفنوا الكنوز في الأرض سترا عليها من أن تقصد بسوء. والآية وإن اتصلت في النظم اللفظي بما قبلها من الآيات الذامة لأهل الكتاب والموبخة لأحبارهم ورهبانهم في أكلهم أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله إلا أنه لا دليل من جهة اللفظ على نزولها فيهم واختصاصها بهم البتة. فلا سبيل إلى القول بأن الآية إنما نزلت في أهل الكتاب وحرمت الكنز عليهم، وأما المسلمون فهم وما يقتنون من ذهب وفضة يصنعون بأموالهم ما يشاءون من غير بأس عليهم. والآية توعد الكانزين إيعادا شديدا، ويهددهم بعذاب شديد غير أنها تفسر الكنز المدلول عليه بقوله: “الذين يكنزون الذهب والفضة” بقوله: “ولا ينفقونها في سبيل الله” ﴿التوبة 34﴾ فتدل بذلك على أن الذي يبغضه الله من الكنز ما يلازم الكف عن إنفاقه في سبيل الله إذا كان هناك سبيل. وسبيل الله على ما يستفاد من كلامه تعالى هو ما توقف عليه قيام دين الله على ساقه وأن يسلم من انهدام بنيانه كالجهاد وجميع مصالح الدين الواجب حفظها، وشئون مجتمع المسلمين التي ينفسخ عقد المجتمع لو انفسخت، والحقوق المالية الواجبة التي أقام الدين بها صلب المجتمع الديني، فمن كنز ذهبا أو فضة والحاجة قائمة والضرورة عاكفة فقد كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله فليبشر بعذاب أليم فإنه آثر نفسه على ربه وقدم حاجة نفسه أو ولده الاحتمالية على حاجة المجتمع الديني القطعية.
ويستفاد هذا مما في الآية التالية من قوله: “هذا ما كنزتم لأنفسكم” فإنه يدل على أن توجه العتاب عليهم لكونهم خصوه بأنفسهم وآثروها فيما خافوا حاجتها إليه على سبيل الله الذي به حياة المجتمع الإنساني في الدنيا والآخرة، وقد خانوا الله ورسوله في ذلك من جهة أخرى وهي الستر والتغييب إذ لو كان ظاهرا جاريا على الأيدي كان من الممكن أن يأمره ولي الأمر بإنفاقه في حاجة دينية قائمة لكن إذا كنز كنزا وأخفى عن الأنظار لم يلتفت إليه، وبقيت الحاجة الضرورية قائمة في جانب والمال المكنوز الذي هو الوسيلة الوحيدة لرفع الحاجة في جانب مع عدم حاجة من كنزه إليه. فالآية إنما تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة التي هي إيثار الكانز نفسه بالمال من غير حاجة إليه على سبيل الله مع قيام الحاجة إليه، وناهيك أن الإسلام لا يحد أصل الملك من جهة الكمية بحد فلو كان لهذا الكانز أضعاف ما كنزه من الذهب والفضة ولم يدخرها كنزا بل وضعها في معرض الجريان يستفيد به لنفسه الوفا والوفا، ويفيد غيره ببيع أو شراء أو عمل وغير ذلك لم يتوجه إليه نهي ديني لأنه حيث نصبها على أعين الناس وأجراها في مجرى النماء الصالح النافع لم يخفها ولم يمنعها من أن يصرف في سبيل الله فهو وإن لم ينفقها في سبيل الله إلا أنه بحيث لو أراد ولي أمر المسلمين لأمره بالإنفاق فيما يرى لزوم الإنفاق فيه فليس هو إذا لم ينفق وهو بمرأى ومسمع من ولي الأمر بخائن ظلوم. فالآية ناظرة إلى الكنز الذي يصاحبه الامتناع عن الإنفاق في الحقوق المالية الواجبة لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط بل بمعنى يعمها وغيرها من كل ما يقوم عليه ضرورة المجتمع الديني من الجهاد وحفظ النفوس من الهلكة ونحو ذلك. وأما الإنفاق المستحب كالتوسعة على العيال، وإعطاء المال وبذله على الفقراء في الزائد على ضرورة حياتهم فهو وإن أمكن أن يطلق عليه فيما عندنا الإنفاق في سبيل الله إلا أن نفس أدلته المبينة لاستحبابه تكشف عن أنه ليس من هذا الإنفاق في سبيل الله المذكور في هذه الآية فكنز المال وعدم إنفاقه إنفاقا مندوبا مع عدم سبيل ضروري ينفق فيه ليس من الكنز المنهي عنه في هذه الآية فهذا ما تدل عليه الآية الكريمة، وقد طال فيها – لما يتعلق بها من بعض الأبحاث الكلامية – المشاجرة بين المفسرين، وسنورد فيه كلاما بعد الفراغ عن البحث الروائي المتعلق بالآيات إن شاء الله تعالى. وقوله في ذيل الآية: “فبشرهم بعذاب أليم” إيعاد بالعذاب يدل على تحريمه الشديد.