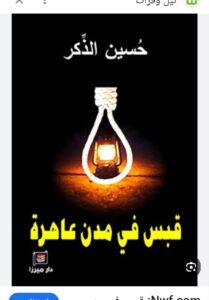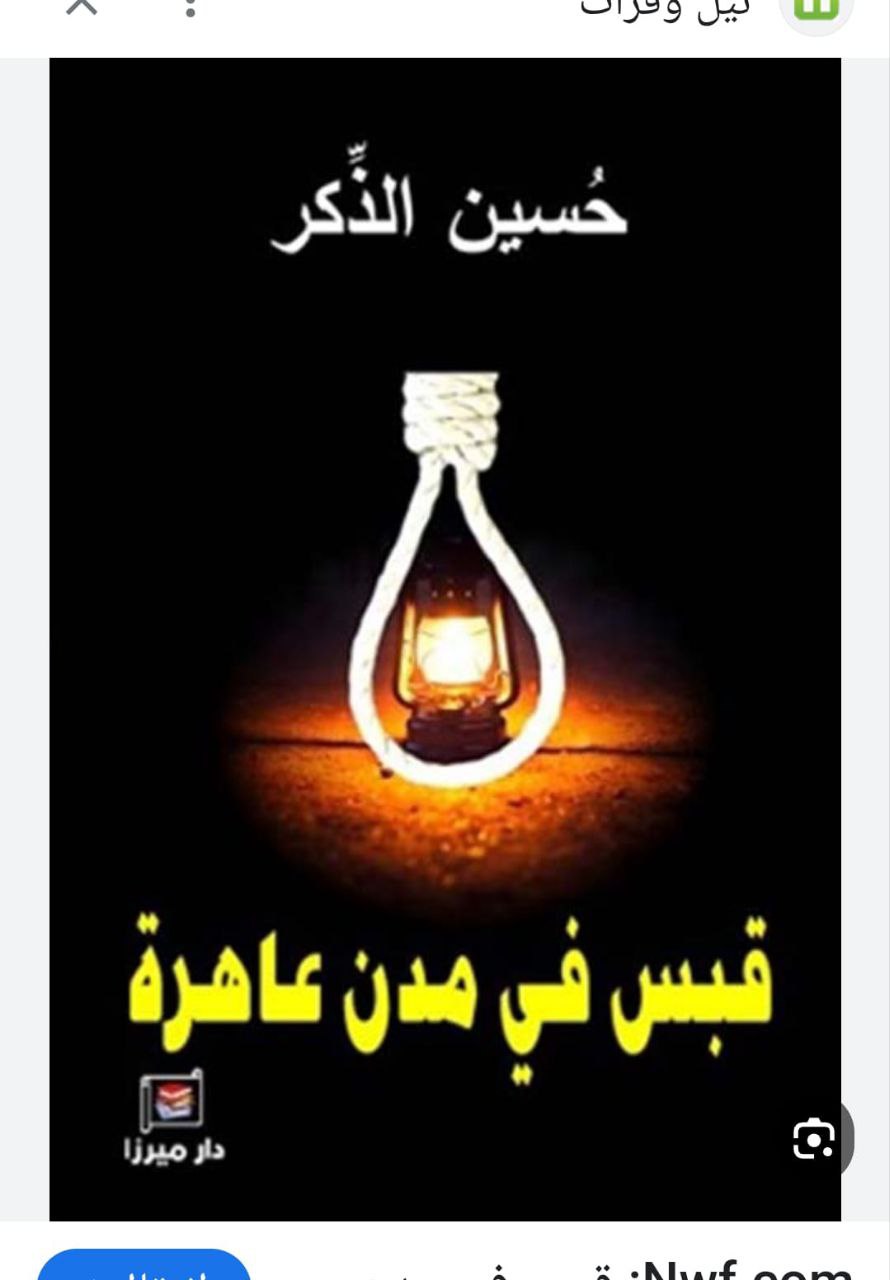قراءة في فساد بعض منتسبي وزارة الداخلية العراقية
رياض سعد
ليست ظاهرة انحراف بعض المحسوبين على ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، ولا سيما جهاز الشرطة، أمرًا طارئًا أو عارضًا؛ فهي أشهر من نار على علم، وأعمق من أن تُختزل في وقائع متفرقة أو أسماء أفراد… ؛ إننا إزاء ظاهرة متجذّرة وضاربة في عمق التاريخ الاجتماعي للدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها؛ ولها امتدادات تاريخية في بنية المجتمعات العراقية ، وتغذّت عبر عقود بل قرون من الاستبداد، والجور والظلم , وضعف المؤسسات، وغياب المساءلة، وتسييس الأجهزة الأمنية… ؛ وقد تراكمت طبقاتها مع الزمن، حتى صارت جزءًا من الوعي الجمعي، وندبة مفتوحة في ذاكرة الناس.
فالشرطة، التي يُفترض أن تكون درع المجتمع وضميره التنفيذي، والتي وُجدت لحماية المواطن وصون كرامته … ؛ تحوّلت في المخيال الشعبي — بفعل تراكم التجارب المريرة — إلى رمز للقهر والخوف والابتزاز… ؛ اذ لم يعد رجل الأمن عند كثير من العراقيين علامة طمأنينة، بل نذير قلق. وصار المواطن يشعر أنه عالق بين مجرم في الشارع، ومنتسب فاسد في الدائرة الامنية وجهاز الشرطة ، فأضحى العراقي كالمستجير من الرمضاء بالنار … .
هذه الصورة القاتمة لم تنشأ من فراغ… ؛ فقد عرف العراقيون، عبر أجيال متعاقبة، أنماطًا من السلوكيات المنحرفة داخل الأجهزة الامنية والقمعية للدولة: من التعذيب، والجور، واستغلال النفوذ، إلى الابتزاز المالي والمعنوي، وصولًا إلى انتهاك الكرامة الإنسانية بأبشع صورها… ؛ حتى إن الذاكرة الشعبية صاغت حكمها القاسي في مقولات متداولة شهيرة ، من قبيل: «إذا سقط الإنسان أخلاقيًا أصبح شرطيًا … ؛ أو راتب الشرطي ورزقه حرام … الخ » وهي مقولات ظالمة ان استخدمت للتعميم، لكنها تعبّر عن حجم الشرخ بين المجتمع والمؤسسة… ؛ نعم , كانت أجهزة الأمن والجيش والشرطة أداة قمع ونهب وجباية جائرة في يد الأنظمة والغزاة والحكام الطغاة ، بدلاً من أن تكون أداة حماية للمجتمع … .
** بطولة الذئب الذي دخل الجنة في المخيال الجمعي ..!!
وفي التراث الاسلامي والعربي والعراقي تُروى حكايات — بغضّ النظر عن أسانيدها — تعكس وعيًا جمعيًا قديمًا بطغيان أعوان السلطة، وتُظهر كيف كان الناس يرون في بكاء الظالم على مصيبته نوعًا من العدالة الرمزية… ؛ و هذه السرديات، وإن كانت أقرب إلى المجاز منها إلى التاريخ، فإنها تكشف عمق الجرح النفسي الذي خلّفته علاقة المواطن برجل الأمن والشرطي .
نعم , لا يُختزل فساد المؤسسة الأمنية العراقية والشرطة في حوادث متفرقة، بل هو ظاهرة تاريخية متجذرة، كشجرة سامة نمت في تربتَين: تربة السلطة المستبدة، وتربة المجتمع المكلوم… ؛ إنها قصة معقدة تتداخل فيها السياسة مع الاجتماع مع النفس، وتُختصر في رواية تحمل دلالات عميقة وموجعة ، اذ ورد عن ابن عباس في ذكر الحيوانات التي تدخل الجنة… ؛ فكان منها “ذئبٌ سلَّطه الله على ابن شرطي ظالم فأكله”… ؛ و هذه الرواية، وبغض النظر عن سندها، تحفر في الوعي الجمعي حفرة نفسية عميقة: صورة الذئب المفترس يتحول إلى أداة عدالة إلهية، بينما رجل الأمن -المفترض أن يكون حامياً- يتحول إلى رمز للظلم الذي تستحق أفعاله انتقاماً حتى من الحيوانات المفترسة! إنها مفارقة تختصر مأساة قرون...!!
اذ تقول هذه الرواية : إن شرطيًا ظالمًا في سالف الزمان كان له ابن وحيد، تعلّق به تعلقًا شديدًا، بينما كان يمارس شتى صنوف التعذيب بحق الناس، لا يرقّ له قلب ولا تدمع له عين… ؛ وذات يوم هجم ذئب على ابنه فافترسه… ؛ فبكى الشرطي بكاءً مريرًا. وتقول الرواية إن الملائكة والمؤمنين فرحوا لذلك البكاء، لا شماتة بالمصاب، بل لأن الظالم لم يعرف معنى الدموع إلا حين مسته الفاجعة شخصيًا.
وبغض النظر عن سند القصة كما اسلفنا، فإن رمزيتها عميقة: فالظالم لا يرى ألم الآخرين، لكنه يكتشف فجأة إنسانيته حين يُصاب في خاصته… ؛ إنها صورة تختصر مأساة السلطة حين تنفصل عن الضمير والرحمة والانسانية .
لقد فقد رجل القانون شرعيته الأخلاقية، ولم يعد الفرق بينه وبين المفترس واضحاً… ؛ و بكاء الشرطي الظالم على ابنه هو اعتراف ضمني بأن الألم الشخصي فقط هو ما يحركه، بينما يتجمد قلبه أمام ألم الآخرين.
هذا ليس تبريراً للعنف، بل هو تحليل لثمرة الاستبداد: فهو لا يدمر المؤسسات فحسب، بل يدمر اللغة العاطفية والأخلاقية للمجتمع، فيصبح التماس الرحمة من الذئب معادلاً موضوعياً لغيابها من قلب من يملك القوة.
**التحليل التاريخي-السياسي: من أداة سلطوية إلى مافيا منظمة
لطالما كانت الشرطة في العراق القديم والحديث ؛ امتداداً أعمى للسلطة الحاكمة وسوطا بيد الحكام الطغاة والمحتلين الغزاة .
ففي العهد الملكي البائس ، حُمِّلت هذه المؤسسة الناشئة مهمة قمع التحركات الشعبية والقومية والشيوعية و وأد الانتفاضات والثورات الجماهيرية ؛ تحت شعار “الحفاظ على النظام”.
ثم جاء العهد الجمهوري الدموي ، ليرسخ هذه الوظيفة القمعية ويوسعها، حيث تحولت الأجهزة الأمنية إلى أدوات بطش في يد الأنظمة المتعاقبة، وصولاً إلى حقبة المجرم السفاح صدام … ؛ التي شهدت ذروة التحول: اذ أصبحت المؤسسة الأمنية دولة داخل الدولة، وشبكة مصالح قائمة على الولاء الشخصي والخوف والفساد المنظم والاجرام والترهيب … .
نعم , كانت الشرطة و الأجهزة الأمنية أدوات قمع بيد السلطة، لا مؤسسات خدمة عامة… ؛ ومن كان يجرؤ على انتقاد هذه الانحرافات والانتهاكات يُزَجّ به في غياهب السجون بتهم جاهزة: المساس بهيبة الدولة، أو الإخلال بالأمن العام ؛ مما عمق الفجوة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع ...!!
بل إن الوقائع المؤلمة تروي كيف جرى التلاعب بالقانون في أبشع صوره: كيف أُفرج عن مجرمين مقابل رشى، وكيف نُسبت جرائم إلى أبرياء، بل وكيف استُبدل بعض المتهمين الحقيقيين بأشخاص ضعفاء مجانين أو فاقدي أهلية لتنفيذ حكم الاعدام بحقهم ؛ في واحدة من أحلك صفحات انهيار العدالة والقانون …!!
حتى إن رأس النظام العفن المجرم صدام اضطر، في لحظة نادرة من الاعتراف العلني ومن على شاشات التلفاز ، إلى الإقرار بأن جهاز الشرطة فاسد، وأن المواطن العراقي يخاف منه، وأن هذا الخوف نفسه صار أداة ابتزاز…!!
اذن , لم تكن تلك الصورة القاتمة عن الشرطة مجرد انعكاس لمخاوف وهمية، بل تأسست على وقائع ملموسة عاشها العراقيون عبر عقود طويلة … ؛ فكثيراً ما برَّأ الشرطي الفاسد المجرمَ والحق التهمة ببريء كما اسلفنا … ؛ بل إن الثنائية بين المجرم ورجل الأمن تلاشت أحياناً ليتحالفا ضد المواطن تحت مظلة الفساد المشترك…!!
**التحليل الاجتماعي-النفسي: تشريح العلاقة السادية بين الحامي والضحية
أنتجت هذه البيئة السياسية علاقة مرضية بين رجل الأمن والمواطن… ؛ اذ تحولت الصورة النمطية للشرطي من “حامي الحي” إلى “ذئب الحي”، كما جاء في احدى الروايات الادبية … ؛ وتشكلت سيكولوجية جماعية تقوم على:
1. الخوف المزمن: خوف المواطن من من يفترض أن يلجأ إليه.
2. الاستعداد للابتزاز: حيث أصبح دفع الرشوة أو “الفدية أو الخاوة ” آلية نفسية للبقاء، كمن يقدم قطعة لحم للذئب لينقذ باقي جسده.
3. فقدان الثقة المطلقة: لم يعد الفساد مفاجأة، بل هو النتيجة المتوقعة لأي تعامل مع المؤسسة الامنية والشرطة .
** بنية الفساد المترسخة في مرحلة ما بعد 2003: الفساد المتحصِّن
بعد سقوط النظام الصدامي الاجرامي ، لم تُقتلع شجرة الفساد، بل تمت “تطعيمها” بأغصان جديدة… ؛ اذ تغيّر الشكل، لكن الجوهر لم يتغير بالقدر المأمول… ؛ صحيح أن هامش التعبير اتسع، وصار بالإمكان فضح بعض الملفات، لكن الفساد أعاد إنتاج نفسه بأزياء جديدة: فكما كان المجرم البعثي سابقًا يحتمي بعشيرته أو منطقته، صار المنتسب الفاسد اليوم يحتمي بحزبه، أو كتلته، أو طائفته، أو شبكة مصالحه… .
والأخطر من ذلك أن القوانين التي وُضعت لحماية المواطنين الأبرياء استُخدمت أحيانًا كدروع للفاسدين والخونة والمنكوسين … ؛ فما من متهم إلا وله جيش من المحامين , أو مرتبط بشبكة كبيرة من الساسة والقادة والمسؤولين … ؛ وما إن يُكشف جزء يسير من فساده وانحرافه حتى تُقام دعاوى “تشهير” لإسكات الإعلاميين والمشتكين، فضلًا عن التهديد والملاحقات العشائرية… ؛ نعم , ويُهدَّد الشهود، ويُلاحق الإعلاميون، وتُغلق الأفواه بالخوف أو العشائر أو الاحزاب ؛ وهكذا يُعاقَب من يبلّغ، ويُكافأ من يبتز…!!
كل هذه الاشكاليات المعقدة ؛ أدت الى هذه النتائج السلبية :
1. الغطاء الطائفي والحزبي: حيث أصبح التعيين والترقية والمنعة مرتبطة بالولاء للزعيم أو الكتلة، لا بالكفاءة والنزاهة.
2. شبكة المصالح الاقتصادية: تحولت بعض الدوائر الأمنية إلى واجهات لعمليات ابتزاز منظمة، من تحصيل “الخوات” من المحال التجارية، إلى الاتجار بالمخدرات عبر السجون، إلى فرض “إتاوات” على المشاريع.
3. القانون المشوَّه: حيث تُستخدم النصوص القانونية كسلاح ضد الضحية، فيقوم الضابط الفاسد بمقاضاة المشتكي بتهمة التشهير، محمياً بموارد الدولة وبطاقات المحامين التابعين للأحزاب.
**ومن الناحية النفسية، نشأ لدى بعض المنتسبين شعور بالقوة المطلقة … ؛ تغذّيه السلطة والسلاح والحصانة غير المعلنة، فتحوّل هذا الشعور إلى سلوك عدواني، وأحيانًا إلى نزعة سادية ترى في المواطن كائنًا قابلًا للإهانة والابتزاز والاستغلال بمختلف اشكاله … ؛ نعم , تراكم لدى بعض المنتسبين شعور بالقوة المطلقة ، فتحوّل هذا الشعور إلى سلوك سادي أحيانًا، وإلى استباحة للناس باعتبارهم “فرائس سهلة”…!!
وهكذا تتكرّر المشاهد: موقوفون يتعرضون للتعذيب داخل مراكز الاحتجاز… ؛ مواطنون يُبتزّون على نقاط التفتيش… ؛ رشاوى تُؤخذ لغضّ الطرف عن تجار المخدرات أو شبكات الدعارة… ؛ شباب يُلاحقون بسبب قنينة خمر، بينما تمرّ شحنات عملاقة محملة بالخمور تحت حماية الفساد… ؛ ضعفاء يُحاسَبون، وأقوياء يُتركون…!!
بل وصلت الانتهاكات في بعض الحالات إلى الاستغلال الجنسي، سواء بحق مواطنين أو حتى بحق منتسبين صغار في الرتبة، في ظل صمت إداري مخزٍ، أو محاولات لطمس الحقائق… .
العجيب المؤلم أن بعض هؤلاء يرفعون راية “الأخلاق العامة”، بينما هم غارقون في كل ما يدّعون محاربته… ؛ يطاردون الناس باسم الفضيلة، ويمارسون الرذيلة في الخفاء… ؛ وكأنهم — بحق — الخصم والحكم في آن واحد.
نعم , المفارقة المأساوية تكمن في ازدواجية المعايير التي يمارسها بعض المنتسبين الفاسدين والمنحرفين … ؛ فهم يلاحقون الشباب لتعاطي الخمر أو لقضايا أخلاقية بينما يغضون الطرف عن مخالفات كبرى مقابل الرشاوى، أو يمارسون هم أنفسهم في الخفاء ما يمنعونه على الناس في الظاهر ؛ وهي ازدواجية تجعل منهم خصماً وحكماً في الوقت ذاته كما اسلفنا، وقد صدق الشاعر عندما انشد : “فيك الخصام وأنت الخصم والحكم”.
وتتنوع أشكال الفساد والابتزاز في وزارة الداخلية اليوم، فمن بيع الحلوين في السجون والمتاجرة بالمخدرات، إلى التعذيب الوحشي للموقوفين وأخذ الرشاوى وابتزاز المواطنين تحت مختلف الذرائع… ؛ كما برزت في السنوات الأخيرة قضايا استغلال جنسي داخل المؤسسة نفسها، حيث يستغل بعض الضباط نفوذهم لممارسة الابتزاز الجنسي ضد منتسبين شباب من صغار السن أو مرؤوسين، كما ظهر في حوادث تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يهز ثقة المواطن بالمؤسسة ويضعف هيبة الدولة.
**اجتماعيًا، أنتج هذا الواقع ثقافة خوف عامة، دفعت كثيرين إلى الصمت، وقايضت العدالة بالأمان المؤقت.
ومن هنا نفهم لماذا تتكرّر أنماط بعينها: ابتزاز المواطنين بذريعة الخمور أو “الأخلاق العامة”، بينما يُغضّ الطرف عن شبكات أكبر مقابل الرشى؛ ملاحقة الضعفاء، والتساهل مع الأقوياء؛ محاربة مظاهر معينة علنًا، وممارستها سرًا. وكأن المؤسسة تعيش انفصامًا أخلاقيًا حادًا: تُدين في الخارج ما تحتضنه في الداخل.
ولا تقف الانتهاكات عند حدود المال. فالتقارير والفضائح المتكررة تكشف عن استغلال جنسي، وتعذيب للموقوفين، واتجار بالممنوعات، وتصفية حسابات شخصية تحت غطاء القانون. ومع كل فضيحة، تهتز ثقة المواطن أكثر، وتتآكل هيبة الدولة، ويتعمّق الشعور بأن العدالة انتقائية.
إن أخطر ما في الأمر ليس وجود الفساد بحد ذاته — فذلك موجود في كل المجتمعات — بل غياب منظومة ردع حقيقية… ؛ فلو وُجدت إرادة سياسية جادة، لأمكن لوزارة الداخلية، بالتعاون مع القضاء، تشكيل خلايا نزاهة واستخبارات مستقلة من شخصيات مهنية معروفة بالنزاهة، وفتح قنوات آمنة وسرية لتلقي شكاوى المواطنين، بعيدًا عن الترهيب والانتقام… ؛ عندها فقط ستنكشف ملفات لو كُشف غطاؤها لارتجف لها الضمير الوطني.
إن ما يجري يوميًا من تجاوزات على يد من يفترض بهم حماية القانون ليس مجرد أخطاء فردية، بل أعراض مرض بنيوي: دولة لم تحسم بعد علاقتها بالمواطنة، ومؤسسات لم تتحرر كليًا من إرث القمع، ونظام سياسي سمح بتغوّل الولاءات الفرعية على مفهوم الخدمة العامة والمواطنة العراقية .
وعليه، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق المنتسب الفاسد وحده، بل على المنظومة التي سمحت له، وحمته، وسكتت عنه… ؛ و الإصلاح الحقيقي يبدأ من تطهير المؤسسات، وإنزال العقوبات العادلة بلا تمييز، وإعادة بناء رجل الأمن بوصفه خادمًا للقانون لا سيدًا على الناس.
**المعالجات المقترحة
إن معالجة هذه الظاهرة البنيوية تتطلب إرادة سياسية حقيقية غير مجزأة، وإصلاحاً مؤسسياً شاملاً يبدأ بتشكيل خلايا تحقيقية نزيهة ومستقلة، تضم عناصر ذات كفاءة ونزاهة مختارة بعناية، وتوفر قنوات اتصال آمنة للمواطنين للإبلاغ دون خوف… ؛ كما يجب فك ارتباط المؤسسة الأمنية بالولاءات الحزبية والطائفية الضيقة، وربط الترقيات والحوافز بالأداء والنزاهة فقط، وتطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن منصبه أو انتمائه.
نعم , إن معالجة هذا الورم الخبيث تتطلب جراحة شجاعة لا ترحم:
أولاً: سياسياً: فصل المؤسسة الأمنية عن المحاصصة الطائفية والحزبية… ؛ و جعل التعيين والترقية والمساءلة خاضعة لمعايير الكفاءة والنزاهة فقط، تحت إشراف هيئات مستقلة كما اسلفنا .
ثانياً: اجتماعياً: بناء جسور الثقة عبر مبادرات ملموسة: إنشاء قنوات اتصال آمنة ومجهولة للإبلاغ، وحماية المشتكين، ونشر نتائج التحقيقات والعقوبات بشكل علني لاستعادة المصداقية كما اسلفنا .
ثالثاً: نفسياً وأخلاقياً: إعادة تأهيل المنتسبين عبر برامج مكثفة تعيد تعريف مفهوم “الشرطة” من “جهاز قمع” إلى “خدمة مجتمع”… ؛ ترسيخ فكرة أن القوة أمانة، وأن الزي شرعية وليس حصانة , والتركيز على ضرورة مراعاة حقوق الانسان .
**وفي الختام :
إن هذه الظاهرة، رغم خصوصيتها في السياق العراقي بفعل تراكمات تاريخية قاسية، إلا أنها ظاهرة إنسانية معقدة قد تظهر في مجتمعات أخرى تحت وطأة أنظمة فاسدة أو حروب مستمرة… ؛ وهي تستدعي، كما رأى الفيلسوف اليوناني فيثاغورس عندما شاهد شرطياً يضرب سارقاً، التأمل في طبيعة السلطة وانحرافها ؛ اذ قال : “عجباً! حرامي السرّ يضرب حرامي العلانية!”.
فالفاسد الذي يستخدم سلطة الدولة لابتزاز الناس هو في حقيقته “حرامي علانية”، لكنه أكثر خطورة من حرامي السر ؛ لأنه يحمل سيف القانون ويستظل بظل الدولة… ؛ والإصلاح يبدأ بالاعتراف بالداء قبل وصف الدواء، وبالعزم على كسر حلقة الخوف والصمت التي استمرت لأجيال.