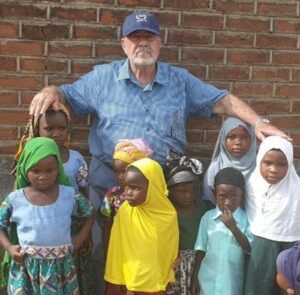رياض سعد
منذ أن فتحتُ عينيّ على هذا العالم، كانت السماء أوّل مرآةٍ أبصرتُ فيها وجهي الحقيقي… ؛ لم أكن أبحث عن الله في المعابد، بل في اتّساع الزرقة التي تملأ الأفق، في ذلك الهدوء الأبديّ الذي لا يشيخ… ؛ كنتُ، كما يولد بعض الأطفال بعيونٍ زرقاء، قد وُلدتُ بإيمانٍ فِطريّ لا أعرف من أين جاء، إيمانٍ كأنّه جينٌ في خلايا الروح، لا في الجسد… لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِيمَانَ الْعَقِيدَةِ، بَلْ حَنِينَ الْغَرِيبِ إِلَى مَوْطِنِهِ الْأَزَلِيّ… ؛ كَأَنَّنِي وَالِدٌ فاقد بِلَا ذِاكرة ، أَعْشَقُ طِفْلًا لَمْ أَرَهُ قَطُّ … ؛ كنتُ أُحادث القمر كما يُحادث الطفلُ صديقه المقرّب، وأشعر، بصفاءٍ غريبٍ، أنّه يتبعني حيثما سرت، وأنّ الله يطلّ من خلفه مبتسماً، كأنّهما كائنان من نورٍ واحد...!!
كنت وأنا أرفعُ عينيّ إلى السّماء، أبحثُ عن صانعها… ؛ أو بالأحرى، كنتُ مؤمناً بإلهٍ ما إيماناً فطريّاً غامضاً، لا أدري من أينَ أتى ولا كيف تشكّل… ؛ فقد وُلدتُ محمّلاً بحُبٍّ للهِ، لدرجة أنّي كنتُ أتوهمُ أنهُ يسيرُ إلى جانبي… ؛ كنتُ صغيراً أتمشّى في الأزقّة، أتأمّلُ القمرَ وهو يلاحقني كظلٍّ وفيّ، يقطعُ المسافاتِ ذاتها، يجتازُ الشوارعَ ذاتها، ينزلقُ فوقَ أسطحِ المنازل… ؛ ولم أكنْ أميّزُ وقتَها بينَ ضوءِ القمرِ الباردِ وضوءِ اللهِ الدافئ؛ كانا في وجداني شعاعاً واحداً...!!
منذ أن وعيتُ على وجودي، كنت أشعر أنني ضيفٌ على هذه الأرض، لا ابنٌ لها… ؛ كأني جئتُ محمولًا على غيمةٍ من ضوءٍ … ؛ جئتُ من جهةٍ لا تعرف الاتجاهات، ومن زمنٍ لا يُقاس بالساعات… ؛ نعم منذ أن وعيتُ على السماء، شعرتُ أن بيني وبينها حبلًا خفيًا من الحنين… ؛ كنتُ أنظر إلى القمر، لا كجسمٍ مضيءٍ في العلوّ، بل كذاكرةٍ تعرفني أكثر مما أعرف نفسي… ؛ كنتُ أظنه الله، أو ظلًّا من ظلاله المقدسة ، لأنني كنتُ أشعر أنه يراني في العتمة، ويمشي معي حين أمشي، كرفيقٍ صامتٍ يعرف سرّي ولا يسألني عنه… ؛ ثم أُلقيتُ في رحم التراب لأتعلم ثِقل الوجود , أُلقيتُ في جسدٍ من طينٍ، كروحٍ ضلّت طريقها إلى الفضاء… ؛ كما يُلقى الطائر في القفص ليفهم معنى الجناحين… ؛ لم أتعلم الإيمان من أحد، بل وُلد الإيمان في داخلي كما تولدُ الأشجار من أسرار البذور، وكما تنبثق الشرارة من جوف الحَجَر.
نعم , كنتُ أنظر إلى السماء كمن ينظر إلى وجه أمه الأولى… ؛ كنتُ أرى القمر وأحسّ أنه يتبعني ، لا لأنه جرمٌ سماويّ، بل لأنه ظلٌّ من ظلال الله يمشي معي… ؛ كنت أؤمن أن الله يراقبني من وراء ستائر الضوء، وأن النجوم عيونُه المتناثرة في الأبد...!!
كُنْتُ أَعِيشُ فِي وَهْمٍ جَمِيلٍ : أَنَّ الْقَمَرَ لَيْسَ جِرْمًا فَلَكِيًّا، بَلْ عَيْنَ الْحَقِّ الْغَائِبَةِ، تَتْبَعُنِي فِي ظُلُمَاتِ الزُّقَاقِ، تُلَقِّمُنِي مِنْ ضِيَائِهَا الْبَارِدِ رَغِيفَ الْيَقِينِ … ؛ لَمْ أَكُنْ أُمَيِّزُ بَيْنَ انْسِكَابِ النُّورِ مِنْ فَلْذَةِ السَّمَاءِ، وَانْسِكَابِ الرَّحْمَةِ مِنْ مَلَأٍ أَعْلَى… ؛ كَانَا سِيَّانَ فِي مَمْلَكَتِي الْوَهمِيَّةِ.
ذات يومٍ، تكسّرت تلك البراءة على حجر الواقع الاصم … ؛ فبينما كنتُ غارقاً في هذا الوَهْمِ الجميل، سمعتُ طفلاً في زقاقنا يسبُّ اللهَ ويشتمُه، كما اعتادَ جيرانُنا أن يفعلوا حينَ يغضبونَ أو حتى حينَ يفرحون … !!
فانتابني غضبٌ عارمٌ لم أفهم مصدره ، شعورٌ بالانتهاكِ والغَدر، فاندفعتُ نحوهُ وضربتُ رأسهُ بعصاً كانتْ بيدي، حتى سالَ الدمُ من جبينهِ قليلاً… ؛ فارتعش داخلي شيءٌ لا أعرفه، شيءٌ بين الندم والإخلاص… ؛ ذهبنا معاً إلى أمّه، هو يبكي وأنا أُفورُ استياءً… ؛ وعندما رأتِ الأمُّ طفلها بتلكَ الحالة، صُعقتْ وسألتني: “لماذا ضربتَه؟”
أجبْتُها ببراءةِ المؤمنِ المُتألّم: “لأنه سبَّ اللهَ وشتمَه!”
فردّتْ عليَّ بانفعالٍ وصوتٍ عالٍ: “أاللهُ أحدُ أقربائكَ ونحن لا نعلم؟ مالكَ ومالَ اللهِ؟ أأنتَ محاميه؟”
سكتُّ… ؛ لكنّ صمتَ الطفل الذي لم يحر جوابا والسماء في تلك اللحظة كانا أكثر ضجيجاً من أيّ كلام.
ثمّ أمسكتْ بذراعي وجرّتني إلى أهلي تشكوني...
بعدَ تلكَ الحادثة، أدركتُ أنّ الله لا يدافع عن نفسه، لأنّ عظمته تترفع عن الخصام… , و فهمتُ يومها أن الله لا يحتاج من يدافع عنه , وعندها عرفتُ أن الله لا يحتاج من يحميه، بل من يراه… ؛ وأنّ غضبي كان جهلًا مقدّسًا، لأنني ظننتُ أن النور يُهان بالكلمات، ولم أدرِ أنه لا يُمسّ إلا بنوايا القلوب النقية … ؛ كما أدركتُ أنّ الله ليس قمراً يلاحقُ الأطفالَ في ظلامِ الشوارع، وأنَّ بعضَ الناسَ يكرهونَه بقدرِ حُبّي له … ، وأنّ القمر ليس وجهه، ولا النجوم عيونه ، لكنّ الضوء الذي يربطهما بي هو الحبل السرّي الذي يغذّي إيماني منذ ولادتي والى هذه اللحظة … ؛ كما انتابني شعور حينها بأن الله ليس في الأعلى كما نُشيع، بل في النقطة التي تتقاطع فيها الدموع بالنور، والعجزُ باليقين... ؛ و لكنّ تعلّقي بالسّماء بَقِيَ كما هو، بل ازدادَ عمقاً وغموضاً … !
كبرتُ، لكنّ طفولتي لم تشخ… , بقيتُ أرى النجوم كأبوابٍ لمنازل أعرفها، وأسمعها تناديني بأسماءٍ نسيتها على الأرض… , كنتُ أحلم بالسفر إلى كوكبٍ لا تُغلق فيه الأرواح في أقفاص الأجساد، ولا يُقاس فيه الحبّ بالتراب… ؛ كلّما نظرتُ إلى السماء، شعرتُ أنني أتذكر، لا أتأمل… ؛ كأنّ تلك النجوم هي طفولتي الحقيقية التي نُسيت هناك … ؛ كلّما نظرتُ إلى النجوم، شعرتُ أنّها أوطانٌ سابقة، وأنّني منفيّ على هذا الكوكب الطينيّ… ؛ كنتُ أؤمن أنّ في صدري غبارَ مجرّةٍ نائية، وأنّ في قلبي جرحَ نجمٍ سقط منذ ملايين السنين ولم يُدفن بعد… ؛ الثرى لا يشدّني، لا أهوى التراب كما يفعل أبناء الأرض , ولا زلت اعتقد انها مقرا للجحافل الشيطانية ومعسكرا للجيوش الظلامية … ؛ لذا تهفو روحي إلى الثريا، إلى مجرّاتٍ بعيدةٍ لا تعرف ثقل الجاذبية ولا وحلَ الخطيئة والجريمة ... ؛ لم أكن أحبّ الأرض، لا لأنّها شريرة فحسب ، بل لأنّها تُحبّ الثقل ، وأنا ابنُ الخفّة والنور… ؛ كنتُ أؤمن أنّ أرواحنا ليست من هنا، وأنّنا نعيش تجربة النسيان الكبرى: نسيان الأصل السماوي في طين الجسد الارضي … .
واليوم، بعد أن شاخت أيّامي وتجعدت ذاكرة السنين، ما زلتُ أصعد إلى سطح البيت كمن يستعدّ للرحيل… ؛ أحدّق في السماء، أراقبها كما يراقب عاشقٌ نافذةَ معشوقته التي لم تُفتح له يوماً… ؛ أنتظر نيزكاً يضلّ طريقه نحوي، أو سفينةً من ضوءٍ تهبط عليّ بهدوءٍ لتأخذني إلى مكاني الحقيقي بين الكواكب... ؛ أريد أن أعود إلى تلك المجرّة التي سقطتُ منها صدفةً، إلى حضن الضوء الذي نسيني بين الكواكب… ؛ هناك فقط، سيتذكّرني الله، لا كعبدٍ من تراب، بل كشرارةٍ هاربةٍ من نوره القديم.
وحين اشتعل شيبُ العمر، لم أعد أخاف الموت ، إنّما أخاف الأرض حين تبتلعني … ؛ أفضّل أن تفتتني النيازك وتذرّيني في فضاءٍ لا نهاية له، على أن تتغذّى الديدان على جسدي… ؛ فالتراب، في النهاية، ليس وطني… , أمّا النور، فكان ولا يزال عنوانَ مولدي الأبديّ.
هَا قَدْ أَظَلَّنِي الْهَرَمُ، وَمَا زِلْتُ أَحْنُو كَالسَّاجِدِ نَحْوَ السماء ، أُرَاقِبُ الْفَضَاءَ… ؛ لَسْتُ أَنْتَظِرُ مَلَائِكَةً وَلَا كَائِنَاتٍ فضائية ، بَلْ أَنْتَظِرُ سَفِينَةَ الْغُفْرَانِ الْأَخِيرَةِ لِتَعُودَ بِي إِلَى بَيْتِي الْحَقِيقِيّ… ؛ إِنِّي لَأَفْضِلُ أَنْ تَتَقَطَّعَ أَوْصَالِي فِي احْتِضَانِ الشُّهُبِ الْمُتَّقِدَةِ، عَلَى أَنْ تَذُوبَ فِي سُكُونِ التُّرَابِ… ؛ فَالْمَوْتُ فِي السَّمَاءِ رِحْلَةٌ، وَالْمَوْتُ فِي الْأَرْضِ انْتِهَاءٌ وفناء .