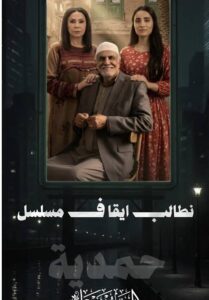رياض سعد
كان عاصي يُهيِّئُ نفسَهُ للخروج إلى دُكَّانه في أحد الشوارع الشعبية العتيقة، حيثُ تتشابكُ الأصوات كما تتشابكُ الأسلاك فوق الرؤوس، ويختلطُ عرقُ النهار برائحة الخبز الخارج من الأفران …
وما إن همَّ بارتداء معطفه حتى رنَّ الهاتفُ الأرضيُّ في زاوية البيت رنينًا نادرًا، كأنما هو طائرٌ غريبٌ حطَّ على نافذةٍ قلَّما تُزار …
وكان ذلك الجهاز العتيق، في تلك الأيام، أشبهَ بنافذةٍ سحريَّة يطلُّ منها الإنسان على عالم الغيب، يختصر المسافات، ويصطاد الأصوات البعيدة، قبل أن تصبح وسائل التواصل مرايا نعكس فيها وجوهنا المزيَّفة …
نعم , لم يكن الهاتفُ يومئذٍ مُتاحًا في كلِّ بيت، وكان صوته يُعدُّ حدثًا، كأنَّهُ بابٌ يُفتح على المجهول، أو خيطٌ يمتدُّ من دارٍ إلى دارٍ ليختصر المسافات ويجمع المتباعدين… ؛ وكان الناسُ يتَّخذونه وسيلةً للوصلِ والأنس، وربما للهوٍ عابرٍ مع أصواتٍ لا تُرى احيانا ؛ فيؤدِّي دورًا يشبه ما تؤدِّيه اليومَ وسائلُ التواصل، مع فارقٍ في البراءةِ والرهبة …
رفع السمَّاعة، فإذا الصوت لزيدان، صديقه الأقرب من شريان القللب
زيدان : أين أنت يا عاصي
عاصي : “في البيت، على وشك الخروج إلى المحل”
زيدان :”حسناً، سأنتظرك هناك”
عاصي : “ما بك؟ صوتك يقطر قلقاً… خيرٌ إن شاء الله؟”
زيدان : تعال، وأخبرك. لا تتأخّر…
انقطعت الكلمات، وبقي في الأذن رجعُها، كأنَّها صدى حجرٍ أُلقي في بئرٍ عميقة… ؛أغلق الخط، وسارع الخطى نحو المحل … ؛كان دكَّان زيدان غير بعيدٍ عن دكَّان عاصي …
وحين وصل، رآه واقفًا كتمثال من حزن … ؛ مسمَّرًا أمام باب دكّانه كأنَّ الأرض ابتلعت ظلَّه… ؛ لم يكن ذاك الرجلَ الذي اعتاد أن يسبق ضحكُهُ كلامَه، بل بدا كغصنٍ كُسِرَ في ريحٍ عاتية …؛ فالوجوم يغطّي ملامحه التي اعتاد منها النكتة والضحكة الصافية …
قال عاصي وهو يربت على كتفه :
ما خطبك يا صاحبي؟ أين ابتسامتك التي كانت تغسل هموم الدنيا وتصلح ما تفسده الايام ؟
رفع عينيه، وفيهما شرر الحيرة ورماد الألم، وتنهد زيدان، كأنَّهُ يُفرغ صدره من دخانٍ ثقيل … ؛ وبدأ يحكي :
البارحة، تأخّرت في العمل حتى منتصف الليل، أُصلح سيارة لأحد الزبائن، وكنت أشرب الخمر كعادتي… ؛ لما هممت بالعودة، وسرت نحو البيت، طرقت الباب فسمعت جلبةً خافتة في الداخل… ؛ تراجعت خطوة، ورفعت رأسي إلى السطح، فرأيت الشاب كريم يقفز من سطحنا إلى سطحهم المجاور كأنه ظلٌّ هارب أو لص فار …؛ مسرعًا كأنَّ خلفه نارًا .
صمت لحظةً، ثم أردف ؛ فتحت زوجتي سعاد الباب , ودخلت , كانت سعاد مضطربة ؛ وجنتاها محمرتان، ونَفَسُها متقطِّع، ترتجف كغصن في مهب الريح، والعرق يتصبّب منها كأنها خرجت لتوِّها من معركة عاطفية او لقاء رومانسي حميم … ؛ ثم قالت: “ما بك؟
فقلت: “رأيت كريم يقفز من سطحنا!”
أجابت: “كنت نائمة، ما شعرت بشيء…
لكن نظرة خاطفة إلى وجهها كانت كافية لتمزيق أكذوبتها، فليس فيه أثر للنوم ولا وسن …
نعم , قالت إنَّها كانت نائمة… ؛ لكنَّ النوم لا يتركُ هذا الاضطراب على الوجوه, ولا يخلف وراءه تلك العلامات الفارقة …
صعدنا إلى السطح معا … ؛ وجدنا آثارًا مبعثرةً من دقيقٍ وسكَّرٍ وعدسٍ وحمص على سلالم الدرج، كأنَّ يدًا مرتعشةً مرَّت من هناك… ؛ وكأنها فتات ذكرى …
ربتت على كتفي وقالت: “لا تهتم، لعل كريم كان يبحث عن حمامة له، فهو (مطيرجي) ويعشق الطيوركما تعلم ؛ فلا تعطي للامر أهمية …
ثم خفض صوته حتى كاد يلامسُ الأرض …؛ حاولتُ أن أُقنع نفسي… ؛ لكنَّ قلبي لم يطاوعني …
في غمرة السكر، اندفعت نحوها، وما أن ألقيتها على السرير حتى رأيت الفراش مكومًا كأن عاصفة مرَّت به , ففيه فوضى لا تشبه عادتنا … ، وبقعاً حليبية لم تجف بعد… ؛ تجاهلت الأمر، لكنني حين هممت بها، رأيت في عينيها نفوراً كأنني غريب، وجسدها كان رطباً على غير عادته، كأنما خرج لتوِّه من بحر …!!
سألتها: “ما بالك الليلة؟”
قالت: كنت في الحمام فاغتسلت…
لأول مرة، شعرت أنني مع امرأة لا أعرفها، امرأة غريبة تمارس دور زوجتي …
كان الكلام يتساقط بيننا كأوراق خريفٍ مبكر …
شيءٌ انكسر، يا عاصي… ولا أعرف أهو الظنُّ أم اليقين …؟!
في الصباح، تذكرت كل شيء، فلم تقنعني تبريراتها… ؛ اتصلت بك لأستشيرك، وأرجوك أن تخبر أهل الشاب كريم بالامر …
ذهب عاصي إلى الحاج خالد، والد كريم، فطلب المهلة… ؛ وبعد يومين، أرسل الحاج خالد “أبا الهيل”، مختار المحلة، وكان رجلاً بعثياً حقيرا متضخماً بسلطته الوهمية …
دخل أبو الهيل إلى دار زيدان، وقال: “هذه الأمور تحدث في كل مكان… ؛ كريم شاب، يحب الطيور، قفز إلى سطحكم وراء حمامه … “
رد زيدان: أيعقل أن يطارد الحمام بعد منتصف الليل ؟!
قال أبو الهيل: أتتهمه بسرقة الطعام يا زيدان ؟
قال زيدان: رأيت آثار الطعام على سلالم الدرج … ؛ لكني لست متأكدا …
التفت أبو الهيل إلى عاصي: “وأنت، ما دخلك؛ زيدان من عشيرة وأنت من أخرى…؟!
فرد عاصي: “وما دخلك أنت؛ الحاج خالد من قبيلة وأنت من أخرى …؟!
قال أبو الهيل متعجرفاً: “أنا وجيه ومعروف ، والناس تكلفني بإصلاح ذات البين , وحل الخصومات …
فرد عاصي: وأنا، رغم صغر سني، ابن مشيخة عشائرية تعرفها أنت وأبوك، فلست من سقط المتاع …
تراجع أبو الهيل قليلاً، وطلب من عاصي الخروج للحديث على انفراد …
في الشارع، قال له: الأمر أكبر مما تتصور… ؛ كريم لم يسرق طعاماً، بل سرق الناموس والعاقل يفهم بالإشارة …
صعق عاصي، وكأن الأرض انفتحت تحته… ؛ عادا إلى زيدان، فنصحه عاصي بطي الصفحة وتجاوز الأمر… ؛ وأُغلِقَ الحديثُ كما تُغلَقُ نافذةٌ على عتمة… ؛ قيل له إنَّ الأمرَ سوءُ فهم، وإنَّ كريمًا كان يطاردُ حماماته، وإنَّ إشاعةً كهذه تُفسدُ البيوت وتُشعلُ الفتن… ؛ قيل الكثير، وسُكِتَ عن الأكثر؛ اقتنع زيدان، ليس اقتناعاً بالتبريرات، بل ثقة بصديقه الذي كان أقرب إليه من حبل الوريد …
وفي أحد الأيام، طرق عاصي باب زيدان… ؛ فتحت له سعاد واستقبلته بنظرةٍ غامضة ، وقالت: “تفضل، إنه في الداخل ينتظرك …
دخل، فأغلقت الباب خلفه بهدوءٍ ثقيل … ؛ جلس في الغرفة ينتظر، فلم يأت زيدان… ؛ أحس بغصة في حلقه، وريبة تسري في دمه … ؛كأنَّهُ انسحب من المشهدِ ليدع الحقيقة تواجهه وحده …
جاءت بالشاي … ؛ وسألها عاصي : أين زيدان ؟!
ردت سعاد : سيأتي , لا تقلق …
ثم أطرقت قليلاً، ورفعت عينيها إليه: “أعجبني دفاعك عن صديقك زوجي زيدان أمام أبي الهيل، وفخرك بأصلك، وقوة شخصيتك … ؛ فيك صلابةٌ لا أراها في غيرك …
رفع عاصي عينيه، فرأى في كلامها ظلَّ اعترافٍ لا يُقال… ؛ لم تُنكر، ولم تُصرِّح؛ لكنَّ المعاني كانت تتسلَّل بين الكلمات كالدخان …
رد عاصي بارتباك: هذا واجبي تجاه صديقي فقط …
ثم قالت سعاد بصوت خفيض: “أنت غير متزوج، وتحتاج لأنثى… ؛ ثق بأن إصبعك الصغير لا يدخل في فرجي من شده نظافته وضيقه …!!
ارتد عاصي إلى الوراء، كمن لدغته أفعى… ؛ احتقن وجهه غضباً: “أتعلمين؟ لقد عرفت بعلاقتك مع كريم، وكتمت السر، ليس حباً بكِ، بل شفقة على صديقي، وخوفاً عليه من الصدمة النفسية وتداعيات الثأر والانتقام …
ردت ببرود غريب , و بنبرةٍ أقرب إلى التحدي منها إلى التبرير :
سأخبرك السر… ؛ نحن النساء، وأنا منهن ، لا نحب الرجل الحنون كثيراً… ؛ زيدان حنون جدا، بينما كريم قاسٍ، وقسوته تشعرني برجولته رغم صغر سنه … ؛ و لا نحب الخجول، فالحياء للنساء لا للرجال، وزيدان خجول، وكريم وقح، نكحني على السطح وهو عريان ولم يخف أحداً أو يستحي … ؛ و لا نحب الطيب، نعتبره ساذجاً، وزيدان طيب حد البلاهة، وكريم لا يرى إلا مصلحته ولا يعبأ بالاخرين …
نحنُ—معشرَ النساء—لا نبحثُ دائمًا عمَّن يُحسن إلينا، بل عمَّن يُشعرنا بأنَّنا مرغوبات… ؛ الطيبةُ وحدها لا تُغري، والحياءُ إذا جاوز حدَّهُ صار عارا …
ولا نحب المتدين، فالمتهتك يثير فينا شهوتنا البدائية… ؛ و لا نحب الفقير، وزيدان فقير، وكريم يسرق من أبيه ليطعمني… ؛ و نحب الرجل الجميل والشاب القوي الوسيم ، وكريم جميل وقوي وصاحب عضلات بارزة، وزيدان قصير ذو كرش مترهل … ؛ وأهم شيء: نحب الرجل المتكلم، وزيدان صامت، وكريم يسد فراغي بكلامه … ؛فالرجلُ الذي لا يتكلم، لا يُسمعُ في القلب …
كان كلامها خليطًا من رغبةٍ وندم، من سطحٍ لامعٍ وعمقٍ موحل… ؛ شعر عاصي أنَّ البيت يضيق، وأنَّ الهواءَ صار أثقل من أن يُتنفَّس …
نهض كالمصدوم دون أن يُتمَّ حديثًا… ؛ وخرج دون كلمة ؛ أدرك أنَّ بعض الأسرار إذا كُشفت، لا تُصلح، بل تُعمِّقُ الشقَّ في الجدار…
ومنذ ذلك اليوم، ابتعد عن زيدان؛ لا قسوةً عليه، بل عجزًا عن حمل ما عرف …
ثم مضت سنوات… ؛ والتقيا صدفةً في مناسبةٍ اجتماعية… ؛ كان الشيبُ قد خطَّ في رأس زيدان طريقًا جديدًا، لكنَّ عينيه ظلَّتا تحملان تلك الطيبةَ القديمة، طيبةَ من يصدِّق ما يُقال له لأنَّهُ لا يعرف كيف يشكُّ طويلًا …
تصافحا،وتبادلا السلام … ؛ وسأله عاصي عن أحواله…
قال زيدان: طلقت سعاد..
قال عاصي: “أفضل لك، أحسنت الصنع ..
سأله زيدان: “ولماذا تقول ذلك ؟!
ارتبك عاصي ثم اجاب : “أنت لبيب يا زيدان ، وأكيد لم تنسجم معها، فطلقتها…؛ فأنا لا أعرفها، ولم أكلمها قط …
نظر إليه زيدان نظرةً قصيرة، ثم ابتسم ابتسامةً باهتة… ؛وكعادته، اقتنع زيدان بالجواب، ومضى في غيبوبته الجميلة، بينما ظل عاصي يحمل سراً يثقب قلبه كالسهم … ؛ ثم التزم الصمت .
كان في صمته تسليمٌ، أو تعبٌ من الأسئلة… ؛ أما عاصي، فمضى وهو يُفكِّر: كم من البيوتِ لا تهدمها الخيانةُ وحدها، بل يهدمها الصمتُ الذي يأتي بعدها؟
وكم من السطوحِ تشهدُ بما لا تقوله الجدران؟
وفي المساء، حين عاد إلى بيته، سمع في ذاكرته رنينَ الهاتفِ القديم… ؛ و أدرك أنَّ بعض الأصوات، مهما خفتت، تبقى ترنُّ في الداخل طويلًا؛ وأنَّ الإنسان قد ينجو من الفضيحة، لكنَّهُ قلَّما ينجو من صدى الحقيقة …