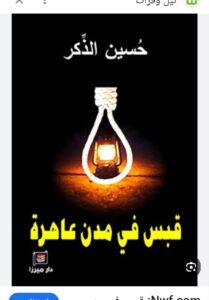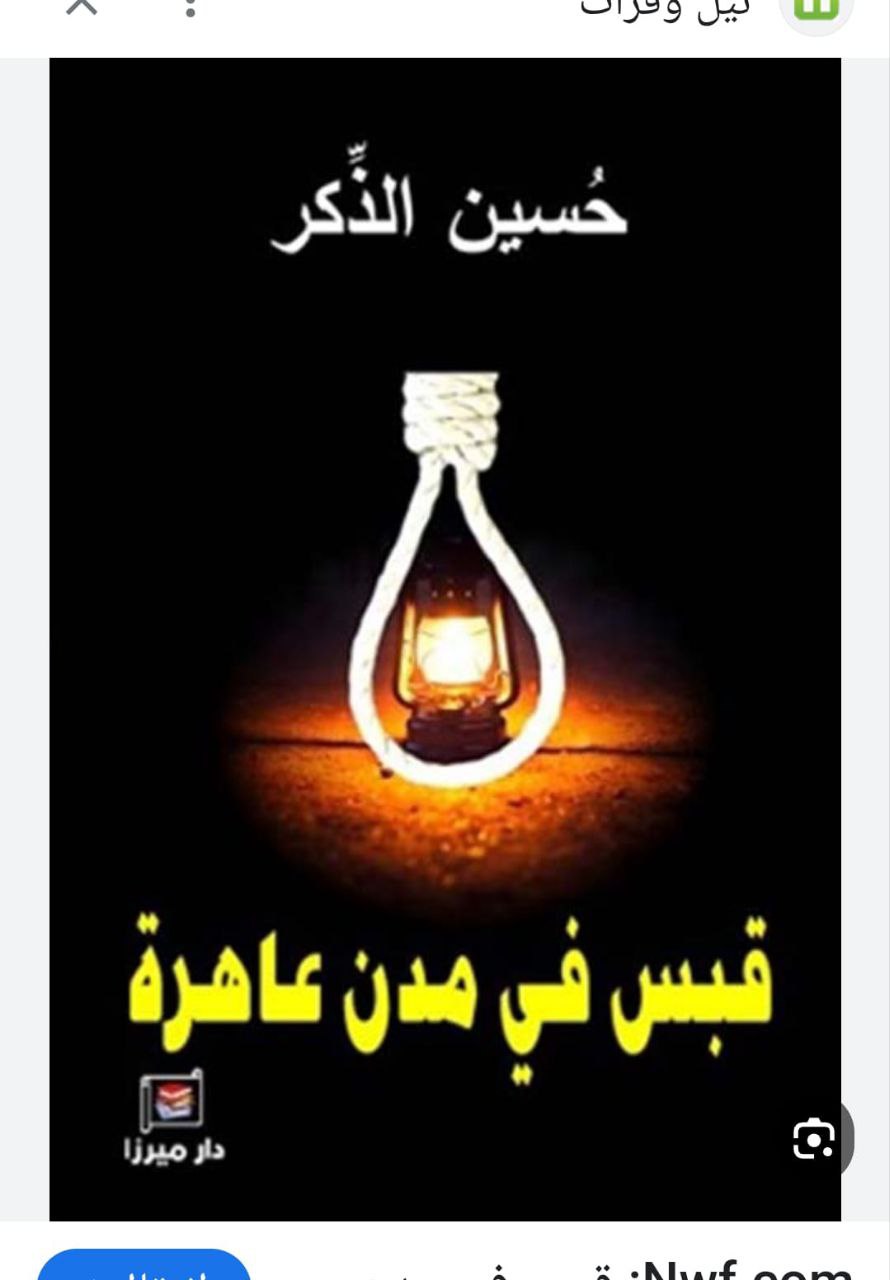البرابرة في المنعطف
كتب رياض الفرطوسي
في المنعطفات لا تُطلق الأبواق،
ولا تُرفع الرايات.
هناك، في تلك اللحظة الصامتة التي تسبق الاصطدام،
تُحسم الاتجاهات.
إما أن ترى ما يقترب،
أو تواصل الطريق بعينين مغمضتين…
وتصطدم.
في مثل هذه اللحظات، لا يدخل البرابرة من الأبواب،
بل يصعدون إلى المنصّات،
وحين يفعلون ذلك،
تصفّق الحضارة.
لم يعودوا ينتظرون البرابرة.
لقد وصلوا.
دخلوا القاعة بربطات عنق، وجلسوا تحت القباب المذهّبة، وتعلّموا كيف يُلقون الخطب بلا أن ترتعش أصواتهم فوق أكوام الجثث.
ما كان كفافيس (قسطنطين كفافيس، شاعر يوناني حديث، اشتهر بقصيدته في انتظار البرابرة التي فضحت منطق الإمبراطوريات حين تخترع أعداءها) ،يكتبه بوصفه مفارقة شعرية، تحوّل في عصرنا إلى نشرة أخبار مسائية.
في العالم القديم، كان البرابرة يأتون من خارج الأسوار.
اليوم، هم داخلها، يكتبون القوانين، ويمنحون الأوسمة، ويُعرّفون لك معنى “الأمن” و“الدفاع عن النفس” و“القيم المشتركة”.
الفرق الوحيد أن السيف صار قراراً، والرمح صار طائرة مسيّرة، والدم… صار رقماً إحصائياً بارداً.
جون ماكسويل كويتزي (روائي جنوب أفريقي حائز نوبل)، حين كتب “انتظار البرابرة”، لم يكن يتنبأ، بل كان يدوّن محضر جلسة مبكرة من محاكم التفتيش الحديثة.
وسيرو جيرا (مخرج سينمائي إيطالي)، وهو يحوّل الرواية إلى فيلم، لم يضف خيالًا، بل أزال بعض الأقنعة السينمائية عن واقع أكثر فظاعة من أي شاشة.
الأنظمة لا تحب الحقيقة.
تحب عدواً.
عدواً واضح الملامح، سهل الشيطنة، صالحاً للاستهلاك الإعلامي.
فالخوف مادة خام ممتازة: تُطحن، تُعبّأ، وتُوزَّع على الجماهير مع نشرة الطقس.
وما دام هناك “برابرة” في الخارج، فلا أحد سيسأل: من سرق الخبز؟ من أشعل الحرب؟ ومن يحصي الأرباح؟
منذ زمن بعيد، فهم قرصانٌ مغمور ما لم يفهمه كثير من فلاسفة البلاط:
السرقة لا تتغيّر… الذي يتغيّر هو حجم السفينة.
لصٌّ بقارب يُعلَّق على مشنقة الأخلاق،
وإمبراطور بأسطول يُمنَح لقب “صانع سلام”.
نعوم تشومسكي (مفكّر ولساني أمريكي، من أبرز نقّاد الإمبريالية وخطابها الدعائي) لم يكن ساخراً حين قال إنهم يريدون منا أن نصدّق المستحيل؛
كان دقيقاً حدّ القسوة.
فاللغة، حين تقع في قبضة القوة، تتحول إلى أداة تعذيب ناعمة:
الاحتلال يصبح “نزاعاً”،
المجزرة “عملية نوعية”،
والضحية… “أضراراً جانبية”.
أن يقف قاتل جماعي ليلقي محاضرة عن الحضارة،
فهذا ليس نفاقاً عابراً،
بل ذروة المسرحية.
كمؤمِس تُلقي درساً في العفّة،
أو جلاد يشرح للضحية أهمية ضبط النفس.
التصفيق هنا ليس تفصيلًا.
التصفيق هو الجريمة المكتملة.
هو إعلان الإفلاس الأخلاقي،
وشهادة وفاة ما تبقّى من وهم العدالة الغربية،
ومن سردية المركز التي نصّبت نفسها مرآةً للإنسانية، بينما لا ترى فيها إلا صورتها.
المركزية الغربية لم تكن يوماً بريئة.
كانت دائماً ترى العالم بدرجات لون واحدة:
نحن… وهم.
العاقل… المتخلّف.
المتحضّر… القابل للقتل دون تأنيب ضمير.
وحين يظهر أدب من الأطراف، لا يُكافأ إلا إذا جلد نفسه،
وشتم تاريخه،
وقدّم مجتمعه كحفرة أبدية من القبح،
ليحصل على “شهادة حسن سلوك” من السيد الأبيض.
أما الحكايات الأخرى، تلك التي تتحدث عن مقاومة، وكرامة، وجمال يومي بسيط،
فلا تُترجم… لأنها تُربك الرواية الرسمية.
الفلاح اليمني الذي يدافع عن بيته إرهابي.
الفيتنامي الذي يحمي حقله متوحش.
الفلسطيني الذي يرمي حجراً مجرم.
أما الطائرة التي تمحو حياً كاملًا،
فهي “قلقة على أمنها”.
الدولة التي تركع تُسمّى مسؤولة.
والدولة التي ترفع رأسها تُدرج في قوائم سوداء.
القانون الدولي هنا يشبه عصاً مطاطية:
تُشدّ حيث تشاء القوة،
وتُترك مترهلة حيث تسكن الضحية.
اليمن نموذج فجّ:
صاروخ من فقراء الجنوب يهدد “الاقتصاد العالمي”،
وحصار شامل يمحو أطفالًا من الوجود يُسمّى “حماية الاستقرار”.
أي استقرار هذا الذي يُبنى من عظام؟
البربرية القديمة كانت تقتل.
هذا صحيح.
لكنها لم تكن تحتفل.
لم تكن تبتسم للكاميرا،
ولم تكن تكتب مذكرات عن “القيم”.
أما البربرية الحديثة،
فتقتل… وتستمتع.
تقتل… وتبرّر.
تقتل… ثم تمنح نفسها جائزة أخلاقية.
وهنا، بالضبط، يكمن الخطر.
ليس في عدد الضحايا،
بل في البرود الذي يُدار به الموت،
وفي الجماهير التي تعلّمت أن تصفّق،
لا أن تسأل.
لم نعد ننتظر البرابرة.
نحن نعيش عصرهم.
والسؤال الوحيد المتبقّي:
هل سنظلّ كومبارس في المسرحية،
أم سنكسر النصّ،
ونفسد العرض؟