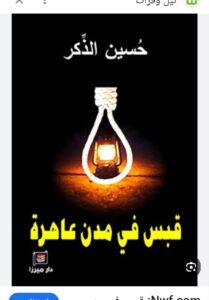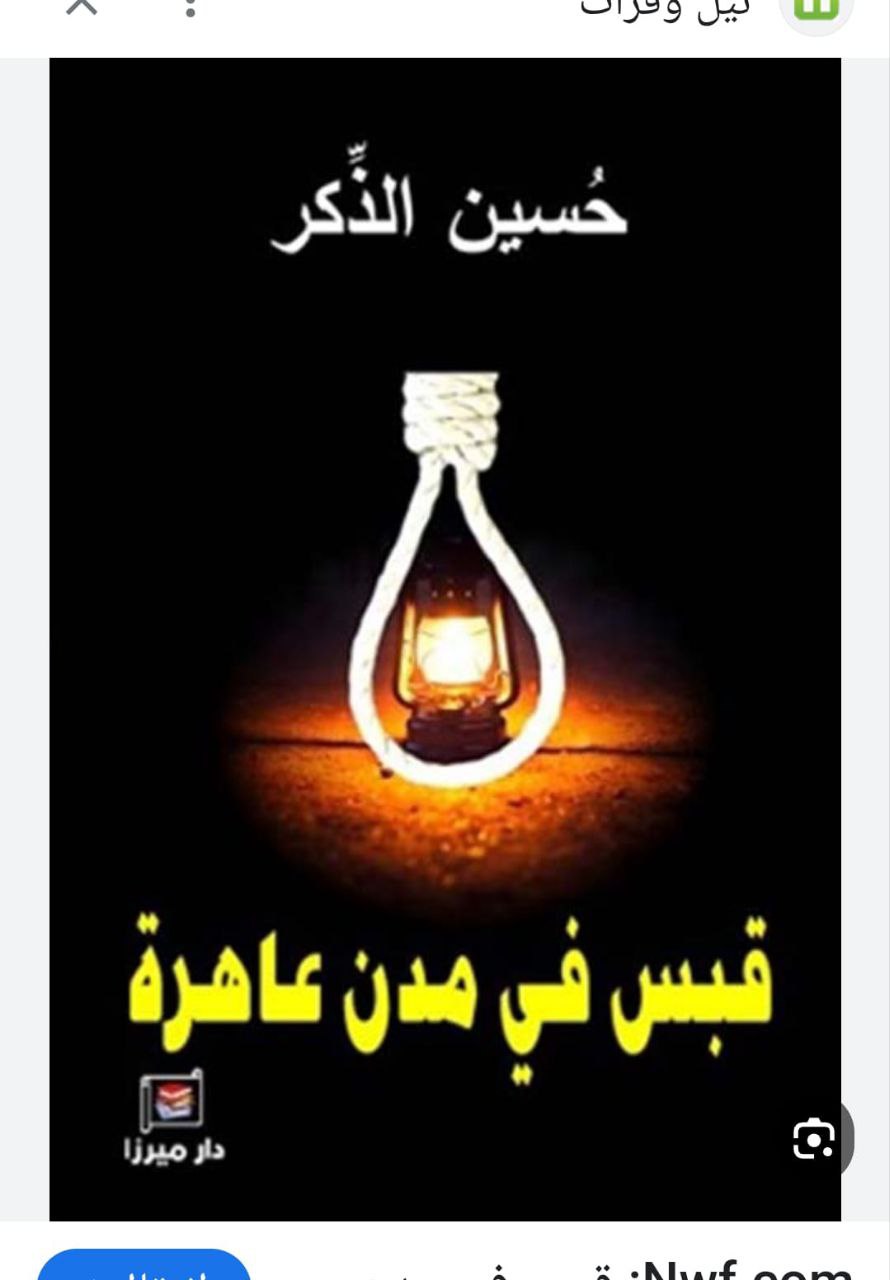اسم الكاتب :محمد جبريل – مصري –
الحقيقة التي يجب التأكيد عليها، عند النظر إلى أيّ مجتمع، سواء كان حديثاً وكامل التكوين والتبنين (صارت تحكمه علاقات بنيوية: طبقات مكتملة)، أو يتأرجح بين التقليدي والحداثي؛ هي أنّ النظام الاجتماعي عمل يُصنع ويُعاد صنعه باستمرار؛ أي إنّه، مثل كلّ عملية إنتاج، مسألة تكرارية، تأسيساً وتطويراً ونقضاً، وليس امتيازاً ميتافيزيقياً لأيّ شعب، ولا يعلو هذا النظام على شرطَي الزمن والتاريخ؛ فتأسيسه المتكرر حدث زمني بامتياز، ولا يحمل أيّة ضمانات غيبية لاستمراره كما هو.
إنّ بناء الأمة، مثل كلّ فعل بشري: محض إنتاج يخضع للآليات العاملة للإنتاج في أيّ مجتمع، ولمحدّداته المادية، ولا يتمّ بمجرد وعي القادة الفذّ، وإذا كانت السلطة هي من يضع الأطر العامة لبناء الأمة، فإنّ عملية البناء يسهم فيها المجتمع ككل: من أعلى بواسطة السلطة السياسية والإنتلجنسيا التي تدعمها وتمدّها بالكوادر والخبرات والرؤى والخطاب، ومن أسفل بواسطة المجتمع المدني الذي يخضع لمحددات اجتماعية واقتصادية متشابكة، وبواسطة الناس العاديين الذين يتفاعلون مع الأفكار والسياسات إيجاباً وسلباً.
كانت خطيئة النظام الملكي أنّه لم يستجب للتحولات الاجتماعية التي أطلقها بنفسه لذا فقد جوبه بمقاومة قادة الأحزاب الأيديولوجية ؛إنّ المعضلة الأكثر صعوبة التي تعيشها المجتمعات العربية؛ هي نقص الاندماج الاجتماعي، الذي تتمّ ترجمته في مستويات مختلفة: رفع الإجحاف التاريخي بحقّ طائفةٍ ما، الاعتراف بالحقوق الثقافية لعرق معيّن، الحصول على حصة متناسبة من السلطة، وأخيراً التمايز عن بقية مكونات المجتمع، هذه الأشكال جميعها هي ما نسميها: التفكّك الاجتماعي، والذي يشهد العراق أكثر أشكاله حدةً وجدية عن باقي المجتمعات العربية.
وفي هذا السياق؛ هناك ضرورة لتقليص التركيز على حادثة الغزو الأمريكي للعراق (2003)، التي تهيمن على جزء معتبر من الأدبيات التي تتناول تفكّك الدولة والمجتمع في العراق؛ فهي، وإن كانت تضع يدها على أسباب جدية للمأزق العراقي (فاقم الغزو التناقضات الموروثة وخلق تناقضات كارثية أخرى)، إلا أنّها تغفل العوامل الأكثر عمقاً على المستوى التاريخي في صياغة هذا الفشل.
كذلك سيكون الانسياق مع الأطروحات التي ترى في الغزو فعلاً هامشياً “فتح صندوق باندورا” (بتعبير الباحث شيركو كرمانج) على مشكلات العراق المتوطنة، انسياقاً مُضلّلاً؛ فقد كان (الغزو) عاملاً ضمن عوامل أكثر فاعلية في عملية التفكّك الوطني العراقي (فحلّ الجيش واستئصال البعث كان يعني عملياً طرد السنّة من العمليات السياسية التي أعقبت الاحتلال؛ بحكم سنّية الجيش والبعث، وهو ما ضاعف حدّة الانقسام بعد الغزو وصولاً إلى الحرب الأهلية 2006/2007).
وفي المقابل؛ يرى باحثون آخرون (أبرزهم ميثم الجنابي وفالح عبد الجبار)؛ أنّ صدام حسين هو الذي دمّر كلّ سمات الهوية الوطنية للعراق، على اعتبار أنّه كان بلداً علمانياً يعرّف مواطنوه عن أنفسهم؛ بأنّهم عراقيون، وليس بهوياتهم العرقية والدينية.
وهذا يتناقض مع الواقع التاريخي للعراق الذي، باستثناء الشيعة في الخمسينيات والستينيات (وفي إطار الحزب الشيوعي)، لم يعرّف مواطنوه أنفسهم بأنّهم عراقيون، وبالتالي سيكون إلقاء اللوم على صدام وحده بمثابة إعفاء مسيرة التكون التاريخي للأمة من أيّ عيوب أو نواقص، لذا يتطلب فهم الوضع الحالي للدولة والأمة في العراق العودة إلى تلك الجذور وتطورها وتحولاتها.
وفي سبيل الوصول لذلك؛ سيكون الحذر واجباً من السير خلف الأطروحات التي تميل إلى تضخيم دور الدولة في بناء الهوية الوطنية، مع وجوب الموازنة بين دورها ودور المجتمع المدني وإرادة الناس.
سردية اسمها العراق
ما تزال صورة العراق في بدء تأسيس الدولة، حين فرضت الإدارة الاستعمارية عليه النظام الملكي، عام 1921، بقيادة الملك فيصل بن الحسين، تتشابه، رغم التغييرات الكبرى التي عصفت بهذا البلد، مع صورته الحالية، فقد كانت الدولة الجديدة على درجة من الهشاشة؛ حيث لم يكن بإمكانها فرض سلطتها دونما عون من سلطة الاحتلال، وما تزال مقولة الملك فيصل بإمكانها أن تفسّر كثيراً من حالة العراق:
“إنّ البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية، ذلك هو الوحدة الفكرية والملية (القومية) والدينية؛ فهي والحالة هذه مبعثرة القوى، مقسمة على بعضها، يحتاج ساستها أن يكونوا حكماء مدبرين، وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنى”.
اتصفت عملية التوحيد وبناء الأمة في العراق، في عشرينيات القرن الماضي، باتّباع سياسات تكامل طوعية وأخرى قسرية؛ فمن خلال المؤسسات الوطنية: الجيش، المدارس، البيروقراطية، المدارس، تمّ دمج شتى الأطراف العرقية والطائفية في مجتمع أكبر بواسطة الحكومة المركزية.
وكما يقول حنا بطاطو، في ثلاثية “العراق” ج 1؛ فقد ساعد تطوّر وسائل النقل والمواصلات في تقليص حالة العزلة التاريخية بين المجموعات الحضرية والريفية؛ فخرجت المدن، التي كانت منغلقة على نفسها ومكتفية ذاتياً، من عزلتها السابقة، كي تعمل وتتفاعل مع فضاء وطني ناشئ، وكذلك الأمر مع الريف، فيما جذبت السلطة القبائل نحو الاستقرار، للمرة الأولى في تاريخها، عبر توزيع الأرض على زعمائها الذين تحوّلوا من شيوخ قبائل إلى مالكين للأراضي، لتميل الوحدة الأبوية المتراصة للقبيلة إلى الانهيار التدريجي.
ولعبت الدولة، من خلال سياساتها الاقتصادية، دوراً مهمّاً في التوحيد، فبوصفها مالكة للأرض؛ شرعت في توزيع الأراضي على شيوخ القبائل والقيادة العليا للجيش والبيروقراطية، كي تخلق قاعدة اجتماعية للدولة الوليدة، (الأمر نفسه أنجزه محمد علي في مصر في القرن التاسع عشر)، وبحسب فالح عبد الجبار، في “العمامة والأفندي”؛ فإنّ “رسملة” الإنتاج الاقتصادي (اقتصاد موجّه نحو السوق، وليس للاستهلاك العائلي)، ساهمت في تفكيك اقتصادات الكفاف المنعزلة، وفي إعادة ربط المناطق النائية والمنعزلة بالمركز: العاصمة.
أما الإجراءات القسرية؛ فقد تمثّلت في لجوء الدولة الوليدة في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين إلى شنّ حملات عسكرية واسعة وحاسمة ضدّ المتمردين الأكراد والآشوريين والإيزيديين والقبائل الشيعية في الجنوب، إلّا أنّ الدولة سرعان ما تحسّست كلفة هذا الإدماج القسري، لتبدأ رحلة التكامل الاقتصادي والتنموي المعزز بسياسات توحيدية قوامها توزيع السلطة الإدارية على الضباط والتجار والسادة والشيوخ مع مراعاة التوازن الإثني والطائفي، التي من خلالها استطاع النظام الملكي إعادة اللحمة بين الأجزاء النائية والمفككة وبين الدولة المركزية، ليحلّ بذلك المهمة الأساسية للدولة الوطنية: التحوّل من التشظّي الاجتماعي إلى المركزية.
لم يمضِ وقت طويل على عملية التكامل الوطني حتى برزت مجموعة من التناقضات في صلبها؛ إذ أدّت إلى خلق طبقات جديدة: أرستقراطية مالكي الأرض، كبار التجار، الطبقة الوسطى، نواة طبقة عمالية، فلاحين يعملون بالأجر، وفلاحين إلى شبه أقنان في أملاك السادة الجدد، وعمال هامشيين في المدن؛ لتصبح بمرور الوقت الثغرة الأكبر في جدار التوحيد الوطني هي استبعاد الطبقة الوسطى من العملية السياسية، واستبعاد الفلاحين والعمال من المنافع الاقتصادية للتنمية.
كانت خطيئة النظام الملكي؛ أنّه لم يستجب للتحولات الاجتماعية التي أطلقها بنفسه؛ لذا فقد جوبه بمقاومة عاصفة: حضرية/ ريفية، قادتها الأحزاب الأيديولوجية التي أسستها الطبقة الوسطى لتحقق مطالبها السياسية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي العملاق. ونظراً لفقدان الحسّ السياسي لدى قادة الدولة؛ فقد استمروا في الاعتماد على بريطانيا، كداعم أكبر في مواجهة دول الجوار وتمرّدات المجتمع، في وقت كانت فيه نزعات التحرر الوطني تعبّئ المنطقة وتمهّد لقلبها رأساً على عقب.
غير أنّ الأحزاب التي كانت بمثابة رأس الحربة في المعارضة، لم تستطع أن تترجم هيمنتها الأيديولوجية إلى سيطرة سياسية لأسباب تاريخية وسياسية معقّدة، بعضها محلّي وأكثرها عالمي، تاركة حسم مسألة السلطة لمجموعة نخبوية من الضباط المسيَّسين.
البندقية تُوحّد ولا تبني
استولى الضباط الراديكاليون على السلطة، في تموز (يوليو) 1958، ليقلبوا العلاقة بين الدولة والتشكيلات الاجتماعية رأساً على عقب؛ حيث أشرف الضباط على تدمير الطبقة الحاكمة القديمة وطبقة كبار الملاك، إلا أنّهم، في الوقت نفسه، ألغوا المؤسسات التشريعية، فاتحين الباب لمسيرة من الحكم العسكري؛ لتصبح السلطة التنفيذية صاحبة اليد الطولى في الحكم دون شريك تشريعي أو قضائي؛ ليتحول مصدر الشرعية السياسية التفويض الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع إلى وجاهة الأيديولوجيات الشعبوية وسحرها الخاص، ومع غياب أيّ شكل من أشكال المؤسسية السياسية أصبح العنف المُركز الأداة الحاسمة للحكم، وهو ما سيكون له أبلغ وأسوأ الأثر معاً في المراحل اللاحقة من عملية بناء الأمة.
استبعاد الفلاحين والعمال من المنافع الاقتصادية للتنمية
مثل كلّ أنظمة المرحلة، مرحلة التحرر الوطني في العالم الثالث، تمكّن الزعيم عبد الكريم قاسم من تحسين وضع الطبقة الوسطى وتلبية مصالحها الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنّه، وفق حنا بطاطو، أفرز خللاً في عمليات التكامل الوطني (بناء العراق كمجتمع سياسي)، ويفسّر بطاطو هذا الخلل في أنّ سلك الضباط (النخبة الحاكمة) كان يسيطر عليه تاريخياً الضباط العرب السنّة، بالتالي؛ جرى استبعاد الشيعة والأكراد من صيغة الحكم، وإطاحة مكتسبات تمثيل التنوع الإثني والديني للعراق، وهذا ما تفادته المرحلة الملكية، رغم عيوبها الكارثية.
ومثلما غيّر وصول الضباط الثوريين إلى السلطة من شكلها، فقد غيّر ظهور البترول من مضمون هذه السلطة أساساً؛ فلأنّ الدولة هي صاحبة السيطرة المطلقة على الثروة؛ فقد أصبحت، بحسب تحليل عبد الجبار، منقطعة عن عملية الإنتاج الاجتماعي للثروة، وبما أنّه جرى تحطيم كلّ المؤسسات السياسية (باستثناء مؤسسة الرئاسة، كما هو الحال في مصر الناصرية)، فلم يكن بإمكان القابضين على زمام الأمر أن يديروا المطالبات المتباينة والمتنافسة لشتى المجموعات، الإثنية والطائفية والطبقية، كما أصبح الوسيلة الوحيدة للتعبير عن التناقضات الاجتماعية/ الاقتصادية، والصراع على النفوذ والمكانة هي التآمر بين أحزاب ضالعة في العمل السرّي.
ومثل أيّة طبقة وسطى في حقبة التحرّر الوطني، دانت الطبقة الوسطى العراقية بالولاء للدولة، صاحبة الفضل في تكوينها أصلاً، وصاحبة الفضل الأكبر في صعود أفرادها الاجتماعي، وكان في ذلك مقتل العراق؛ إذ مالت كلّ أجنحتها للصراع على السيطرة على الدولة، وبقدر تبايُن الواقع الاجتماعي لهذه الطبقة بقدر ما تعددت الانقسامات الأيديولوجية والسياسية؛ بين الوطنية العراقية (التي تبنّاها الشيعة والحزب الشيوعي الذي أطر رؤاهم)، والقومية العربية (التي تبناها السنّة وضباطهم الراديكاليون)، والقومية الكردية، ثم النضالية الشيعية (بعد تضعضع الحزب الشيوعي)، ثم الأصولية السنّية أخيراً.
تميّز عهد عبد الكريم قاسم بخفوت النزعة القبلية (وفق شيركو كرمانج)، أو على الأقل لم تُترجم سياسياً في شبكة من العلاقات تدير الدولة وتوزّع الثروة، على عكس الأخوَين عارف، اللذين جاءا من بعده؛ حيث اخترقت النزعة القبلية صفوف العسكر؛ نتيجة عجز الروابط الأيديولوجية عن إضفاء حالة من الاستقرار على الدولة، ودمج أكبر قدر ممكن من السكان في الدولة، دون أن يكونوا شركاء أصلاء في إدارتها.
تميّز عهد عبد الكريم قاسم بخفوت النزعة القبلي
وبطبيعة الحال؛ تلاشت الأسس التي تقوم عليها السلطة السياسية؛ فلا هي دولة أيديولوجية وثورة وتبشير وراديكالية، ولا هي دولة دستور ومؤسسات وتمثيل شعبي، ولا تحكمها سلالة نبيلة؛ بل حفنة من الضباط المنقسمين على أنفسهم (كما تجلى في تكرار الانقلابات العسكرية آنذاك)، فكان لا بدّ من وضع أساس جديد وصلب (ودموي إذا تطلب الأمر) للسلطة: البعث.
عشيرة التحرّر الوطني!
باستثناء موقفه المخجل من التدخّل الأجنبي لإطاحة النظام، فإنّ كنعان مكية كان أفضل من كتب عن عراق صدام، سواء في “جمهورية الخوف”، أو في “القسوة والصمت”، ومكيّة وإن لم يكن مشغولاً بقضية الهوية والأمة في العراق، إلا أنّه كان أفضل من رسم الخطوط العامة والتفصيلية للسلطوية في عهد البعث، وما يهمّ في حالتنا هذه ليس الطابع الوحشي للسلطوية الذي شغل مكية، بل اعتمادها على إستراتيجية القسر والعنف، في أقصى أشكاله، في عملية التوحيد الوطني، وعدم فتحها أفقاً آخر غير الإخضاع المسلح للأطراف والجماعات الفرعية للسلطة المركزية.
فقد اختلف النظام الشمولي البعثي اختلافاً جذرياً عن كلٍّ من النظام الملكي التقليدي (شبه الليبرالي) والأنظمة العسكرية السلطوية التي تلته، وقد جاء على هيئة مزيج غير متجانس من النزعة الاشتراكية القومية والعلاقات والمفاهيم العصبوية.
ما منع النظام البعثي من أن يكون نازياً حقيقياً هو افتقار العراق إلى طبقات اجتماعية ناضجة ومتبلورة
احتفظ الوجه الأول (الشعبوية ذات المنحى الاشتراكي) بكلّ خصائص الأنظمة الشبيهة في العالم آنذاك، ومعظمها استُوحيَ من الاتّحاد السوفييتي: حكم الحزب الواحد (الحزب القائد للدولة والمجتمع)، بالتالي؛ احتكار السياسة، ونموّ بيروقراطية الدولة، وتضخم القوات العسكرية والأمنية، ومركزة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالكامل، في يد هيئة سياسية ذاتية التعيين “هيئة قيادة الثورة” (وهي شكل سياسي موروث من الخمسينيات، عمّمته مصر الناصرية)، والسيطرة على معظم ميادين الإنتاج وتوزيع الثروة، والهيمنة على الثقافة بأشكالها كافة: (التعليم، الصحافة، النشر)، وابتلاع المجتمع المدني: (النقابات العمالية والمهنية، الجمعيات، النوادي، اتحادات رجال الأعمال، الغرف التجارية) في جوف النظام، هذه العمليات جميعها هي ما أطلق عليها نزيه الأيوبي تعبير “تضخيم الدولة العربية”.
لكن، وفق فالح عبد الجبار؛ فإنّ الحكم البعثي، من حيث الأيديولوجيا الشمولية والاقتصاد المركزي والوحدة الوطنية الممثلة في الزعيم، وليس في مؤسسات الدولة، والقمع المفرط ضدّ الأقليات القومية والدينية، تشابه كثيراً مع النموذج الألماني الشمولي النازي، لا أنظمة التحرر الوطني التي جاء بعد انزياحها (لم يفقد كادر بعثي واحد حياته في سبيل الاستقلال)، فيما احتفظ الوجه الآخر للنظام (حكم العشيرة) بكلّ خصائص نموذج حكم العائلة.
ما منع النظام البعثي من أن يكون نازياً حقيقياً؛ هو افتقار العراق إلى التبنين الطبقي، أو إلى طبقات اجتماعية ناضجة ومتبلورة، وإلى الملكية الخاصة والمصالح الكبرى المستقلة عن الدولة، فضلاً عن حداثة تكوين الدولة الوطنية والمجتمع الموحّد سياسياً فيه، ومن ثمّ أعطى هذا التمازج الفريد للنزعتَين؛ القبلية والجماهيرية الشعبوية، للدولة العراقية فُرادة سياسية لم يعرفها بلد آخر في العالم!