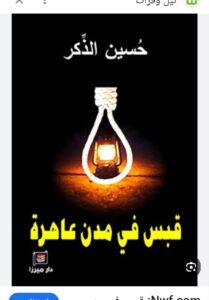الكاتب : فاضل حسن شريف
جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تبارك وتعالى “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (الأنعام 108) “ولا تسبوا الذين يدعون” ـهم “من دون الله” أي الأصنام “فيسبوا الله عدْوا” اعتداء وظلما “بغير علم” أي جهلا منهم بالله، “كذلك” كما زيَّنا لهؤلاء ما هم عليه “زيَّنا لكل أمة عملهم” من الخير والشر فأتوه، “ثم إلى ربهم مرجعهم” في الآخرة “فينبِّئهم بما كانوا يعلمون” فيجازيهم به.
عن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تبارك وتعالى “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” ﴿الأنعام 108﴾ قالوا: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فيجيبهم الكفار بسب اللَّه جل ثناؤه، وهذا القول ليس ببعيد، فكثيرا ما يقع ذلك بين المختلفين في الدين، ولفظ الآية لا يأباه، بل روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله: ان الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلماء؟. قال: كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون اللَّه، فكان المشركون يسبون من يعبد المؤمنون، فنهى المؤمنين عن سب آلهتهم لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين، فكأنّ المؤمنين قد أشركوا من حيث لا يعلمون.. وقوله تعالى: بغير علم. إشارة إلى جهالة المشركين وسفاهتهم. وفي الآية دلالة واضحة على ان ما كان ضره أكثر من نفعه فهو محرم، وان اللَّه لا يطاع من حيث يعصى. “كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ”. المعنى الظاهر من هذه الجملة ان اللَّه سبحانه كما زين للمسلمين أعمالهم كذلك زين لغيرهم أعمالهم، حتى المشركين.. وليس من شك ان هذا المعنى غير مراد، لأن الشيطان هو الذي يزين للمشركين والعاصين الشرك والعصيان بنص الآية 43 من الأنعام: “وزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ”. بالإضافة إلى أن اللَّه سبحانه لا يأمر عبده بالكفر ويزينه إليه، ثم يعاقبه عليه، بل العكس هو الصحيح، قال تعالى: “ولكِنَّ اللَّهً حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمانَ وزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكَرَّهً إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والْفُسُوقَ والْعِصْيانَ” (الحجرات 7). ومن أجل هذا نرجح حمل الآية على ان اللَّه خلق الإنسان على حال يستحسن معها ما يأتيه من أعمال، ويجري عليه من عادات، ووهبه عقلا يميز به بين الأعمال الحسنة والقبيحة، ولو خلقه على حال يستقبح معها جميع أعماله لما عمل شيئا.. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: “زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ” تماما كمعنى قوله: “كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ” (المؤمنون 53). وقولنا: كل انسان راض عن عمله. “ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ”. إذن، فليدع المؤمنون سب آلهة المشركين ما دام اللَّه سيعاقبهم عليه. وتسأل: ان من سب اللَّه أو رسوله يجب قتله، وهذه الآية تشعر بأن أمره متروك إلى حسابه وعذابه يوم القيامة؟. الجواب: إن هذه الآية نزلت بمكة يوم كان المسلمون ضعافا لم يؤذن لهم بقتال، لأن القتال كان آنذاك بالنسبة إليهم أشبه بعملية الانتحار، أما مع قوة الإسلام وسلطانه فيجب تنفيذ حكم الإعدام بالساب، ولا يجوز وقفه وتعطيله.
عن المركز الاسترتيجي للدراسات الاسلامية التحديد المفاهيمي لمصطلحيّ الأمّة والمُواطَنة للسيد صادق عباس الموسوي: أن الأُمَّـة مجموعة من الناس تحمل رسالة حضاريّة إلهيّة، وتعيش طبقاً لمبادئ هذه الرسالة، وتظلّ تحمل سِمَة الأُمَّـة ما دامت تحمل هذه الصفات، والعنصر الأساسيّ فيها هو عنصر الرسالة التي تحاول الجماعة تقديمها إلى الآخرين لإتِّباعِها، كما لا يشُتَرط في العنصر البشريّ ـ المكوِّن للأُمَّةـ الروابط الدمويّة أو الجغرافيّة ولا الكمّ العددي, فقد يكون هذا العنصر فرداً أو فئة أو جماعة ما دامت تحمل رسالة ويوحِّدها فقهٌ شامل لهذه الرسالة. لكن لو تتَّبعنا أكثرَ النصوص، فسنجد أنّ إستعمَال الدال في المدلول المذكور ليس مُطَّرداً، إنّما قد استُعمِلَ للدلالة عن الدّين في خصوص الدّين الإسلامي، حيث أنّه دين أقام دولة وأنشأ حضارة وثقافة موحّدة بين أقوام متشّعبين وأفرادٍ متنوعين وألسنٍ مختلفة. فقلّما نجد استعمَالاً لهذا المفرد لتوصيف ديانات أُخَر، فلم يكن يُقال أُمَّة النصارى ولا أُمَّة اليهود ولا أُمَّة الصابئة، إلاّ نادراً، مثل استعمَال ابن خلدون للمصطلح مرَّة واحدة على بني إسرائيل ولكن يعود ذلك لالتباس المفهوم عنده كما سيأتي. لذلك يمكن الاستنتاج أنّ الأُمَّـة بمعنى الدين استُعمِلَ في الإسلام خاصّة، يَدُّلُ على ذلك أنّ القدماء كانوا يعتمدون على إطلاق هذا المصطلح لبداهة انطباقه على الإسلام، فنادراً ما نجدُ استعمَالاَ مقيّداً لهذا النص، لكن عندما تداعت الدُوَل على المُسلِمين وعانوا من اهتراءٍ في حضارتهم أصبح يُقيَّد بكلمة الإسلاميِّة، فأصبح المصطلح المطلق مقيّداً بطريقة تعدُّد الدال والمدلول. وإذا ما رجعنا إلى النصوص القديمة فقد كان استعمَاله كما ذكرنا، ولكن قد يُستعمل في معانٍ أُخَر بعد أن يقيَّد، فيُقال أُمَّة اليونان مثلاً، وهذا الاستعمَال في فترة متأخّرة نسبيّاً. هذا الأمر يقودنا للإشارة إلى مفردة أخرى استُعمِلَها المُسلِمون والعرب الدلالة على أصل الديانات الأخرى، وهي المِلَّة. والمِلَّة في القُرآن هي الدّينُ وشعائرُه، فمِلَّة إبراهيم عنَت دين إبراهيم. وأتباع كلِّ دين بمقتضى هذا يشكِّلون مِلَّة بحد ذاتها: مِلَّة النصارى، مِلَّة اليهود، مِلَّة المُسلِمين. وقد استُعمِلَ هذا المصطلح قديماً للدلالة على أتباع الديانات الأخرى، وفي الحديث لا يتوارث أهل ملّتين، أي أهل ديانتين. وهي في اللغة الشريعة والدين). ولأنَّ المصطلحَ استُعمِلَ قديماً للدلالة على أتباع الديانات الأخرى، فإن كُتَّّاب القرن التاسع عشر من المُسلِمين كانوا يميلون لاستعمَاله للدلالة على الدولة والأُمَم والشعوب غير المُسلِمة أكثر من استعمَالهم لمفرد الأُمَّـة الذي ارتبط في أزمانهم بدرجة أو بأخرى بالأُمَّـة الإسلاميِّة. لكن بمقاربة بعض النصوص نجدُ تصنيفاً آخر، أكثرَ قِدَماً، فابن خلدون الذي التبس عنده مفهوم الأُمَّـة يستعمل مفردة المِلَّة في أتباع الديانات سواء كانت إسلاميِّة أم غيرها، فيقول (المِلَّة الإسلاميِّة لمّا كان الجهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين الإسلام طوعاً أو كرهاً اتَّحدَت فيها الخلافةُ والملك) حيث يَستعملُ كلمة المِلَّة للدلالة على الديانة الإسلاميِّة. وكذا الفارابي حيث يعتبر أنّ المِلَّة والدّين يكادا يكونان اسمين مترادفين وكذلك الشريعة والسنّة فإنّ هذين إنّما يدُّلان ويقعان عند الأكثر على الأفعال المقدّرة من المِلَّة. ويعتبر (الدكتور ناصيف نصّار) أنّ الإزدواجيّة في مفهوم الأُمَّـة وضرورة اعتبار جوانب أُخرى غير الدّين أو المذهب في تكوين الجماعات البشريّة وفي تمييزها بعضها عن بعض حمل بعض المؤرّخين والفلاسفة في المائة الثانية من تاريخ الخلافة العباسيّة كالمسعوديّ والفارابي على فكِّ الازدواجية أي استعمَال لفظة المُسلِمة أو لفظة الشيعة للدلالة على المعنى الدّيني وعلى استعمَال لفظة الأُمَّـة بالمعنى الاجتماعيّ التاريخيّ. لكن رغم استعمَالات بعض المؤرّخين فيما ذكره (الدكتور نصّار)، فإنّه يظهر في نصوص المُسلِمين وخلفيَّاتهم الفكريّة توجُّهاً لاستعمَالِ كلمة الأُمَّـة في خصوصِ المُسلِمين، سواء كانوا أهلَ ديانةٍ واحدةٍ أم أهلَ حُكم واحد، واستعمَال مفردة المِلَّة في ديانات غير المُسلِمين كونها أكثر دلالةً. نعم، يظهر استعمَال لفظة المِلَّة عند الحديث عن الدِّين الإسلاميّ كشريعة وفقه ورسالة، ولا يُطلق على المُسلِمين كجماعةٍ وشعبٍ وسلطةٍ ودولةٍ. ومن المعروف أنّ العثمانيين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر استخدموا مفرد (ملّت) للدلالة على طوائف رعاياهم المختلفة والتي تمتّعت في نطاق نظام الملل باستقلال ذاتيّ نسبيّ، لكنَّ هذا المصطلحَ خرجَ من الاستعمَال السياسِّي تماماً في الربع الأوّل من القرن العشرين.
وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تبارك وتعالى “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” ﴿الأنعام 108﴾ اللذائذ أمور زينت بها هذه الأعمال ومتعلقاتها، وقد سخر الله سبحانه بها الإنسان فهو يوقع الأفعال ويتوخى الأعمال لأجلها، وبتحققها يتحقق الغايات الإلهية والأغراض التكوينية كبقاء الشخص، ودوام النسل، ولو لا ما في الأكل والشرب والنكاح من اللذة المطلوبة لم يكن الإنسان ليتعب نفسه بهذه الحركات الشاقة المتعبة لجسمه والثقيلة على روحه فاختل بذلك نظام الحياة، وفنى الشخص، وانقطع النسل فانقرض النوع، وبطلت حكمة التكوين بلا ريب في ذلك. وما كان من هذه الزينة طبيعية مغروزة في طبائع الأشياء كالطعوم اللذيذة التي في أنواع الأغذية ولذة النكاح فهي مستندة إلى الخلقة منسوبة إلى الله سبحانه واقعة في طريق سوق الأشياء إلى غاياتها التكوينية، ولا سائق لها إليها إلا الله سبحانه فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وما كان منها لذة فكرية تصلح حياة الإنسان في دنياه ولا تضره في آخرته فهي منسوبة أيضا إلى الله سبحانه لأنها ناشئة عن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال تعالى: “حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ” (الحجرات 7). وما كان منها لذة فكرية توافق الهوى وتشقي في الأخرى والأولى بإبطال العبودية وإفساد الحياة الطيبة فهي لذة منحرفة عن طريق الفطرة السليمة فإن الفطرة هي الخلقة الإلهية التي نظمها الله بحيث تسلك إلى السعادة والأحكام الناشئة منها والأفكار المنبعثة منها لا تخالف أصلها الباعث لها فإذا خالفت الفطرة ولم تؤمن السعادة فليست بالمترشحة منها بل إنما نشأت من نزعة شيطانية وعثرة نفسانية فهي منسوبة إلى الشيطان كاللذائذ الوهمية الشيطانية التي في الفسوق بأنواعه من حيث إنه فسوق فإنها زينة منسوبة إلى الشيطان غير منسوبة إلى الله سبحانه إلا بالإذن قال تعالى حكاية عن قول إبليس: “لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ” (الحجر 39) وقال تعالى: “فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ” (النحل 63). أما أنها لا تنسب إلى الله سبحانه بلا واسطة فإنه تعالى هو الذي نظم نظام التكوين فساق الأشياء فيه إلى غاياتها وهداها إلى سعادتها ثم فرع على فطرة الإنسان الكونية السليمة عقائد وآراء فكرية يبني عليها أعماله فتسعده وتحفظه عن الشقاء و خيبة المسعى، وجلت ساحته عز اسمه أن يعود فيأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف ويبعث إلى كل قبيح شنيع فيأمر الناس جميعا بالحسن والقبيح معا وينهى الناس جميعا عن القبيح والحسن معا فيختل بذلك نظام التكليف والتشريع ثم الثواب والعقاب ثم يصف الدين الذي هذه صفته بأنه دين قيم فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة بريئة من هذا التناقض وأمثاله متأبية مستنكفة من أن ينسب إليها ما تعده من السفه والعتاهية. فإن قلت: ما المانع من أن تنسب الدعوة إلى الطاعة والمعصية إليه تعالى بمعنى أن النفوس التي تزينت بالتقوى وتجهزت بسريرة صالحة يبعثها الله إلى الطاعة والعمل الصالح، والنفوس التي تلوثت بقذارة الفسوق واكتست بخباثة الباطن يدعوها الله سبحانه إلى الفجور والفسق بحسب اختلاف استعداداتها فالداعي إلى الخير والشر والباعث إلى الطاعة والمعصية جميعا هو الله سبحانه. قلت: هذا نظر آخر غير النظر الذي كنا نبحث عنه وهذا هو النظر في الطاعة والمعصية من حيث توسيط أسباب متخللة بينهما وبينه تعالى فلا شك أن الحالات الحسنة أو السيئة النفسانية لها دخل في تحقق ما يناسبها من الطاعات أو المعاصي، وعلى تقديرها تنسب الطاعة والمعصية إليها بلا واسطة وإلى الله سبحانه بالإذن فالله سبحانه هو الذي أذن لكل سبب أن يتسبب إلى مسببه.