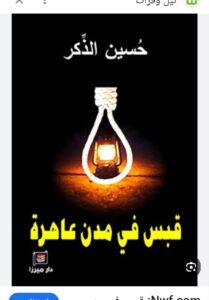فاضل حسن شريف
جاء في کتاب تفسير سورة هل أتى للسيد جعفر مرتضى العاملي: يستطرد السيد العاملي في كتابه قائلا عن الخوف: هذا الخوف يكشف عن أن كل تلك المراحل قد كانت سليمة، خالية من أي ضعف، قادرة على التأثير. وقد أثرت بالفعل. بل إن ثبوت وصف الخوف، لهؤلاء الصفوة الأبرار، خصوصاً إذا كان شاملاً لكل موارد احتمال التكليف والمسؤولية. يجعله في عداد ما يمكن الاستدلال به على عصمتهم الشاملة، خصوصاً إذا انضم إلى سائر الأوصاف المذكورة قبله وبعده، كقوله تعالى: “يُوفُونَ بِالْنَذْرِ” (الإنسان 7). وقوله: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ” (الانسان 8) لأن ذلك كله يدل على أنهم قد بلغوا في إنسانيتهم أسمى الغايات، وفي إيمانهم أعلى الدرجات.. بل هم قد تجاوزوا حدود العصمة كما سيتضح في شرح قوله تعالى: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّه مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً” (الانسان 8). إن شاء الله تعالى. وقد قال تعالى: “يَخَافُونَ يَوْمَاً” (الإنسان 7) ولم يقل: من يوم. فلماذا؟ وما هو الفرق؟ والجواب هو: أنك إذا قلت: يخافون من يوم، فيحتمل أن يكون خوفهم من أعمالهم، لأجل أن العدل يجري عليهم في ذلك اليوم. ويحتمل أيضاً: أن يكون نفس اليوم مخيف، من حيث هو زمان، وأن العذاب والمصائب، تكمن في عمق ذاته، وحقيقة وجوده. تماماً كما يخاف الإنسان من الأسد المفترس، فإن الشر كامن في ذات الأسد. ولا يفرق الأسد بين أحد من الناس، مع أن المخيف في ذلك اليوم هو تلك الأمور الهائلة، التي جعلها الله فيه، مثل نار جهنم وزفراتها، وأهوال يوم القيامة. ثم إنه قد جعل الخوف متعلقاً باليوم، فقال: “يَخَافُونَ يَوْمَاً” (الإنسان 7)، ولم يقل: يخافون من الله. فلعل سبب ذلك هو أن الله سبحانه رحيم بعباده، ولا خوف من الرحيم.وهو نفسه عز وجل، قد جعل الكلمة التي يطلب الابتداء بها في كل شيء هي: “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ”. والله تعالى لا يظلم أحداً، فلا معنى للخوف منه، بل الناس إنما يخافون من سيئات أعمالهم التي ستظهر وتتجسد لهم في ذلك اليوم، على شكل عذاب، وحرمان من مقامات القرب والرضا. أما قوله تعالى: “وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ” (آل عمران 28)، فلا ينافي رحيميته، ورؤوفيته.. فإنه إنما جاء لبيان سوء عملهم من حيث إن فيه إظهاراً للاستخفاف بمقام العزة الإلهية، فذكرهم الله سبحانه بنفسه، وأنه لا يعجزه باغ ولا طاغ، وأن بغيهم إنما هو على أنفسهم.
وعن مناشىء الخوف يقول السيد جعفر مرتضى العاملي: وإن للخوف بمعنى الانفعال النفساني مناشئ ومحركات مختلفة. فقد يكون مبعث الخوف هو النفس الأمارة بالسوء، كالذي يخشى فوات فرصة التلذذ بالجنس، فيقدم على الزنى، وقد يكون مبعثه التحرز من التعرض للأذى بعد ارتكاب جريمة مَّا. كالسارق الذي يخاف من انكشاف أمره، وملاحقته بالعقوبة. وقد يكون الباعث على الخوف هو النفس اللوامة.. كمن يخاف من غلبة دواعي الهوى عليه. مع سعيه للتخلص منها. وقد يكون الباعث له هو النفس المطمئنة التي تبحث عن الخير، وتخاف من فواته منها، كمن يخشى فوات فرصة الحج، أو نحو ذلك. فالحالة الشعورية التي هي انفعال وخشية نفسانية موجودة في هذه الموارد على نحوٍ واحد. ولذلك جاء التحديد لمنشأ الخوف لدى الأبرار في الآية الشريفة، حيث قال تعالى: “يَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً” (الانسان 7). أن الخوف الذي نفاه الإمام علي عليه السلام عن نفسه، دون أن يسجل ذماً صريحاً له، هو الخوف من العقوبة و مواجهة الآلام، بحيث يكون ذلك منشأ وأساساً، وباعثاً على العبادة. قال تعالى: “كَانَ شَرُّهُ” (الانسان 7) فلماذا جاء بلفظ (كان)؟ ولماذا أيضاً جاء فعل الكون بصيغة الماضي، لا المضارع. وقد يكون الجواب على السؤال الأول هو: أن الإتيان بلفظ كان، يهدف إلى التأكيد على تحقق هذا الأمر، وحصوله. فلا محل للبداء في هذا القرار الإلهي. فإننا نقول أيضاً: إنه لا معنى للزمان في علم الله سبحانه، فإن علمه بالمستقبل وحضوره لديه، هو على حد علمه تعالى بما مضى. وهذا ما ربما يوضح لنا قوله تعالى: “وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ” (التوبة 49) جاء بها بصيغة الإثبات، ولم يلحظ فيها واقع الزمان، وأنه في المستقبل، حيث لم يقل سبحانه: إنها ستحيط.. وكذا الحال بالنسبة لقوله تعالى: “إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً * وَنَرَاهُ قَرِيباً” (المعارج 6-7)، وغير ذلك. قال تعالى: “كَانَ شَرُّهُ” (الانسان 7) فعبّر بالشر، ولم يقل: عذابه مثلاً، أو مصائبه، أو نحو ذلك.
قال الله تعالى “فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ” (الانسان 11) يقول السيد العاملي في كتابه فالخوف من اليوم الذي فيه الشر، لكن الوقاية تعلقت بالشر مباشرة، فلماذا هذا التنوع في التعبير يا ترى؟ ونقول: لعل سبب هذا التنوع التعبيري هو: أن الذي لا بد أن يواجهه الأبرار هو نفس ذلك اليوم. ولكن ليس بالضرورة أن ينالهم شره، إذ إنهم قد يتمكنون من التحرز من شروره بالأعمال الصالحة، أو بوقايةٍ منه تعالى لهم، قد استحقوها. فهم يخافون يوماً قادماً عليهم، ويعرفون أن فيه شروراً ومحاذير. ولكن ليس بالضرورة أن يلحقهم من تلك الشرور شيء بسبب وقاية الله تعالى لهم منها. فلا محذور في التعبير هنا بقوله: “يَخَافُونَ يَوْماً” (الانسان 7). ثم يقول تعالى: “فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ” (الانسان 11). ثم إنه تعالى يصف ذلك الشر بقوله: “مُسْتَطِيرَاً” أي يتطلّب أن يطير، وأن ينتقل من مكان إلى مكان.. وهذا التعبير يشير إلى سرعة في الانتقال من جهة. وإلى تطلُّب هذا الانتقال، والسعي إليه، من جهة أخرى. وقوله تعالى “فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ” (الانسان 11). أي أوجد ما يحجز عنهم ذلك الشر، ويمنعه من الوصول إليهم. ولم يقل تعالى: إنه قد أزال الشر، وأبطل وجوده. كما أنه لم يقل: وقاهم من شر، لأن هذا التعبير إنما يعني أن الشر آت إليهم، وهو قد منعه من الوصول إليهم، وحال بينهم وبينه. وذلك يستبطن أمراً باطلاً، وهو: أن ثمة معاص لدى الأبرار، اقتضت وصول الشر إليهم، لكن التفضل والعفو الإلهي قد حال دون ذلك. مع أن الله تعالى لا يريد ذلك جزماً. ولذلك قال: “فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ” (الانسان 11)، دون أن يأتي بكلمة ( من ) إذ إن أعمالهم لم تتسبب في إثارة الشر. ولم توجد أسباب استطارته، بل إن ورعهم وتقواهم قد منع من توجهه إليهم من الأساس. فهو لا يصل إلى مكان وجودهم، ولا يطير إليها. فهم محفوظون منه بأعمالهم، بل إن أعمالهم هي التي تخمده وتزيله، وتطفىء ثائرته.
قال الله تعالى “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً” (الانسان 8) يقول السيد العاملي في كتابه: وقد أجملت الآية السابقة حال الأبرار، وأنهم يوفون بالنذر، ثم جاءت هذه الآية لتذكر شاهداً تفصيلياً، ولتكون شاهداً حياً على ذلك الوفاء، وعلى تأصل حالة البر والأبرارية فيهم. وهذا الشاهد هو قضية إطعام المسكين، واليتيم، والأسير. حادثة الإطعام: حادثة الإطعام: وقد ذكرنا في أوائل هذا الكتاب أن هذه الآية بالذات قد ذكرت الحادثة التي كانت سبب نزول السورة بأكملها. وهي باختصار شديد: أن الحسنين عليهما السلام مرضا، فنذروا صيام ثلاثة أيام إذا شافاهما الله سبحانه. وبعد شفائهما أرادوا الوفاء بالنذر، فصام الجميع حتى الحسنان عليهما السلام ولم يكن عندهم طعام سوى أقراص شعير هيأتها الزهراء عليها السلام للإفطار، فلما أرادوا الشروع جاءهم مسكين فأعطوه ما هيأوه، وأفطروا على ماء، وباتوا بدون طعام، وأصبحوا صياماً. فلما حضر إفطار اليوم الثاني، جاءهم يتيم فأعطوه أيضاً ما هيأوه، وطووا ليلتهم كسابقتها، وأصبحوا صياماً. وفي اليوم الثالث جاءهم أسير، فأعطوه طعامهم، وباتوا بدون طعام. غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وشاهد صلى الله عليه وآله حالهم، فنزلت السورة في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم. بدايةً نشير إلى أن من يلاحظ آيات السورة المباركة، سيجد قضية الصيام والإطعام قد ذكرت في السورة مرتين: أولاهما: على سبيل الإجمال، وذلك حين أشار إليها تعالى بقوله: “يُوفُونَ بِالنَّذْرِ” (الانسان 7)، وهذه القضية هي التي كانت وفاءً بالنذر، فهي من مصاديق تلك الآية. الثانية: حين ذكرها تعالى تفصيلاً هنا بقوله: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً” (الانسان 8). “وَيُطعِمُونَ” لقد بدأت الآية المباركة بكلمة: يطعمون. لم يقل سبحانه: يعطون الطعام: قد يقال: إنه يظهر من الروايات، أن ما حصل، إنما هو إعطاء الطعام. أن إعطاء الطعام لا ينافي أن يكون الآخذ قد أكل ذلك الطعام أمام أعينهم، فالذي حصل فعلاً وإن كان هو الإعطاء، والمناولة لكنه انتهى بالإطعام. (يُطْعِمُونَ)، لا بصيغة الماضي، فلم يقل: (أطعموا إنما جاء ليفهمنا: أن هذا الإطعام يستمر، ويتجدد بإرادة، والتفات، واختيار، ومبادرة منهم.