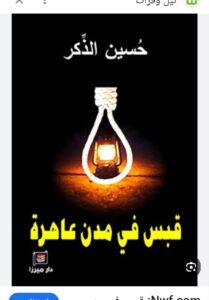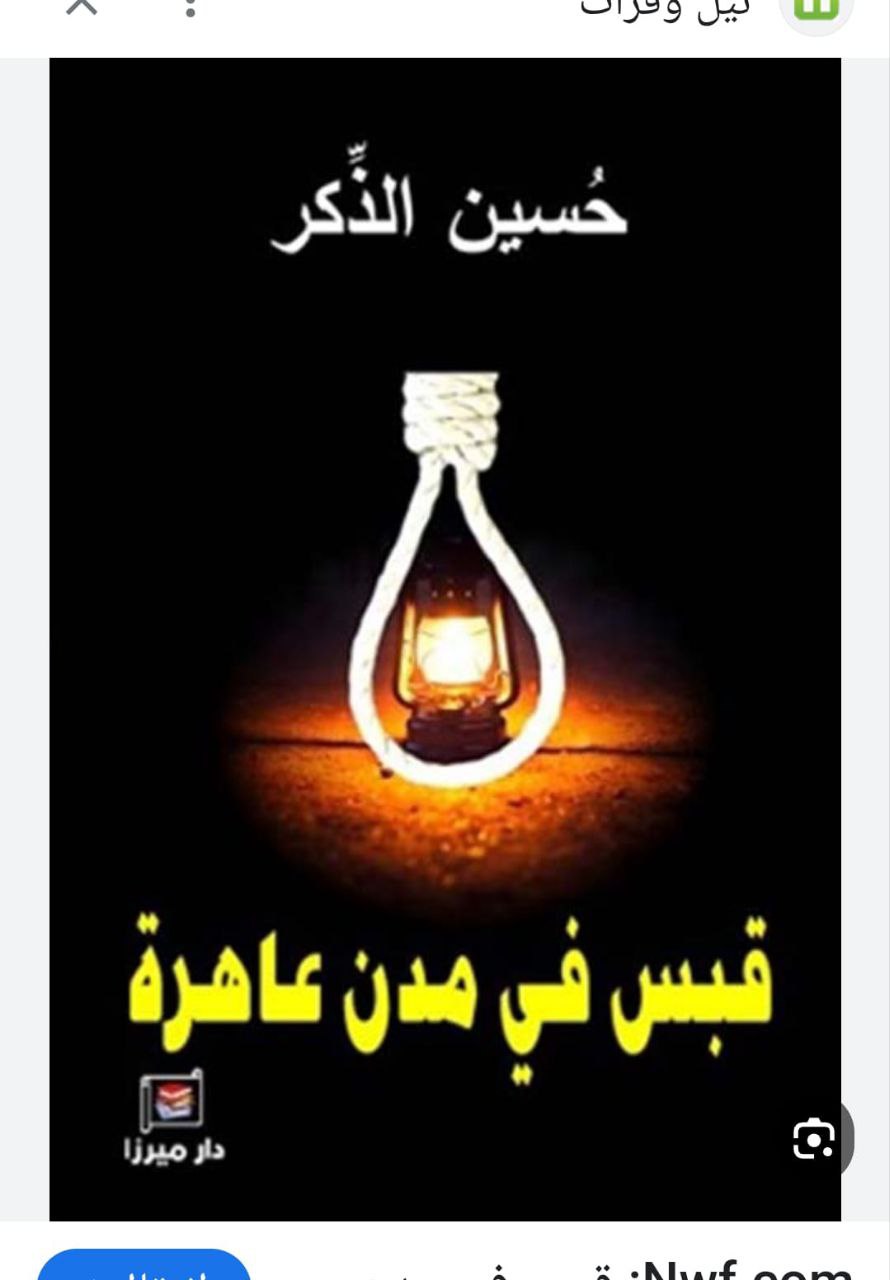د. فاضل حسن شريف
عن مجلة البيان بدائع (التكرار) في القرآن المجيد للكاتب محمد عبد الشافي القوصي: نعم، لقد نزل القرآنُ بلسان العرب، ومِن مذاهبهم التكرار للتأكيد والإفهام، أوْ للتذكير بالنِّعم، أوْ لدلائل الإعجاز. وقد جاء التكرار في نظْم القُرآن على عدة صور، منها: تكرار أداة تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن تستوفي ركنيْها الأساسييْن: مثل قوله تعالى: “ثُمَّ إنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ” (النحل 110)، فقد تكرَّرت (إنَّ) في الآية مرتيْن، وكان من الممكن الاكتفاء بـ (إنَّ) الأولى، ولكن لـمَّا طال الفصل بينها وبين خبرها “لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ”، كُرِّرت “إنَّ” مرة ثانية، حتى لا يتنافى طول الفصل مع الغرض المسوقة له (إنَّ) وهو التوكيد، فاقتضت البلاغة تكرارها لتلحظ النسبة بين ركني الجملة على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد. يقول الزركشي: (وحقيقته إعادة اللفظ أوْ مرادفه لتقرير معنى، خشية تناسي الأول لطول العهد به). ومن هذه الصور أيضاً: تكرار (حرف الجر) كما في قوله تعالى: “وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ” (البقرة 8). فقد أعاد المولى سبحانه (الباء) مع حرف العطف في قوله: “وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ”، وهذا لا يكون إلاَّ للتوكيد، وليس في القُرآن غير هذا الموضع. والسرُّ في ذلك: أنَّ هذا حكاية لكلام المنافقين، وهم أكدوا كلامهم نفياً للريْبة وإبعاداً للتهمة، فكانوا في ذلك كما قيل: (يكاد المريبُ يقول: خُذوني) فنفَى اللهُ الإيمانَ عنهم بأوكد الألفاظ، فقال: “وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ”. وذلك حينما جاء بضمير الجمع للغائب “هُم” مسبوقاً بالنفي، فأخرج ذواتهم وأنفسهم من طوائف المؤمنين، وجاء الإيمان مطلقاً كأنه قال: ليسوا من الإيمان في شيء قط، لا من الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولا من الإيمان بغيرهما.
جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” (التوبة 29) أهل الكتاب هم اليهود والنصارى على ما يستفاد من آيات كثيرة من القرآن الكريم وكذا المجوس على ما يشعر أو يدل عليه قوله تعالى: “إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد” (الحج 17) حيث عدوا في الآية مع سائر أرباب النحل السماوية في قبال الذين أشركوا، والصابئون كما تقدم طائفة من المجوس صبوا إلى دين اليهود فاتخذوا طريقا بين الطريقين. والسياق يدل على أن لفظة “من” في قوله: “من الذين أوتوا الكتاب” بيانية لا تبعيضية فإن كلا من اليهود والنصارى والمجوس أمة واحدة كالمسلمين في إسلامهم وإن تشعبوا شعبا مختلفة وتفرقوا فرقا متشتتة اختلط بعضهم ببعض ولو كان المراد قتال البعض وإثبات الجزية على الجميع أو على ذلك البعض بعينه لاحتاج المقام في إفادة ذلك إلى بيان غير هذا البيان يحصل به الغرض. وحيث كان قوله: “من الذين أوتوا الكتاب” بيانا لما قبله من قوله: “الذين لا يؤمنون” الآية فالأوصاف المذكورة أوصاف عامة لجميعهم وهي ثلاثة أوصاف وصفهم الله سبحانه بها: عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله، وعدم التدين بدين الحق. فأول ما وصفهم به قوله: “الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر” وهو تعالى ينسب إليهم في كلامه أنهم يثبتونه إلها وكيف لا؟ وهو يعدهم أهل الكتاب، وما هو إلا الكتاب السماوي النازل من عند الله على رسول من رسله ويحكي عنهم القول أو لازم القول بالألوهية في مئات من آيات كتابه. وكذا ينسب إليهم القول باليوم الآخر في أمثال قوله: “وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة” (البقرة 80)، وقوله: “وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى” (البقرة 111). غير أنه تعالى لم يفرق في كلامه بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر فالكفر بأحد الأمرين كفر بالله والكفر بالله كفر بالأمرين جميعا، وحكم فيمن فرق بين الله ورسله فآمن ببعض دون بعض أنه كافر كما قال: “إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا” (النساء 151). فعد أهل الكتاب ممن لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفارا حقا وإن كان عندهم إيمان بالله واليوم الآخر، لا بلسان أنهم كفروا بآية من آيات الله وهي آية النبوة بل بلسان أنهم كفروا بالإيمان بالله فلم يؤمنوا بالله واليوم الآخر كما أن المشركين أرباب الأصنام كافرون بالله إذ لم يوحدوه وإن أثبتوا إلها فوق الآلهة. على أنهم يقررون أمر المبدأ والمعاد تقريرا لا يوافق الحق بوجه كقولهم بأن المسيح ابن الله وعزيرا ابن الله يضاهئون في ذلك قول الذين كفروا من أرباب الأصنام والأوثان أن من الآلهة من هو إله أب إله ومن هو إله ابن إله، وقول اليهود في المعاد بالكرامة وقول النصارى بالتفدية. فالظاهر أن نفي الإيمان بالله واليوم الآخر عن أهل الكتاب إنما هو لكونهم لا يرون ما هو الحق من أمر التوحيد والمعاد وإن أثبتوا أصل القول بالألوهية لا لأن منهم من ينكر القول بألوهية الله سبحانه أو ينكر المعاد فإنهم قائلون بذلك على ما يحكيه عنهم القرآن وإن كانت التوراة الحاضرة اليوم لا خبر فيها عن المعاد أصلا.
ويستطرد العلامة السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان للآية التوبة 29 عن كلمة (لا): ثم وصفهم ثانيا بقوله: “ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله” (التوبة 29) وذلك كقول اليهود بإباحة أشياء عدها وذكرها لهم القرآن في سورتي البقرة والنساء وغيرهما وقول النصارى بإباحة الخمر ولحم الخنزير، وقد ثبت تحريمهما في شرائع موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأكلهم أموال الناس بالباطل كما سينسبه إليهم في الآية الآتية: “إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل”. والمراد بالرسول في قوله: “ما حرم الله ورسوله” (التوبة 29) أما رسول أنفسهم الذي قالوا بنبوته كموسى عليه السلام بالنسبة إلى اليهود، وعيسى عليه السلام بالنسبة إلى النصارى فالمعنى لا يحرم كل أمة منهم ما حرمه عليهم رسولهم الذي قالوا بنبوته، واعترفوا بحقانيته وفي ذلك نهاية التجري على الله ورسوله واللعب بالحق والحقيقة. وأما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويكون حينئذ توصيفهم بعدم تحريمهم ما حرم الله ورسوله بغرض تأنيبهم والطعن فيهم ولبعث المؤمنين وتهييجهم على قتالهم لعدم اعتنائهم بما حرمه الله ورسوله في شرعهم واسترسالهم في الوقوع في محارم الله وهتك حرماته. وربما أيد هذا الاحتمال أن لو كان المراد بقوله: “ورسوله” رسول كل أمة بالنسبة إليها كموسى بالنسبة إلى اليهود وعيسى بالنسبة إلى النصارى كان من حق الكلام أن يقال: “ولا يحرمون ما حرم الله ورسله” (التوبة 29) على ما هو دأب القرآن في نظائره للدلالة على كثرة الرسل كقوله: “ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله” (النساء 150)، وقوله: “قالت رسلهم أفي الله شك” (إبراهيم 10)، وقوله: “وجاءتهم رسلهم بالبينات” (يونس 13). على أن النصارى رفضوا محرمات التوراة والإنجيل فلم يحرموا ما حرم موسى وعيسى عليهما السلام، وليس من حق الكلام في مورد هذا شأنه: أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. على أن المتدبر في المقاصد العامة الإسلامية لا يشك في أن قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ليس لغرض تمتع أولياء الإسلام ولا المسلمين من متاع الحياة الدنيا واسترسالهم وانهماكهم في الشهوات على حد المترفين من الملوك والرؤساء المسرفين من أقوياء الأمم. وإنما غرض الدين في ذلك أن يظهر دين الحق وسنة العدل وكلمة التقوى على الباطل والظلم والفسق فلا يعترضها في مسيرها اللعب والهوى فتسلم التربية الصالحة المصلحة من مزاحمة التربية الفاسدة المفسدة حتى لا ينجر إلى أن تجذب هذه إلى جانب، وتلك إلى جانب، فيتشوش أمر النظام الإنساني إلا أن لا يرتضي واحد أو جماعة التربية الإسلامية لنفسه أو لأنفسهم فيكونون أحرارا فيما يرتضونه لأنفسهم من تربية دينهم الخاصة على شرط أن يكونوا على شيء من دين التوحيد، وهو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، وأن لا يتظاهروا بالمزاحمة، وهذا غاية العدل والنصفة من دين الحق الظاهر على غيره. وأما الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم وحسن إدارتهم ولا غنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقة أو باطلة. ومن هذا البيان يظهر أن المراد بهذه المحرمات: المحرمات الإسلامية التي عزم الله أن لا تشيع في المجتمع الإسلامي العالمي كما أن المراد بدين الحق هو الذي يعزم أن يكون هو المتبع في المجتمع. ولازم ذلك أن يكون المراد بالمحرمات: المحرمات التي حرمها الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادع بالدعوة الإسلامية، وأن يكون الأوصاف الثلاثة: “الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر” (التوبة 29) الآية في معنى التعليل تفيد حكمة الأمر بقتال أهل الكتاب. وبذلك كله يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه أنه لا يعقل أن يحرم أهل الكتاب على أنفسهم ما حرم الله ورسوله علينا إلا إذا أسلموا، وإنما الكلام في أهل الكتاب لا في المسلمين العاصين. وجه الفساد أنه ليس من الواجب أن يكون الغرض من قتالهم أن يحرموا ما حرم الإسلام وهم أهل الكتاب بل أن لا يظهر في الناس التبرز بالمحرمات من غير مانع يمنع شيوعها والاسترسال فيها كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل المال بالباطل على سبيل العلن بل يقاتلون ليدخلوا في الذمة فلا يتظاهروا بالفساد، ويحتبس الشر فيما بينهم أنفسهم. ولعله إلى ذلك الإشارة بقوله: “وهم صاغرون” (التوبة 29) على ما سيجيء في الكلام على ذيل الآية.
أما الوصف الثالث فيقول عنه السيد الطباطبائي: ثم وصفهم ثالثا بقوله: “ولا يدينون دين الحق” (التوبة 29) أي لا يأخذونه دينا وسنة حيوية لأنفسهم. وإضافة الدين إلى الحق ليست من إضافة الموصوف إلى صفته على أن يكون المراد الدين الذي هو حق بل من الإضافة الحقيقة، والمراد به الدين الذي هو منسوب إلى الحق لكون الحق هو الذي يقتضيه للإنسان ويبعثه إليه، وكون هذا الدين يهدي إلى الحق ويصل متبعيه إليه فهو من قبيل قولنا طريق الحق وطريق الضلال بمعنى الطريق الذي هو للحق والطريق الذي هو للضلال أي إن غايته الحق أو غايته الضلال. وذلك أن المستفاد من مثل قوله تعالى: “فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم” (الروم 30)، وقوله: “إن الدين عند الله الإسلام” (آل عمران 19)، وسائر ما يجري هذا المجرى من الآيات أن لهذا الدين أصلا في الكون والخلقة والواقع الحق يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويندب الناس إلى الإسلام والخضوع له ويسمى اتخاذه سنة في الحياة إسلاما لله تعالى فهو يدعو إلى ما لا مناص للإنسان عن استجابته والتسليم له وهو الخضوع للسنة العملية الاعتبارية التي يهدي إليها السنة الكونية الحقيقية، وبعبارة أخرى التسليم لإرادة الله التشريعية المنبعثة عن إرادته التكوينية. وبالجملة للحق الذي هو الواقع الثابت دين وسنة ينبعث منه كما أن للضلال والغي دينا يدعو إليه، والأول اتباع للحق كما أن الثاني اتباع للهوى، قال تعالى: “ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض” (المؤمنون 71). والإسلام دين الحق بمعنى أنه ستة التكوين والطريقة التي تنطبق عليها الخلقة وتدعو إليها الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فتلخص مما تقدم أولا: أن المراد بعدم إيمان أهل الكتاب بالله واليوم الآخر عدم تلبسهم بالإيمان المقبول عند الله، وبعدم تحريمهم ما حرم الله ورسوله عدم مبالاتهم في التظاهر باقتراف المناهي التي يفسد التظاهر بها المجتمع البشري ويخيب بها سعي الحكومة الحقة الجارية فيه، وبعدم تدينهم بدين الحق عدم استنانهم بسنة الحق المنطبقة على الخلقة والمنطبقة عليها الخلقة والكون. وثانيا: أن قوله: “الذين لا يؤمنون بالله” إلى آخر الأوصاف الثلاثة مسوق لبيان الحكمة في الأمر بقتالهم ويترتب عليه فائدة التحريض والتحضيض عليه. وثالثا: أن المراد قتال أهل الكتاب جميعا لا بعضهم بجعل “من” في قوله: “من الذين أوتوا الكتاب” (التوبة 29) للتبعيض. قوله تعالى: “حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” (التوبة 29) قال الراغب في المفردات:، الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم. وفي المجمع، الجزية فعلة من جزى يجزي مثل العقدة والجلسة وهي عطية مخصوصة جزاء لهم على تمسكهم بالكفر عقوبة لهم. عن علي بن عيسى. والاعتماد على ما ذكره الراغب فإنه المتأيد بما ذكرناه آنفا أن هذه عطية مالية مصروفة في جهة حفظ ذمتهم وحقن دمائهم وحسن إدارتهم. وقال الراغب أيضا: الصغر والكبر من الأسماء المتضادة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض فالشيء قد يكون صغيرا في جنب الشيء وكبيرا في جنب آخر إلى أن قال يقال: صغر صغرا بالكسر فالفتح في ضد الكبير وصغر صغرا وصغارا – بالفتحتين فيهما – في الذلة. والصاغر الراضي بالمنزلة الدنية: “حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”.
وعن اعطاء الجزية يقول العلامة السيد الطباطبائي: والاعتبار بما ذكر في صدر الآية من أوصافهم المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم يفيد أن يكون المراد بصغارهم خضوعهم للسنة الإسلامية والحكومة الدينية العادلة في المجتمع الإسلامي فلا يكافئوا المسلمين ولا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه أنفسهم وإشاعة ما اختلقته هوساتهم من العقائد والأعمال المفسدة للمجتمع الإنساني مع ما في إعطاء المال بأيديهم من الهوان. فظاهر الآية أن هذا هو المراد من صغارهم لا إهانتهم والسخرية بهم من جانب المسلمين أو أولياء الحكومة الدينية فإن هذا مما لا يحتمله السكينة والوقار الإسلامي وإن ذكر بعض المفسرين. واليد: الجارحة من الإنسان وتطلق على القدرة والنعمة فإن كان المراد به في قوله: “حتى يعطوا الجزية عن يد” ﴿التوبة 29﴾ هو المعنى الأول فالمعنى حتى يعطوا الجزية متجاوزة عن يدهم إلى يدكم، وإن كان المراد هو المعنى الثاني فالمعنى: حتى يعطوا الجزية عن قدرة وسلطة لكم عليهم وهم صاغرون غير مستعلين عليكم ولا مستكبرين. فمعنى الآية – والله أعلم – قاتلوا أهل الكتاب لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا مقبولا غير منحرف عن الصواب ولا يحرمون ما حرمه الإسلام مما يفسد اقترافه المجتمع الإنساني ولا يدينون دينا منطبقا على الخلقة الإلهية قاتلوهم ودوموا على قتالهم حتى يصغروا عندكم ويخضعوا لحكومتكم، ويعطوا في ذلك عطية مالية مضروبة عليهم يمثل صغارهم، ويصرف في حفظ ذمتهم وحقن دمائهم وحاجة إدارة أمورهم.
عن كتاب أسرار التكرار في القرآن للمؤلف محمود بن حمزة بن نصر الكرماني: سورة البقرة: قوله “فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر” (البقرة 34) ذكر هذه الخلال في هذه السورة جملة ثم ذكرها في سائر السور مفصلا فقال في الأعراف “إلا إبليس لم يكن من الساجدين” (الأعراف 11) وفي الحجر “إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين” (الحجر 31) وفي سبحان إلا إبليس قال “أأسجد لمن خلقت طينا” (الاسراء 61) وفي الكهف “إلا إبليس كان من الجن” (الجن 50) وفي طه “إلا إبليس أبى” (طه 116) وفي ص “إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين” (ص 74).