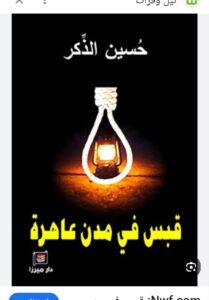فاضل حسن شريف
جاء في كتاب الأديان والمذاهب من مناهج جامعة المدينة العالمية: يستطرد الكتاب متحدثا عن إبطال دعوى ألوهية المسيح أو التثليث بدليل عقلي: واستنادهم إلى أنه هو كلمته التي ألقاها إلى مريم، فليس في ذلك ما يبرر الألوهية والتثليث، لأن كلمة الله تعالى هي أمره: “إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ” (يس 82). والمسيح تكوّن في بطن أمه، وخرج إلى الدنيا بأمر الله وكلمته، فهو كلمة الله بهذا المعنى، ألا ترى أن الحاكم يصدر الأمر ويتكلم بالكلمة فتنفذ، وتحول إلى بناء يقام أو مدينة تشيد، فيقال عن ذلك: كلمة الحاكم وأمره، والأمر شيء والمأمور به شيء آخر، فعندما يُخلق إنسان بكلمة ويظهر في الوجود بأمره لا يقال أبدًا الذي تكلم الكلمة وأمر بها، ومظهره وما تكونت به شيء واحد، ولا يقال: إن الذي تكلم الكلمة هو الشيء الذي تكوّن بها ومنها، فالنار التي أطفئت بأمر الله وكلمته، ولم تصب إبراهيم ليست هي الذي أمر وتكلم وقال: “يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ” (الأنبياء 69). والروح هي القدرة والمسيح خلق بقدرة الله، وهو ليس وحده بل آدم كذلك، ونحن أيضًا كما قال تعالى: “ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ” (السجدة 8-9) إن ما تزعمه النصرانية فوق مستوى العقول والنقول، وذلك ما اعترفوا به هم أنفسهم، وذكرنا من ذلك ما قاله القس توفيق في كتابه (سر الأزل) إن تسمية الثالوث باسم الأب والابن والروح القدس، تعتبر أعماقًا إلهية وأسرارًا سماوية، لا يجوز لنا أن نتفلسف في تفكيكها وتحليلها، أو نلصق بها أفكارًا من عندنا. ثم ذكر في كتابه (التثليث والتوحيد): الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه، هل يكلف الإنسان بما فوق فهمه وإدراكه، ما الداعي لهذه الطلاسم والألغاز، ثم في النهاية يكون العذاب الأبدي. إن العقل لا يصدق تجسد الإله، وإن كان أن يتحول رب العالمين إلى شخص يأكل ويشرب إلى آخره، كما أن العقل لا يصدق أيضًا أن البشر جميعًا أرباب خطايا وأصحاب مفاسد، وأنهم محتاجون لمن ينتحر من أجلهم كي تغفر خطاياهم. وبعد هذا الرد العقلي مختصرًا أنادي على أهل الكتاب: “يَا أَهْل الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا * لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ” (النساء 171-172).
وعن إبطال دعوى صلب المسيح: قول الله عز وجل: “وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا” (النساء:157-158). وقال تعالى: “إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ” (آل عمران 55) الآية. فالآية الكريمة الأولى أوضحت بيقين أن المسيح عليه السلام لم يصلب، كما بينت الاختلافات التي يعجز عن فهمها حتى الآن علماء النصارى وآباء الكنيسة على الصعيد العالمي، هذا وليس القرآن الكريم وحده هو الذي حكم ببطلان الصلب، بل الإنجيل أيضًا والتاريخ والعقل كذلك، وإليك طرفًا من ذلك. أن الأناجيل ليست قاطعة في صلبه، بل فيها اختلافات وشكوك كثيرة كما قدمت لك، بل هي احتمالات، واليهود ليسوا قاطعين بذلك أيضًا، فأي ضرورة تدعوكم إلى إثبات أنواع الإهانة والعذاب في حق رب الأرباب على زعمكم، إن هذا لمن العجب العجاب، هذا فضلًا عن تبرئة اليهود حديثًا من دم المسيح عليه السلام وصدق ربنا عز وجل إذ قال: “وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا” (النساء 157). أن العالم يخطئ فيقتل الله ابنه كفارة للخطأ الواقع، فهذا ما يضرب الإنسان كفًا بكف لتصوره، لماذا يقتل الله ابنه الوحيد البريء من أجل ذنوب الآخرين، إذا كان هذا الإله رب أسرة كبيرة، فلِمَ يقتل أبناءه كلهم أو جلهم من غير جريرة، أليس الأعقل والأعدل أن يقول هذا الإله للمذنبين: تتطهروا من أخطائكم وتوبوا إلي أقبلكم، فلا يكون هناك قتل ولا صلب ولا لف ولا دوران، أليس كل إنسان مسئولًا عن نفسه “أن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى” (النجم 38-39). ألم يكن أوفق لعدل الله ورحمته أن يعغو عن عباده بدلًا من أن يعاقب ابنه الوحيد المزعوم، “وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا” (النساء 110)، وإذا كان هذا الصلب بسبب ذنب اقترفه آدم عليه السلام فهو إما أن يتوب الله عز وجل كما حدث، يتوب عليه ويعفو عنه، أو أن يعاقبه بذنبه، ولا ثالث لهما وذلك مقتضى عدل الله. وكم نود أن نقول لهؤلاء وأمثالهم من الحاقدين على الإسلام: “يَا أَهْل الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ” (المائدة 77).
وعن مصادر دراسة الدين المصري: بعض العلماء المصريين تأثر ببعض العقائد السماوية، وبصورة خاصة تلك الرسالات التي عاشت فترة بينهم، كرسالة إبراهيم ويوسف وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء العلماء لا يرون الدين الصحيح صناعة بشرية، ويؤكدون أنه لا يكون إلا بالوحي المنزل على رسول من رسل الله تعالى، ويذهب بعضهم إلى أن الدين الصحيح جاء لسائر الأمم داعيًا للتوحيد الخالص والنظام المستقيم، استنتاجًا من الحقيقة القرآنية الواردة في قوله تعالى: “وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ” (فاطر 24). الرأي القائل بأن التوحيد الموحى به تجاه المصريين، في أقدم عصورهم من غير تحديد رسالات أو رسل معينين لما يلي: الأول: تأكيد الله تعالى في القرآن الكريم بأن سائر الأمم جاءها رسول من عند الله، لدعوتها إلى التوحيد ودين الله، وذلك في قوله تعالى: “وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ” (فاطر 24) والمصريون أمة من الأمم، بل إنهم أسبق من غيرهم، لدرجة أن من العلماء من يرى أن المنطقة التي عمرت في الكون أولًا هي مصر، وتبعًا لهذا يمكن القول بمجيء رسول إلى المصريين منذ القدم. بل إن العقل يسلم بنزول عدد من الرسل في مصر يدعون للتوحيد على فترات، فكلما غابت رسالة تأتي أخرى وهكذا، ولعل هذا يفسر ظهور دعوة التوحيد في فترات مختلفة على امتداد التاريخ المصري القديم. الثاني: القول بتحديد أسماء الرسل يلزمنا بالدليل على ذلك، وبتعريف سائر الرسل الذين أرسلوا لمصر، بينما ذلك لم يذكره أحد ولا يستطيعه، لأن التعريف بالرسل لم يرد إلا في الكتب المقدسة، وهي لم تتناولهم جميعًا حيث يقول تعالى في القرآن الكريم: “مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ” (غافر 78). الثالث: القول بالتوحيد الموحى به، يفسر ظاهرة وجود تعدد الآلهة بجانب التوحيد، حيث آمن البعض بالتوحيد وكفر آخرون، وتلك قضية مسلمة أكدتها البشرية مع سائر دعوات الله تعالى. الرابع: تحديد الرسالة بإدريس عليه السلام أو بداود عليه السلام يدفع إلى التسليم بخلو مصر من التوحيد قبل وبعد هذا الرسول أو ذاك، وذلك غير صحيح حيث ظهر التوحيد في حياة المصريين فترات عديدة. الخامس: القطع بأن دعوة أخناتون جاءت بعد داود عليه السلام غير مسلم به، فمن علماء الآثار من يذهب إلى أن دعوة أخناتون ظهرت قبل داود بوقت طويل، وفقرات المزمور مأخوذة من النص المصري، وهذا لون من تحريف التوراة. السادس: القول بالرسالات من غير تحديد لا يتعارض مع القول بإرسال رسول معين، وتحديد مسماه، لأن ثبوت ذلك يؤكد أنه واحد من رسل الله تعالى، بينما التحديد يمنع من احتمال إرسال ما لم يرد في التحديد، وعلى الجملة فإن التوحيد ظهر في مصر القديمة، وبلغه رسل الله تعالى، وهذا الذي نرجحه ونراه الأولى بالتسليم، والله أعلم.