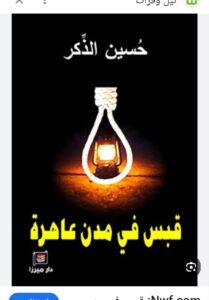فاضل حسن شريف
أن الشعوب التي نهلت من فلسفة عظماء عدّتهم أنبياء ورسل، بل تخطى هذا الاعتقاد تلك الشعوب ليشمل نسبة كبيرة من مفكّري العالم وعلمائه وفلاسفته، ومن بينهم علماء مسلمون كُثر استندوا في فرضياتهم إلى آيات كريمة كتلك التي تقول: “إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير” (فاطر 24). وقد ذكر الله عز وجل بأن أولئك الرسل متتابعين، كل رسول يتبعه رسول آخر: “ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ” (المؤمنون 44). وأكثر الآيات دلالة على فرضية (نبوّة) هؤلاء الفلاسفة، وغيرهم، وربما كان بعض فلاسفة الإغريق منهم، هو في قوله تعالى: “وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ” (غافر 78). وكما نلاحظ، فإن الآية الأخيرة، وسابقاتها، تثبت بأن الأنبياء والرسل قد انتشروا في بقاع الأرض كلها، وهم أكثر من الذين ذكرت أسماؤهم وقصصهم في القرآن الكريم. إضافة إلى فرضية نبوة فلاسفة آسيا ورسالتهم، ما تزال شعوبهم وفئة من الشعوب الأخرى تؤمن بهم وتعتنق (فكرهم- دياناتهم) حتى اللحظة، وهم يشكّلون نسبة كبيرة من عدد سكان الأرض. جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله عز من قائل “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (يونس 47) قضاء إلهي منحل إلى قضاءين أحدهما: أن لكل أمة من الأمم رسولا يحمل رسالة الله إليهم ويبلغها إياهم، وثانيهما: أنه إذا جاءهم وبلغهم رسالته فاختلفوا من مصدق له ومكذب فإن الله يقضي ويحكم بينهم بالقسط والعدل من غير أن يظلمهم. هذا ما يعطيه سياق الكلام من المعنى. ومنه يظهر أن قوله: “فإذا جاء رسولهم” فيه إيجاز بالحذف والإضمار والتقدير: فإذا جاء رسولهم إليهم وبلغ الرسالة فاختلف قومه بالتكذيب والتصديق، ويدل على ذلك قوله: “قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” فإن القضاء إنما يكون فيما اختلف فيه، ولذا كان السؤال عن القسط وعدم الظلم في القضاء في مورد العذاب والضرار أسبق إلى الذهن. وقد تقدم الفرق بين الرسول والنبي في مباحث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب، وهذا القضاء المذكور في الآية من خواص الرسالة دون النبوة.
جاء في موقع مؤمنون بلا حدود عن رؤية في العلاقة بين القرآن والفلسفة للكاتب زكي الميلاد: أصدر الشيخ الأزهري الدكتور محمد يوسف موسى (1317-1383هـ/ 1859-1963م)، في سنة 1958م، الطبعة الأولى من كتابه (القرآن والفلسفة)، وهو في الأصل القسم الأول من رسالته للدكتوراه التي أعدها باللغة الفرنسية، وناقشها في جامعة السوريون الفرنسية سنة 1948م، وحصل بموجبها على دكتوراه دولة في الفلسفة بدرجة مشرف جدّاً، وهي أعلى الدرجات التي تمنحها الجامعة هناك، وحملت الرسالة عنوان (الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط). وبعد مناقشة الرسالة، قام الدكتور موسى بترجمتها من الفرنسية إلى العربية، وأصدرها في كتابين متعاقبين، الكتاب الأول حمل عنوان (القرآن والفلسفة)، والكتاب الثاني حمل نفس عنوان الرسالة، وصدر سنة 1959م. وأول ما يستوقف الانتباه في هذا الكتاب، هو عنوانه اللافت بشدة (القرآن والفلسفة)، ولعله أول كتاب في المجال العربي الحديث والمعاصر يحمل هذا العنوان، ويضع القرآن والفلسفة في حالة اقتران بصيغة ثنائية مركبة، اقتران توافق واتصال وليس اقتران تخالف وانفصال، وبشكل يثير الانتباه والدهشة، مع أنه على ما يبدو لم يستقبل بطريقة تتسم بإثارة الانتباه والدهشة، ليس هذا فحسب، بل إنه بقي خارج الانتباه، وبعيداً عن الذاكرة والتذكر، وكأنه من المؤلفات التي صدرت ومرت ونسيت ولم تترك أثراً باقياً، حاله كحال عشرات أو مئات أو آلاف الكتابات والمؤلفات التي نسيت عند العرب والمسلمين مع مرور الوقت. في هذا الكتاب (القرآن والفلسفة)، قدم الدكتور محمد يوسف موسى رؤية مهمة في العلاقة بين القرآن والفلسفة، وذلك في محاولة منه للدفاع عن الفلسفة من جهة، والتأكيد على عدم معارضة القرآن للفلسفة من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة الكشف عما بين القرآن والفلسفة من علاقة.
عن تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله عز من قائل “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (يونس 47) “ولكل أمة” من الأمم “رسول فإذا جاء رسولهم” إليهم فكذبوه “قضي بينهم بالقسط” بالعدل فيعذبون وينجى الرسول ومن صدقه “وهم لا يظلمون” بتعذيبهم بغير جرم فكذلك نفعل بهؤلاء.
والقضاء الصادر من اللّٰه تعالى نتيجة ارسال الرسل الذي يبين بعض الكتاب ان ما يسمى ببعض الفلاسفة القدماء الا هم رسل لم يذكرهم القرآن الكريم في قصصه. و في القرآن للقضاء معاني عدة منها معنى الأمر “وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا” (الإسراء 23). ومعنى الخبروالاعلام”وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ” (الحجر 66)، و”وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ” (الإسراء 4). والموت”وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ” (الزخرف 77)، و”فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ” (القصص 15). ومعنى الفصل “وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ” (مريم 39)، و”فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (يونس 47).
وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله عز من قائل “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (يونس 47) “ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ” يبشرها وينذرها، وبعد الانذار والإعذار يكون الحساب والعقاب، إذ لا عقوبة من غير نص “فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ” وبلغهم ما تجب معرفته عليهم من أمور الدين، ولم يبق من عذر لمعتذر “قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ”فيحكم لمن استجاب للَّه ورسوله بالفوز والثواب، وعلى من أعرض ونأى بالخذلان والعقاب “وهُمْ لا يُظْلَمُونَ” فلا نقصان من ثواب من أطاع، وقد يزداد، ولا زيادة في عقاب من عصى، وقد تشمله الرحمة، وهذا المعنى يدل عليه قوله تعالى: “بِالْقِسْطِ” ولكن من عادة القرآن أن يؤكد كل ما يتصل بالآخرة وثوابها وعقابها.
جاء في موقع مؤسسة تراث الشهيد الحكيم عن مفهوم الامة في السياق القرآني للدكتور محمد جعفر العارضي: الأمَّة: جماعة تجتمع على أمر ما، من دين، او مكان،او زمان. وردت لفظة الأُمَّة في القرآن الكريم في دلالتها الاجتماعية 56 مرة. وعلى الرغم من تعدد السياقات التي تحتوي هذه اللفظة، وكثرة تفريعاتها، ومن ثمَّ كثرة دلالاتها، الا إنَّنا نجد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره قد أدار هذا التعدد السياقي وعالجه معالجة شاملة منتجة، فبدا ممهدا تارة، و مستنتجا تارة اخرى. فتناول مفهوم الأُمَّة بلحاظين هما: تناوله بلحاظ دلالته على البعد الاجتماعي المجرد، بمعنى دلالته على مجرد الجماعة البشرية التي تربطها رابطة الاجتماع. و من ذلك قوله تعالى “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (يونس 47) وتناوله بلحاظ دلالته على البعد المعنوي و الفكري للجماعة البشرية.